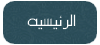دكتور محيي الدين عميمور
بعد رئاسة باهتة لجيرالد فورد تسلم جيمي كارتر منصب الرئاسة في يناير 1977 ويختار سيروس فانس، بدلا من كيسنجر في وزارة الخارجية، وبدأ اقترابه من أزمة الشرق الأوسط بدعوات وجهها إلى عدد من ساسة المنطقة للقاء به، وكان قد اعتمد آنذاك مشروع معهد “بروكينز″ الشهير للأبحاث في واشنطن، والذي كان من بين مستشاريه بريجينسكي ووليم كوانت، ليكون أساس تحركه الذي سوف يعتمد على أربع نقاط محددة.
وأستبق الأحداث لأقول بأن وليم كوانت قال لنا خلال محاضرة ألقاها في الجزائر، كنت كتبت عنها في حينها ولعلي أعود إليها بالتفصيل فيما بعد: لو كانت هناك ديموقراطية حقيقية في مصر لما أمكن تمرير اتفاق كامب دافيد.
وواقع الأمر أن مصر آنذاك، وطبقا لما قاله “ويلي موريس″ سفير بريطانيا في القاهرة عبر رسالة بعث بها إلى حكومته وكُشف عنها مؤخرا (وثيقة 111/77) أن : “السادات توسع في الحديث عن نصر أكتوبر، واعدا بسنوات رخاء تعقب السنوات الصعبة، لكن الاقتصاد ظل في منطقة الخذلان الكبرى، نتيجة لفقدان السادات للمعرفة عبر معاونين قادرين أو فعالين، وكرر بأنه يحتاج 11 مليار دولار للوصول بمصر إلى مرحلة الانطلاق عام 1980، لكن فقدان “الفلوس″ لم يكن هو الذي أعاق التنمية، بل هي الآلة الحكومية المرهقة”.
وينقل السفير البريطاني قول مسؤول مصري لم يذكر اسمه : “إننا فشلنا في الزراعة وفي التصنيع، وربما سننجح فقط بتحولنا إلى اقتصاد “خدميّ” متزايد للوصول إلى هيمنة على السياحةالعربية وتعليم الطلاب العرب في مؤسساتنا التعليمية وتصدير العمالة والعقول”.
ويواصل السفير قائلا: “لقد تسارع إيقاع التضخم وازدادت أموال الأغنياء الجدد، وهم في الغالب الأغنياء القدامى، والفقراء ازدادوا فقرا (..) وواصل الرئيس (السادات) زيارة عدد من الدول الأوربية ليقول بأن سياساته أكسبت مصر صداقة ودعما”.
ويرسم هيكل في كتابه عن المفاوضات السرية الذي صدر في 1996 ( ج:2- ص 294) الصورة الحقيقية لما كانت مصر تعيشه آنذاك، فهو يقول بأن : “انتصارات الأيام الأولى (في حرب أكتوبر) كانت وعدا تحقق ومعجزة ظهرت بشارتها، ومن هنا تصور الناس أنها نقطة الوصول، فتنفسوا الصعداء، في حين أن النتائج العسكرية في الحرب المحدودة هي نقطة البداية للحرب الحقيقية، حرب التحقيق السياسي لأهداف القتال، وكان معظم الناس قد أصابهم الإعياء (..) ويريدون لأولادهم أن يعودوا إلى دراساتهم أو إلى عمل تتوفر لهم فرصته، وإلى حياة يستطيعون البدء في بنائها تحت أجواء تسمح لهم بحياة أفضل في ظروف سلام، وكان حلم السلام أملا يسري في عروق كثيرين، خصوصا مع ثورة أسعار النفط التي قلبت الموازين الاجتماعية في العالم العربي، وسمحت للبعض بألوان من الترف الاستهلاكي أطارت ما تبقى في عقول الناس (..) الناس في مصر كانوا يتصورون أن بلدهم هو أغنى الأوطان العربية، ولكن الصورة التي تبدّت أمامهم أثارت مخاوفهم من أنهم أصبحوا أفقرها، وكان عليهم أن يسابقوا بعضهم ويُسابقوا غيرهم إلى أبواب الثراء (..) وكان السادات يريد أن يؤسس شرعية مستقلة له عن شرعية عبد الناصر، واعتقدَ أن أكتوبر يُعطيه ذلك، لكن الشرعية لا تستطيع أن تستند إلى “قرار” أكتوبر وإنما كان يجب أن تستند إلى “روح” أكتوبر، والرئيس كان في عجلة من أمره، فقد كان هو الآخر مرهقا، وقال لي : الناس تعبوا، وأنا أيضا تعبت، وأريد أن أستريح”.
والذي حدث هو أن : “الشعب المصري صبر على ما وصل إلى علمه، ولو في حدود ضيقة جدا، من أنه لم يحقق سياسيا وعسكريا ما كان يصبو إليه، وظل يأمل في أن يستطيع تعويض ذلك اقتصاديا واجتماعيا”.
لكن مكاسب الحرب، كما يقول هيكل (ص 310) “بدأت بسياسات الانفتاح التي اختارها الرئيس، والتي كانت غنيمة لطبقة طفيلية ظهرت فجأة على سطح الحياة المصرية، وراحت تخطف ثروات طائلة بدون جهد أو عمل، ومن غير مصدر ظاهر أو مشروع، بينما لم تستفد الشرائح الوطنية التي أعطت أبناءها للدفاع عن الوطن، وتحملت أعباء القتال وضروراته”.
كانت السبعينيات قد بدأت تعيش الطفرة البترولية التي عرفتها الساحة العربية منذ ارتفاع أسعار النفط، نتيجة للمواقف الشجاعة التي اتخذتها جزائر “هواري بو مدين” منذ 1971 وسعودية “الملك فيصل” وإمارات “الشيخ زايد” وكويت “الشيخ جابر” وعراق “صدّام حسين”، وهو ما كان يعني بروز قيادات جديدة يجب أن نعترف بأنها أضعفت من الاحتكار المصري لموقع الريادة، بعد أن تأثر بغياب قامة كعبد الناصر، وثبت عجْز خلفه عن ملء الفراغ السياسي في المنطقة، حيث فقدَ، أو كادَ، هالة الانتصار في أكتوبر، وهو ما كان مبرر بداية الانكفاء إلى الداخل ومواجهة المصاعب المتزايدة بالاتجاه نحو تنشيط “الشوفينية”الداخلية.
وأخذ مرتزقة الإعلام والمستفيدين من أبناء الطبقة الطفيلية الجديدة في ترديد الادعاءات بأن العرب لم يقوموا بواجبهم تجاه مقاتلي حرب أكتوبر، الذين يعود لهم، كما قيل، الفضل الأول في ارتفاع أسعار النفط وزيادة مداخيل الدول النفطية، وهي كلمة حق أريد بها باطل مما جعلها مغالطة إلى حد كبير، لأن الحظر الذي فرضه العرب على تصدير النفطتضامنا مع جبهة القتال في حرب أكتوبر، كما سبق أن وضّحت، هو الذي يقف وراء ارتفاع الأسعار، الذي ما كان من الممكن أن يحدث لو لم يتم العبور العظيم الذي اضطر العرب إلى إشهار النفط كسلاح، أجهض أثره السادات، ربما إلى الأبد، بناء على وسوسة كيسنجر(وبغض النظر هنا عن دور الشركات الأمريكية في تشجيع رفع الأسعار للأسباب التي تناولها الدكتور زلوم في بحثه القيم، وهو ما لم يكن واضحا آنذاك).
كان السادات، كما يقول هيكل : “شديد الإيمان بهنري كيسنجر، حيث كان، في تكوينه، يعتمد دائما على رجل قريب منه، يتأثر به ويأخذ برأيه (..) كان عبد الناصر يقوم بهذا الدور، ثم انتقل الدور إلى عبد الحكيم عامر (..) ثم بدأ السيد كمال أدهم يزداد قربا من الرئيس، ثم أصبح الدور مناصفة مع إسماعيل فهمي، ثم انتقل نهائيا إلى كيسنجر (..) وكان السادات على استعداد لأن يصدق كل ما يقوله (ص:269) كان كيسنجر، منذ التقاه أول مرة وحتى نهاية حياته هو المؤثر الأكبر (..) واتجه فكر السادات إلى رجال من أمثال عثمان أحمد عثمان (..) وكانت تلك إشارة لتوجه اجتماعي مختلف، وترافق هذا مع عودة مئات من المصريين والأجانب غادروا مصر في سنوات سابقة إلى العالم العربي أو أوروبا، وهناك راكموا ثروات طائلة من أعمال المقاولات والوكالات، وقد عادوا الآن إلى مصر وقد بدت لهم مثل كنز تفتحت أبوابه، وترافق ذلك أيضا مع وجود أشخاص آخرين على الساحة، بعد أن ابتعدوا أو أبعدوا عنها لأسباب تتعلق بارتباطات وولاءات ومصالح وامتيازات طبقية، تبدّت إمكانية استعادتها بل واستزادتها”.
وكان دخول أموال النفط إلى مصر، والذي لم يحقق استفادة شعبية واسعة واقتصرت فوائده على شرائح معينة، جزءا من المخطط الكبير لتذويب الاتجاهات القومية وتخريب المعادلة الاجتماعية التقليدية، فاختل بناء الطبقة الوسطى وهي عماد الفكر والوطنية والثقافة، وبرزت تطلعات طبقية جديدة، خصوصا في أوساط شرائح بدأت تشكل رأسمالية جديدة لم تكن لها خصائص الرأسمالية الوطنية العريقة فكرا أو ممارسة أو انتماءات.
ومع رغبة السادات في تأسيس شرعية جديدة فإن هذا كان يسهل تحويره ليكون بمثابة تقويض للشرعية السابقة، وكانت المقولة جاهزة، وهي هزيمة 1967 (..) لكن الإدانة على النحو الذي مورست به وقتها كانت كفيلة أن تفقد الشعب المصري ثقته بكل شيء، ومن ثم تجعله قابلا لأي شيء، خصوصا عندما يُقدم له حلفاؤه الطبيعيون كمجرد “بَدْوٍ” حديثي النعمة، يتفجرون غرورا وحقدا على سليلي الحضارة والأمجاد.
وربما كان هذا هو سر التعبير الذي استخدمه هيكل في الألفية الجديدة، عندما قال أن “الجغرافيا” انتصرت على “التاريخ”، ورددت آنذاك عليه في مقال نشر داخل الجزائر وخارجها قلت فيه إن”الجيولوجيا” هي التي انتصرت على التاريخ والجغرافيا معا.
لكن عودة إلى ما كان يقوله هيكل عن تلك المرحلة يرسم صورة الأرضية التي ستنطلق منها وعلى أساسها الطبقة الجديدة، التي جعلت مصر فيما بعد حليفا متميزا لكل أعدائها وخصومها السابقين، ولعل صورة واقع كل من الاتحاد السوفيتي والصين يُفسّر اللوحة السياسية بشكل أكثر وضوحا.
فقد انطلقت واحدة من أكبر قوتين في العالم في عملية بصق على الماضي منذ المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي في الخمسينيات، وكانت النتيجة أن تحولت الإمبراطورية السوفيتية في التسعينيات إلى شظايا، وأصبحت روسيا بعد عهد “غورباتشيف”، الذي أنهى مرحلة الحزب الواحد والمنهج الشيوعي وأسقط الكتلة الاشتراكية، صورة لمجتمع المخدرات والبغايا، وتجسيدا حقيقيا لعزيز قوم ذلّ، في حين أن الصين، رغم الحزب الواحد والمنهج الشيوعي، أصبحت قوة كبرى يتزايد وجودها وتأثيرها على الساحة الدولية يوما بعد يوم، وكان السبب البسيط هو أن الصين تشبثت بعمقها التاريخي والتزمت بقياداتها الدينية والمذهبية والسياسية، من “كونفوشيوس″ إلى “صن يات سن”، ومن “ماو” إلى “تنغ سياوبنغ”، وإلى الرئيس الجديد الذي لم أنجح بعد في حفظ اسمه.
وكان أكبر أخطاء السلطة في مصر هجومها الأحمق على الماضي، والذي كان جمال عبد الناصر من أهم رموزه، وذلك بحثا عن الشرعية الجديدة، وهو ما حرمها من عمقها التاريخي الذي كانت ثورة يوليو، بكل إنجازاتها بل وبأخطائها، جزءا رئيسيا فيه، وكان اللافت للنظر هنا العودة بشكل تدريجي إلى تمجيد مرحلة الملكية، واستعادة مآثر أسرة محمد علي باشا، وهو ما لم يكن خطأ مطلقا، حيث كانت الإساءة لتلك المرحلة بشكل مطلق ونهائي من أخطاء المرحلة الناصرية، وأذكر بالصورة التي قدّم عليها باني مصر الحديثة، الخديوي إسماعيل، في فيلم “ألمظ وعبده الحمولي”، وبالصورة التي قدم عليها الملك فاروق في أكثر من فيلم مصري.
ولأن العلاقات العربية كانت من أسس العمق التاريخي الذي جسدته المرحلة الناصرية، وقبلها المرحلة الملكية، كان لا بد بالتالي من تخريبها لأن هذا يحقق هدفين، الأول التستر على وضعية الانزلاق الاجتماعي التي تعيشها مصر في اتجاه خلق مجتمع جديد له طابعه المتناقض مع أهداف ثورة يوليو، وهو يستلزم تنشيط مشاعر “البارانويا” لدى الجماهير، التي سوف تلتف حول النظام بقدر ابتعادها عن محيطها العربي، والهدف الثاني، والذي كانت وراءه أيضا حسابات تاريخية مع القيادة المصريةالقديمة تعود إلى عهد محمد علي باشا، أرادت تنفيذ مخطط واسع المدى يساهم في تخريب المجتمع المصري ويعزل أكبر الدول مساحة عن عمقها الاستراتيجي، فتفقد تدريجيا وضعية الشقيقة العربية الكبرى وتتحول إلى مجرد دولة شقيقة، لا تختلف عن غيرها من الدول، إن لم تكن أحيانا، ولتخلّيها عن دورها التاريخي، أقل وزنا وتأثيرا، وهذا يضيف هدفا ثالثا لم يكن أحد يشير له، وهو أن تظل مصر لقمة سائغة للعدو التاريخي المتربص بجانبها، يكون، بتجاوزاته المتواصلة، امتصاصا لأي دور عربي محتمل للنظام المصري.
وأتوقف لحظات لأقول إنني أرفض أن يظن البعض بأن حديثي هو تدخل في شؤون دولة أحمل لشعبها كل المحبة والتقدير، وأسجل لقياداتها التاريبخية دورها في دعم كل حركات التحرير، والثورة الجزائرية في المقدمة، لكن دراسة وضعية مصر في السبعينيات ضرورية لمعرفة الأسباب الحقيقة لما وصلت به الأوضاع إلى ما وصلت إليه على الساحة العربية، ولهذا أستعنت دائما بما يقوله عدد من أبرز أبناء مصر، يهمهم أمرها ومستقبلها بأكثر مما يهم بعض مواطنيها بالجنسية، ممن ارتزقوا من وضعية الانزلاق التي عرفتها، والتي يهمهم التعتيم على أهم معطياتها.
وهكذا يقول هيكل بأن “مصر في تلك الفترة (من السبعينيات) كانت تعيش في حالة دوار بين ماضٍ يبدو لها مُكلفا، ومستقبل يلوح أمامها مُغريا، ثم جرى استدعاء مشاعر كانت نائمة في الذاكرة، مثل دعوى أن الوطنية المصرية متناقضة مع القومية العربية، ومثل أن العرب شمتوا فيها أيام وقعت تحت ضربة 1967″، وذلك حدث فعلا ولكنه كان استثناء اقتصر على بعض القيادات السياسية العربية التي كانت ساخطة على عبد الناصر، مثل نوري السعيد في العراق، ولم يثبت أن أكبر خصوم “الريّس″ تشفواّ في الأسد الجريح، وربما كان في مقدمة النزهاء من الخصوم الملك فيصل والرئيس الحبيب بو رقيبة، لكن الشعوب العربية كلها كانت متعاطفة إلى أبعد مدى مع مصر في محنةٍ، لم يكن العرب سببا فيها بأي حال من الأحوال، بقدر ما كانت متضامنةً معها في صمودها الرائع وداعمة لها في انطلاقتها المُباركة لكي تسترد بالقوة ما أخذ منها بالقوة.
وهكذا تضافرت الشوفينيةوالبارانويا لتحرم مصر من حلفائها الحقيقيين، ويواصل شبه عسكري من إنتاج “كامب دافيد” نباحا لا يؤثر علىجمل واحد من بعير القافلة.
المصدر
http://www.raialyoum.com/?p=334175