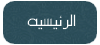في الأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة القتال في جنوب سوريا حيث تسعى الطائرات الحربية الروسية وقوات بشار الأسد إلى استعادة السيطرة على مدينة درعا. وتُعتبر المدينة التي تقع على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى دمشق وتبعد بضعة أميال فقط شمال الحدود الأردنية، من الجيوب المتنازع عليها في جزء الحدود الخاضع لسيطرة المتمردين. وتسلّط أعمال العنف في هذه المنطقة الضوء على الدعوات المستمرة لإقامة منطقة آمنة في الجنوب لحماية المدنيين السوريين من النظام وحلفائه.
ويطالب السوريون بإقامة مناطق آمنة منذ بدء الحرب. ولكن، في الآونة الأخيرة، حظيت الفكرة بتجاوب بعض الجهات الرئيسية، بما فيها الولايات المتحدة والأردن. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دعا دونالد ترامب إلى "بناء منطقة آمنة كبيرة وجميلة" في سوريا؛ وقبل عام، قال القائد المسؤول عن «حرس الحدود الأردنية» أنه "إذا تم إقامة منطقة آمنة سيكون ذلك أمراً جيداً". وفي الآونة الأخيرة، أفادت بعض التقارير أن الرئيس ترامب والعاهل الأردني الملك عبدالله قد ناقشا هذا الاحتمال خلال لقائهما الوجيز في 2 شباط/فبراير. وإذا تمّ تحويل هذه الفكرة إلى واقع، سيكمن الشيطان في التفاصيل - إذ إنّ إقامة أي نوع من المناطق الآمنة في الجنوب سيكون معقداً من الناحيتين العسكرية والدبلوماسية.
مصالح مشتركة
تقول الأردن أنها استقبلت حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري، أو أكثر من 13 في المائة من إجمالي سكان المملكة منذ عام 2011. ويفرض وجود اللاجئين أعباءً هائلة على الجهاز الأمني المحلي وعلى ندرة الموارد مثل المياه، فضلاً عن التكاليف المالية الضخمة التي تترتب على استضافة اللاجئين - والتي تفوق 2.5 مليار دولار سنوياً، وفقاً لبيانات "البنك الدولي".
ومنذ ما يزيد قليلاً عن العام، أحكمت المملكة الهاشمية السيطرة على حدودها فعلاً، وهي تواصل تعزيز أمن حدودها مع سوريا والعراق على أمل منع تسلل الإرهابيين، وعمليات التهريب، والدخول غير الشرعي للاجئين إضافيين. وفي الشهر الماضي، أعلن قائد قوات «حرس الحدود الأردنية»، العميد سامي الكفاوين، أنه تمّ تخصيص "نصف جيش المملكة والموارد العسكرية" لتأمين تلك الحدود. ومع ذلك، شهدت الأردن ارتفاعاً كبيراً في النشاط الإرهابي المحلي خلال العام الماضي كان مستوحىً عموماً من تنظيم «الدولة الإسلامية». وإلى جانب التصدي لهذه التهديدات الأمنية، تأتي إعادة فتح الحدود مع سوريا والعراق، أكبر شركاء عمّان التجاريين، على رأس قائمة الأولويات الأخرى للأردن.
ويصبّ الحدّ من تدفق اللاجئين الهائل من سوريا في مصلحة الولايات المتحدة أيضاً. فإدارة ترامب قلقة بشكل خاص من التهديد الإرهابي الذي قد يشكله اللاجئون على أوروبا والولايات المتحدة. وعلى غرار [رؤية] عمّان، يُعتبر إيواء السوريين في أماكن تواجدهم كونهم مشردين داخلياً إلى حين انتهاء الحرب خياراً جذاباً بشكل متزايد بالنسبة لواشنطن.
الحالة الراهنة
في السنوات الأخيرة، كانت الاستخبارات الأردنية تعمل بصورة غير علنية في جنوب سوريا، بتنسيقها مع القبائل وقوات المعارضة المعتدلة من أجل إقامة منطقة عازلة تمتد على طول سبعين كيلومتراً تكون خالية من تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة فتح الشام» التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة». وتمتد هذه المنطقة شرقاً من مرتفعات الجولان وتغطي المناطق الأكثر كثافة سكانية على طول الحدود. وفي إطار هذه الاستراتيجية، كانت عمّان تعمل مع وحدات المتمردين من «الجيش السوري الحر» في الجنوب. ولم يتمّ الكشف عن الكثير من تفاصيل تلك العمليات، ولكن وفقاً لمقابلة إماراتية جرت مؤخراً مع مسؤول في «الجيش السوري الحر» يُقيم في درعا، يستهدف الأردن المسلحين ومستودعات الأسلحة الخاصة بـ «جيش خالد بن الوليد» التابع لتنظيم «الدولة الإسلامية»، مستخدماً الطائرات الحربية وطائرات مسلحة بدون طيار لضرب أهداف على الحدود في حوض اليرموك غرب درعا، من بين عمليات أخرى.
كما يتنامى قلق المملكة إزاء انتقال «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني، والميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران، و«حزب الله» اللبناني إلى المنطقة الحدودية. فقد بدأت المشكلة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، حين أقدمت عناصر «حزب الله» بمساعدة قوات الأسد النظامية والدعم الجوي الروسي على الاستيلاء على بلدة الشيخ مسكين إلى الشمال مباشرة من درعا التي تتميز بموقع استراتيجي. وعلى أثر ذلك، اعتبرت عمّان ذلك الهجوم بمثابة تحذير حيال برنامجها المحدود القائم على تدريب جماعات المعارضة وتزويدها بالعتاد، فقامت بوضع حدّ له. وقد نبع إذعانها من مصدري قلق ملحّين: (1) أن أي تقدّم إضافي لهذه القوات المدعومة من روسيا قد يدفع بالمسلحين الإسلاميين إلى التوجه أبعد إلى الجنوب، و(2) أن طهران قد تتمركز أساساً على طول حدود المملكة إذا تمّ ترسيخ هذه المكاسب. وبخلاف ما حصل مع الجهاديين، لم يكن باستطاعة الأردن إشراك وكلاء إيران عسكرياً في سوريا - وسرعان ما أدركت عمّان أن روسيا هي الجهة الفاعلة الوحيدة القادرة على وقف تقدّمهم نحو الحدود.
دور روسيا
من خلال إدراك الأردن للديناميكيات المتغيرة في سوريا، فقد قرر التعاون عن كثب مع موسكو ابتداءً من أواخر عام 2015، فأنشأ مركز مراقبة مشترك في عمّان في تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام للتركيز على تبادل المعلومات الاستخباراتية وعدم الانخراط في الاشتباكات. وفي الشهر الماضي، اجتمع الملك عبدالله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بعد فترة ليست طويلة من دعوة روسيا للأردن للمشاركة في مفاوضات السلام السورية في أستانة، كازاخستان. ويتمثّل هدف الأردن غير المعلن من زيادة التعاون مع روسيا في تأمين ضمانات من قبل موسكو بألا ينشر «حزب الله» وغيره من الميليشيات المدعومة من إيران عناصرهم جنوب دمشق، لئلا تتوفر لديهم الفرصة لزعزعة استقرار المملكة (تماماً كما ضمنت إسرائيل تفاهمات روسية مماثلة تهدف إلى مواجهة عمليات نقل الأسلحة إلى «حزب الله» والحد من الأنشطة الإيرانية في الجولان).
وفي حين لم تتمّ مناقشة أي تفاصيل علناً، إلّا أن المناطق الآمنة تبقى خياراً مطروحاً لكل من موسكو وعمان. وكان الأسد قد انتقد صراحة هذه الفكرة، لكنّ موسكو كانت أقل رفضاً لها. وبعدما أعلن الرئيس ترامب أنه أوعز إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين بإعداد خطط لهذه الغاية، ردّ وزير الخارجية الروسي سيرغاي لافروف بالقول إن موسكو "لم تستبعد" إقامة مناطق آمنة للمشردين داخلياً، شرط موافقة الأمم المتحدة والحكومة السورية. بيد، إن ذكر دمشق في هذه الصيغة بدا أشبه بتملّق دبلوماسي أكثر من أي شيء آخر؛ فنظراً إلى ديناميكيات القوة الحالية في سوريا، لا تحتاج روسيا إلى التشاور مع الأسد حول قرار كهذا.
تشغيل المنطقة الآمنة
على الرغم من أنه ليس من المؤكد أن موسكو ستوافق على إقامة منطقة آمنة، إلا أن التعاون الوثيق لمكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن قد يجعل الاتفاق على ترتيب معيّن أمراً محتملاً في الجنوب. وستكون آليات ضمان أمن المنطقة، التي قد تصل إلى بعد عشرة أميال (18 كلم) داخل الأراضي السورية، واضحة إلى حد ما. وإذا ما افترضنا موافقة روسيا - وجرّ دمشق على الموافقة معها - فلن تكون هناك ضرورة لفرض منطقة حظر جوي تقليدية. وبدلاً من ذلك، ستواصل الطائرات الأمريكية والأردنية وغيرها من طائرات التحالف والطائرات بدون طيار لهذه الدول التي مقرها في المملكة تسيير رحلات استطلاع ومراقبة فوق محيط الممر الإنساني. وفي الوقت نفسه، سيزيد الأردن والولايات المتحدة من قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية للقوات الصديقة على الأرض، الأمر الذي سيمكّن القوات المحلية وبصورة أفضل من استهداف الميليشيات الإسلامية والعناصر المسلحة الأخرى التي تحاول دخول المنطقة.
أما المهمة الأكثر صعوبة، فستكون التوصّل إلى تفاهمات بشأن هوية الجهة المسؤولة بالضبط عن الأمن على الأرض. فستصر موسكو على أن لا تصبح أي منطقة إنسانية معسكر تدريب لهجوم المتمردين المقبل ضد نظام الأسد. غير أن الأردن يعمل بالفعل مع الميليشيات المناهضة للأسد في الجنوب، لذلك ستكون هذه الميليشيات القوات الأكثر ترجيحاً التي ستكلَّف بمهمة الدفاع عن المدنيين في هذه المناطق. وحالياً، يقيم هناك حوالي400,000 شخص، وقد يفر إلى المنطقة عشرات الآلاف من النازحين الآخرين مباشرة بعد أن يتم إقامة حزام آمن. فضلاً عن ذلك، أشار مؤخراً وزير التعاون الدولي الأردني عماد فاخوري إلى أنه سيتم إعادة بعض اللاجئين الموجودين داخل المملكة إلى سوريا، لذلك فقد ينتهي المطاف بعدد غير محدّد منهم في المنطقة الحدودية.
وإذا اعتُبرت القوات المحلية غير مقبولة دبلوماسياً أو غير قادرة على تأمين المنطقة، ستكون هناك حاجة لتواجد قوات أجنبية كقوى بشرية - تنحدر على الأرجح من الجيوش العربية. ومع ذلك، فمن غير الواضح أي من الحكومات الإقليمية، إن وجدت، قد تكون مستعدةً لتوفير مثل هذه القوات.
وإذا ما طلبت إدارة ترامب من الأردن نشر جنود في سوريا، ستشعر المملكة بغضاضة إذا رفضت الطلب الأمريكي نظراً إلى سخاء واشنطن المستمر تجاهها - فقد تلقّت عمّان أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية في العام الماضي، كما أنها تضغط على واشنطن لمضاعفة خط أساس التزامها من 1 مليار دولار إلى 2 مليار دولار في عام 2018. غير أن نشر قوات أجنبية ينطوي على مخاطر سياسية كبيرة للملك عبدالله. فقد احتج الإسلاميون الأردنيون بأن المشاركة في التحالف المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» تخالف دستور المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يتألف الجيش بشكل حصري تقريباً من الأردنيين القبليين، الذين يُطلق عليهم سكان "الضفة الشرقية"- ويُعتبرون تاريخياً من مقدمة المؤيدين للحكم الملكي - لذلك فإن وقوع أي خسائر بشرية في سوريا يمكن أن يصبح بسرعة مشكلةً سياسيةً للبلاط الملكي. ونتيجةً لذلك، قد لا يرغب الأردن في نشر قوات برية في أي منطقة آمنة، على الرغم من أنه من المرجح أن يعرض غالبية أي نوع آخر من المساعدة المطلوبة.
وفيما يتخطى المسائل العملية، لا بدّ من معالجة لائحة طويلة من الأسئلة الإدارية من أجل المضي قدماً في تنفيذ أي اقتراح خاص بإقامة منطقة آمنة. على سبيل المثال، مَنْ الذي سيشرف على المنطقة؟ مَنْ الذي سيكون مسؤولاً عن توفير ما يكفي من السكن والمياه والكهرباء والصرف الصحي؟ فالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى لن تدخل الأراضي السورية دون موافقة من دمشق - وهل سيبارك نظام الأسد ما سيعتبره من دون شك انتهاكاً لسيادته؟ وكيف سيتمّ تموين الحزام؟ هل سيكون الأردن بمثابة مركز المنطقة؟ يجب على المخططين أن يحدّدوا أيضاً عدد السكان الذين سيعيشون في الحزام. وإذا اعتُبرت المنطقة آمنة، فقد يتدفق إليها عشرات الآلاف من اللاجئين من سوريا والأردن - فمَنْ سيتحقق من هؤلاء الأشخاص ويحدّد من يمكنه الدخول؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سوف يستغرق شهوراً، ولكن القيام بذلك يشكّل جزءاً أساسياً من مرحلة التخطيط إذا ما أُريد للمنطقة أن تكون صالحة للبقاء وأن تنجح.
فن صفقة (سوريا)
باعتراف الجميع، لا تزال المناطق الآمنة احتمالاً بعيد المنال في الوقت الراهن. بيد، إن التوصّل إلى اتفاق قد يكون ممكناً نظراً إلى إعطاء إدارة ترامب الأولوية لعمليات محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» والتعاون بين واشنطن وروسيا بشأن سوريا في الآونة الأخيرة. وفي حين أن بقاء الأسد في السلطة هو احتمال بغيض، يبدو أن التدخل الروسي قد جعل استمرار حكمه حتمياً. ومع ذلك، إذا رضحت إدارة ترامب لبقاء الأسد في دمشق، فيجب أن تحصل على شيء في المقابل - أي قبول روسيا بإقامة منطقة آمنة في الجنوب يسيطر عليها «الجيش السوري الحر» وميليشيات أخرى غير إسلامية، حتى لو كان هذا الأمر يجعل أساساً أراضي الأسد مجرد دويلة صغيرة.
وقد تتصدى موسكو لذلك، لكن يجب على واشنطن أن تصر على قيام الميليشيات السورية المدعومة من الغرب بتأمين المنطقة الآمنة على الأرض. ومن شأن مساعدة المتمردين على حماية المدنيين السوريين أن يخلق ميزان قوى أفضل على الأرض بين المعارضة والائتلاف الانتقامي للأسد، فضلاً عن إعادة بناء بعض المصداقية التي فقدتها واشنطن منذ عام 2011. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان الضغط المستمر في جنوب سوريا أن يُثني «حزب الله» وجماعات مماثلة عن القيام بعمليات أخرى مزعزعة للاستقرار الإقليمي، مثل إشعال فتيل حرب مع إسرائيل.
ولكن الأهم من ذلك، من شأن إقامة منطقة آمنة في الجنوب أن تسهّل تقديم الدعم الإنساني للسوريين في سوريا - بحيث يكونون مشردين داخلياً داخل بلادهم بدلاً من أن يكونوا لاجئين خارجها. وفي حين قد لا يكون مثل هذا الاتفاق الأمثل [في التعامل مع المشكلة]، إلّا أنه ربما يكون الخطوة الأفضل بالنسبة لواشنطن في وقت تتولى فيه روسيا السيطرة بشكل حاسم.
ديفيد شينكر هو زميل "أوفزين" ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.