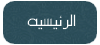أُعِدّ هذا التحليل الإقيليمي كجزء من مشروع "إعادة النظر في العلاقات العربية المدنية-العسكرية: الحوكمة السياسية والاقتصادية في المرحلة الانتقالية" للعامَين 2014-2015، والذي وضعه مركز كارنيغي للشرق الأوسط. سعى المشروع إلى تعزيز البحث حول القوات المسلحة في الدول العربية، وتحدّيات الانتقال الديمقراطي.
لم يكن الجيش السوري مُهيّأً قتالياً عندما اندلعت الأزمة الحالية في البلاد في ربيع العام 2011. فعقودٌ من الفساد جرّدت الجيش العربي السوري من احترافه القتالي والعملياتي. ومع ذلك، استطاع الجيش أن يصمد بعد خمس سنوات في وجه ثورةٍ شعبيةٍ حاشدة، وحربٍ متعدّدة الجبهات، وعشرات آلاف الانشقاقات.
تأتي قدرة الجيش على الإمساك بالأراضي التي تتّسم بأهميةٍ حيويةٍ لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، نتيجة مفارقةٍ غير مُتوقَّعة: العوامل التي سلبت الجيش قدرته القتالية في حقبة السلم، أصبحت قوّته الرئيسة في خضم الحرب. وعلى وجه الخصوص، تحوّلت شبكات الزبائنية والمحسوبية في الجيش، والتي تعود إلى ماقبل الحرب، إلى سلسلةٍ موازيةٍ من القيادة تشدّ عضد النظام. والواقع أن هذا الأخير استطاع، من خلال سحب الجيش من خطوط أمامية محدّدة، أن يعزّز قاعدته الاجتماعية والسياسية والمجتمعية المحلية، بعد أن جنّد ميليشيات مؤقّتة لتلبية احتياجاته من المشاة. سلسلة القيادة الموازية هذه، أتاحت للنظام أن يكيّف استراتيجيته للتفاعل مع ديناميكيات الصراع المتغّيرة بسرعة، وليضمن قبضته على القوات شبه العسكرية الموالية، ويرسّخ نفسه في المناطق ذات الأهمّية.
ليس الجيش مجرّد أداة لاستراتيجية النظام؛ فالطرفان يعملان كهيئتَين متمايزتين ولكن معتمدتين على بعضهما البعض، تحتاج إحداهما إلى الأخرى من أجل البقاء. فتحصُّن فرق الجيش في بقاع واسعة من الأراضي السورية، ساعد النظام في الحفاظ على سيطرته على مراكز سكّانية أساسية. كما أن الجيش يشكّل العمود الفقري اللوجستي للميليشيات التي يرعاها النظام، وقناةً مهمةً لداعمتي النظام: روسيا وإيران. وفي حين أن الميليشيات وفّرت معظم احتياجات النظام من المشاة، حافظ الجيش على سيطرته على القوة الجوية واستخدام الأسلحة الثقيلة. نتيجةً لذلك، تراجع عدد الإصابات والانشقاقات، وتعزّزت صورة نظام الأسد كرمزٍ للوحدة الوطنية. وهكذا أتاح تطوّر الجيش السوري وصموده منذ العام 2011 للنظام الصمودَ في الصراع، والتموضع في موقعٍ يجعله جزءاً لايتجزّأ من أي حلّ سياسي تفاوضي قد يجري التوصّل إليه.
الجيش السوري: ضعيف لكن ذو هيكل مرن
البقاء عبر الفساد
تأسّس الجيش في العام 1946، وسرعان مابرز بصفته لاعباً رائداً في التطوّر السياسي لسورية. في ستينيات القرن الماضي، أدّت الانقسامات السياسية والإيديولوجية العميقة في الجيش إلى سلسلةٍ من الانقلابات العسكرية، أوصل آخرُها وزيرَ الدفاع وقائد القوات الجوية آنذاك حافظ الأسد، العضو في حزب البعث، إلى السلطة في العام 1970. وبمساعدة طاقم صغير من الضباط، حيّد الأسد خصومه. بعد ذلك، حافظ النظام على قبضةٍ مُحكَمةٍ على الجيش، جاعلاً جنوده معتمدين على زبائنية النظام من أجل الحصول على الترقيات والمنافع المادية. وعقب المواجهة الأخيرة للجيش مع إسرائيل في لبنان في العام 1982، تخلّى عن مهمته الأساسية المتمثّلة في محاربة الأعداء الخارجيين، لكنه تحوّل إلى دور أكثر رمزية تمثّل في تعميم سردية محلّية تقول أن إسرائيل والبلدان الخارجية الأخرى، تشكّل تهديداً وشيكاً ومتواصلاً. وأصبح التجنيد العام أداةً فعّالةً لإدارة المجتمع السوري وتعبئته، ولاسيما الشباب منه.
لم تحدث أي تغييرات مهمة في الهيكل التنظيمي الرسمي للجيش، عندما تسلّم بشار الأسد السلطة في العام 2000. فاستمر الضباط في حصد السلطة والموارد بشكلٍ زادَ من الفساد وقلّص القدرة القتالية للجيش.
كانت المزايا الاجتماعية والمالية لضباط الجيش أمراً شائعاً. وعلى وجه الخصوص، عزّزت البرامج الاقتصادية النيوليبرالية التي وضعها الأسد طبقةً جديدةً من شخصيات النظام ومستثمري القطاع الخاص، وشجّعت الروابط بينهم، ما أثرى بعض الضباط من ذوي الرتب العالية. على سبيل المثال، ابتداءً من العام 2007، أطلقت وزارة الدفاع ومجموعة من رجال الأعمال خطّةً مشتركةً لبيع سيارات فخمة لضباطٍ متقاعدين في الجيش بسعرٍ مُخفَّضٍ مُعفى من الضرائب، على أن يُسدَّد ثمن السيارات مع الوقت من خلال اقتطاعاتٍ من رواتب التقاعد الدورية. هذا البرنامج أضفى مكانة اجتماعية جديدة على هؤلاء الضباط: فالسيارات الفارهة لطالما كانت متاحةً فقط للنخبة بسبب الرسوم العالية على الواردات، والتي بلغت حوالى 200 في المئة، وبسبب القدرة الشرائية المحدودة لمعظم السوريين. فضلاً عن ذلك، استطاع الضباط بيع سياراتهم فوراً، حاصدين ربحاً طائلاً من الوفورات الضريبية وحدها.
جدير بالذكر أن الرواتب الأساسية للضباط كانت منخفضة للغاية، وتراوحت مابين 400 و800 دولار في الشهر. لهذا السبب، استخدم الضباط بانتظامٍ نفوذهم المتضخّم طوال عقود لاقتناهم المكاسب المالية الشخصية. فهم يسمحون دوماً للمجنّدين الأثرياء بالتملّص من الخدمة الإلزامية لأشهر طويلة مقابل رشاوى. وقد أصبحت هذه الممارسة شائعةً، إلى حدّ أنها سُمِّيَت بالعامية بـ"التفييش" أو الفيش"، دلالةً على الملف الرسمي الذي يفتحه ضابط في مايتعلّق بشخص معيّن. وغالباً مايعيّن الضباط أيضاً مجنّدين للقيام بأعمال الصيانة والبناء في منازلهم وممتلكاتهم الشخصية، إضافة إلى نقل أولادهم إلى المدرسة بالسيارات العسكرية. كما أنهم يقبلون الهدايا أو الأطعمة المحلية المميّزة من مسقط رأس المجنّدين (في بعض الحالات، العسل من حماة أو الجبنة من دير الزور) مقابل غضّ النظر عن المخالفات.
ومع أن العمل الإداري النموذجي يمكن نظرياً أن يساعد الضابط على التقدّم، إلا أن المحسوبية والزبائنية كانتا تقليدياً العاملَين الرئيسَين في الترقيات، ولاسيما على مستوى الرتب المتوسطة والعليا. فالترقّي لما بعد رتبة عقيد كان ببساطة أمراً مستحيلاً من دون الصلات الضرورية. وفي هذا السياق، تذكّر مجنّد سابق، عُيِّن في وحدة رسم الخرائط في فرقته في الجيش في العام 2002، أنه كان يضطّر إلى القيام بأبسط المهام المهنية لرئيسه العقيد، الذي كان يفتقر حتى إلى المهارات الأوّلية في علم رسم الخرائط. وهذا العقيد بالتحديد، الذي كانت له روابط عائلية في أجهزة الأمن، أصبح عميداً في العام 2005، وتولّى لاحقاً قيادة فوج في درعا في العام 2012.
مع الوقت، تراجع الجيش السوري وأصبح يشبه أي بيروقراطية حكومية أخرى، حيث الطموح الأول للعاملين فيه كان تحسين مواقعهم لتحقيق الكسب الشخصي. وقد تذكّر أحد الضباط القدماء أنه من ثمانينيات القرن الماضي وصولاً إلى بداية القرن الحالي، أصبحت التفتيشات السنوية التي يخضع إليها الضباط، والتي تُعرَف بـ"المشروع الحربي"، عبارة عن تقييمات شكلية – إذ يصل المفتّشون إلى القواعد العسكرية، ويستمتعون بوجبة طعام دسمة مع الضباط، ثم يوقّعون الشهادات الضرورية. وكان كلٌّ من النظام والجيش على علمٍ بهذه الممارسة الشائعة، إلا أنهما لم يفعلا شيئاً للحدّ منها.
عقب انتفاضة العام 2011، سهّل افتقار الجيش السوري إلى الاحترافية، في الواقع، قدرة النظام على السيطرة وتخطّي أقسام سلك الضباط التي عارضت قمع الجيش للمعارضة. لم يكن لانشقاق أكثر من 3000 ضابط، معظمهم من السنّة، في خلال العام 2011، تأثيرٌ ضارٌّ يُذكَر على تماسك الجيش وقدرته العملياتية، بما أن الهياكل الرسمية التي عمل فيها هؤلاء الضباط سابقاً لم تكن أساسيةً لأداء الجيش. وهكذا، برزت شبكات المحسوبية بصفتها سلسلة القيادة غير الرسمية للنظام بحكم الواقع، حالما تعسكرت الأزمة في العام 2012. كان في مقدور النظام أن يصدر الأوامر عبر نظام فعّال قائم على شخصيات موثوقة ترتبط ببعضها البعض بشكلٍ وثيق عبر صلات عائلية وطائفية، وبمصالح تجارية ومالية مشتركة. على سبيل المثال، بدأ ابن خال بشار الأسد والمستثمر البارز، رامي مخلوف، تمويل قوات النمر في العام 2013 تحت قيادة العقيد سهيل الحسن، وهو ضابط مخابرات علوي وشخصية شهيرة لدى العلويين. وقوات النمر هي وحدة نخبوية تتمتّع بتجهيزٍ أفضل من الجيش، وتضمّ ضباطاً معظمهم من العلويين، من الفرقتَين الرابعة والحادية عشرة. كذلك، عمدت إدارة المخابرات الجوية التابعة للنظام إلى تجنيد مدنيين علويين وتدريبهم للالتحاق بهذ القوة الخاصة.
علاوة على ذلك، استطاع النظام، من خلال التحايل على بيروقراطية الجيش الرسمية، أن يتفاعل سريعاً مع الصراع المتفاقم. رَدُّ النظام على التظاهرات في مدينة حمص المركزية في أيار/مايو 2011، في ظلّ وجود مراقبين دوليين، يُظهِر كيف حصل ذلك. فبغية تضليل مراقبي الأمم المتحدة، زوّد أعضاء في النظام للضباط والجنود المحليين هويات مدنية وبزّات شرطة، ونشرهم إلى جانب المتظاهرين، فاستطاع النظام بذلك أن يتملّص من الاتهامات بأن الجيش قمع الاحتجاجات بشكل عنيف.
التحصّن في الأرض السورية
صمد الجيش في بقاع أساسية من الأراضي في وجه تقدّم المعارضة منذ العام 2012، وذلك جزئياً بفضل تنظيمه المناطقي للفرق القتالية. كانت كل فرقة تعيّن في منطقة محدّدة، وفي قسمٍ من الأراضي المحيطة. قيادة الفرقة تقع في تلك المناطق، كما منشآت التدريب، ومخازن الوقود، ومستودعات الذخيرة والمعدات، والمساكن العسكرية. وتشكّل هذه المنشآت، إلى جانب أي مراكز سكانية ومنشآت مدنية مجاورة تقع ضمن منطقة عمليات الفرقة، وحدةً إداريةً معقّدةً تُعرَف بالقطّاع.
من خلال تَحصّن كل فرقة في قطّاع ما، تصبح مهنة الضابط وحياته متشابكتَين مع فرقة الجيش المحدّدة والقطاع حيث يتواجد الضابط والفرقة. وهذا الأمر حال دون انشقاق الضباط. وفي المقابل، يمنح الجيش قائد الفرقة تفويضاً مطلقاً للتصرّف بالمنطقة التي يُشرِف عليها. وقد أُضفي الطابع الرسمي على هذه الصلاحية في باب القانون العسكري السوري المتعلّق بمسؤوليات الضباط، وينصّ على أن "القائد يستطيع التعامل مع أي حَدَثْ ضمن قطاعه، من دون طلب إذن القيادة [وزارة الدفاع في دمشق] إن لم يكن ثمة تواصل أو في الحالات الطارئة".
أسّس الرئيس حافظ الأسد نظام القطاع بدايةً في العام 1984 بهدف تحييد الطموحات السياسية لشقيقه رفعت، بعد أن بدا أن مرضاً ألمَّ به لفترة وجيزة وشرّع الأبواب أمام خلافته. وبعد إعادة توكيد سيطرته واستئناف مهامه الاعتيادية، عيّن حافظ الأسد رؤساء عددٍ من فرق الجيش والقوات الخاضعة إلى قيادتهم في قطاعات محدّدة، للحؤول دون حصول أي تحدٍّ لحكمه. هذا الانتقال إلى نظام القطاع مكّن القادة من تشكيل إقطاعيات في مناطق أساسية من البلاد حيث تقع هذه القطاعات. على سبيل المثال، خلال تسعينيات القرن الماضي، سيطر قائد الفرقة الأولى، إبراهيم الصافي، على بلدة الكسوة والمناطق المحيطة بها على مشارف دمشق، حيث تواجد قطاع الفرقة الأولى. ولاستعراض سطوته، بنى بشكل غير شرعي منزلاً صيفياً خارج محيط القطاع، بالقرب من مساكن المدنيين في الكسوة – ولم يلقَ سوى معارضة ضئيلة، هذا إن وُجِدَت. في الوقت نفسه، استطاع الرئيس استخدام نظام القطاعات للحدّ من نفوذ قادة الفرق، بتأليب أحدهم على الآخر، وبالتالي تجنّب أي عمل مشترك بينهم من شأنه أن يؤدّي إلى انتزاع السلطة عبر انقلاب عسكري.
قدرة الجيش على الصمود
في آذار/مارس 2011، كان الجيش السوري يتألّف من اثنتي عشرة فرقة، تركّز ثقلُ توزّعها على قطاعاتها بشكل كبير في جنوب البلاد وجنوب غربها الأقرب إلى إسرائيل، ماعكس الاعتبارات الاستراتيجية لسبعينيات وثمانينيات القرن الفائت. كانت الفرقتان الخامسة والتاسعة، ولاتزالان، متمركزتَين في ضواحي مدينة درعا الجنوبية؛ أما الفرقة الخامسة عشرة فتتواجد في السويداء، التي تقع أيضاً في الجنوب؛ وثمة ست فرق حول دمشق؛ وتتمركز الفرقتان الحادية عشرة والثامنة عشرة في حمص؛ أما الفرقة السابعة عشرة فتتواجد في الرقة.
مع تقدّم الصراع، احتفظ الجيش السوري بقبضته على الأراضي محقّقاً نجاحاً أكبر بكثير في المناطق التي يقع فيها قطاعٌ متحصّن. ومع أن مساحات واسعة من البلاد سقطت في أيدي قوات المعارضة، بقيت فرق الجيش كلها متماسكة، وهي لاتزال تقود قطاعاتها. الاستثناء الوحيد هو الفرقة السابعة عشرة في الرقة، التي هزمها تنظيم الدولة الإسلامية في صيف العام 2014. والحال أن هذه الفرقة كانت أقلّ تحصّناً في قطاعها من الفرق الأخرى، نظراً إلى أنها كانت أُنشِئَت حديثاً بعد اجتياج العراق بقيادة الولايات المتحدة في العام 2003.
في المقابل، نُشِرَت ألوية الجيش في محافظة حلب في المناطق حيث لاتوجد قطاعات عسكرية، ثم انسحبت لاحقاً تحت وطأة تقدّم المعارضة. تلك كانت الحال أيضاً في العام 2012 في محافظة إدلب، حيث أقام الجيش مجمّعاً عسكرياً كبيراً لإيواء الألوية والوحدات التابعة لفرقٍ عدة تعمل في منطقة المسطومة. لم تكن القاعدة العسكرية الواقعة هناك جزءاً من قطاع أُقيم منذ أمد، فسقطت في غضون شهر بعد محاصرتها في نيسان/أبريل 2015 – وانسحب الجيش من دون أن يبذل جهداً جدّياً للحفاظ على موقعه. لكن في قطاعات درعا المُنشَأة منذ وقت طويل، تخضع الفرقتان الخامسة والتاسعة في الجيش إلى حصار أطول مدةً وأشدّ ضراوة من حصار إدلب، ومع ذلك واصلتا السيطرة على المنطقة.
مُقاولة المهام القتالية
إسناد مهام المشاة إلى قوات شبه عسكرية
منذ بداية الحرب، تغيّرت العلاقة بين الجيش السوري وبين نظام الأسد بشكلٍ كاسح. ففي حين أن عناصر الجيش لطالما اعتمدت على النظام للحصول على المزايا من شبكات المحسوبية، قلبت الانتفاضة علاقة التبعية هذه. فالنظام بات يحتاج إلى الجيش للحفاظ على قبضته على الميليشيات التي تقاتل نيابةً عنه – وهو يُلبِس هذه المجموعات المسلحة أيضاً عباءة الدفاع عن الدولة والعمل من أجل المصلحة الوطنية. لهذا السبب يُعَدّ الجيش، أكثر من أي مؤسسة حكومية أخرى، مركزياً لزعم النظام بأنه الحامي الشرعي للبلاد طيلة الصراع. ولذا، إذا انهار الجيش، سيلحق النظام به حتماً بعدها بوقت قصير.
لكن حتى قبل العام 2011، كان الشبان السوريون يجدون طرقاً عدة لتفادي الخدمة العسكرية – وهو أمر أعاق لاحقاً قدرة النظام على شنّ عمليات قتالية طويلة الأمد. فغالباً ماسعى الشبان السوريون وراء وسائل لتجنّب الخدمة العسكرية، بما فيها الذهاب إلى الجامعة، أو العمل خارج البلاد في الخليج العربي لسنوات طويلة، لدفع 5 آلاف دولار بدل إعفاء من الخدمة، أو الفرار كلّياً من سورية.
وإذ أدرك النظام أهمية الجيش، كان عليه معالجة هذا النقص في القوة البشرية. وبغية تحفيز المزيد من المجنّدين، قصّرت الحكومة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في العام 2005، من سنتَين ونصف السنة إلى سنتَين. بيد أن الإصلاحات النيوليبرالية للحكومة جعلت القطاع الخاص خياراً مربحاً أكثر، حتى للعلويين.
كما اتّخذ النظام خطوةً غير مسبوقة في العام 2011، تمثّلت في الإبقاء على المجنّدين الذين يُطلَق عليهم اسم "الدورة 102" حتى العام 2016، ولم يمنحهم سوى راتباً شهرياً يتراوح مابين 60 و100 دولار بصفتهم ضباط صف. لكن حتى هذا التدبير لم يكن كافياً، فلجأ النظام بشكل متزايد إلى إنشاء/واستخدام المجموعات شبه العسكرية.
أتاح قانون الخدمة العسكرية، وهو الإطار القانوني الذي يحكم الجيش رسمياً، استخدامَ المجموعات شبه العسكرية هذه، إذ أنه يسمح "للقوات الفرعية" و"القوات الأخرى التي تقتضي الضرورةُ إنشاءها" بالقتال إلى جانب الجيش. وتقع الميليشيات في الفئة الأخيرة، لأنها تُعَدّ مجموعات مسلحةً مستقلةً تعمل في إطار الجيش. ويُذكَر أن الجيش عبّأ مجنّدين لإنشاء مجموعات شبه عسكرية بدت مستقلة ولكنها في الواقع كانت تعمل تحت إشرافه.
عموماً، كان التجنيد شبه العسكري ناجحاً أكثر بكثير من التجنيد في الجيش، إذ أنه يجري عادةً من خلال الشبكات المحلية غير الرسمية والروابط العائلية أو المجتمعية المحلية. كما أن هذه المجموعات تقدّم راتباً أفضل – 30 ألف ليرة سورية مقارنةً بـ18 ألف ليرة سورية في الشهر للجندي العادي (أي 136 دولاراً مقارنةً بـ81 دولاراً). وتتيح المجموعات شبه العسكرية عادةً للمقاتلين البقاء قريباً من ديارهم – وهو أمر مهم في حربٍ حيث العديد من المقاتلين يهتمّون في الدفاع عن منازلهم ومجتمعاتهم المحلية أكثر مما يهتمّون في الدفاع عن النظام. هذا ومن الأسهل الانضمام إلى مجموعة شبه عسكرية ثم هجرها، مايشكّل إغراءً للرجال في سنّ الخدمة العسكرية، الذين قد يُجنَّدون بدلاً من ذلك لسنوات عديدة.
تشكّل قوات الدفاع الوطني في مدينة حمص مثالاً ممتازاً على قدرة النظام على تعبئة السوريين عبر المجموعات شبه العسكرية. فبحلول منتصف العام 2013, كانت قوات الدفاع الوطني في حمص والمناطق المحيطة بها قد اجتذبت مايناهز الـ30 ألف مقاتل تحت قيادة صقر رستم، وهو علوي تخرّج كمهندس مدني، وابن شقيقة بسام الحسن، الضابط في الحرس الجمهوري الذي أسّس قوات الدفاع الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن رستم لايتمتّع بأي خلفية عسكرية سابقة.
بشكل عام، يمكن أن تُصنَّف هذه القوات شبه العسكرية في إحدى فئتَين: تلك المجموعات التي ترتبط بشكل وثيق بجهاز أمن النظام والحرس الجمهوري عبر العميد بسام الحسن، وتلك التي ترتبط شخصياً بعائلة الأسد ومؤسساتها الخاصة. لذا، عندما كان الحسن يشكّل قوات الدفاع الوطني، كان رامي مخلوف يستخدم أموالاً خاصة لإنشاء جمعية البستان للأعمال الخيرية. ومع أنها كانت بدايةً مؤسسةً خيرية، إلا أنها أنشأت لاحقاً فرعاً أمنياً، يجتذّ إجمالاً العلويين من مركز الطائفة الساحلي في اللاذقية وطرطوس. إضافة إلى ذلك، أُنشِئَت قوة أخرى هي صقور الصحراء، فرديّاً على يد محمد جابر، وهو رجل أعمال تربطه صلات وثيقة بالنظام. وتتمتّع هذه الميليشيات، التي تتمركز حول شخصيات نافذة، بأسلوب مافياوي.
غالباً مايشير أعضاء قوات الدفاع الوطني إلى الحسن على أنه الخال. وعلى نحو مماثل، يُلقَّب محمد منصور بالعمّ، وهو ضابط صف متقاعد يرأس قوةً من قوات الدفاع الوطني في الرقة قوامها 5000 عنصر.
من العام 2012 وصاعداً، انتشرت هذه القوات شبه العسكرية في أرجاء سورية، وتراوح حجمها من عشرة آلاف إلى 40 ألف عضو. وقد نُشِر بعضها فقط في أراضٍ محدّدة يتراوح حجمها من حيٍّ إلى منطقة بكاملها، وجرى تشكيلها وتسريحها بسرعة وفقاً لمهمات راهنة. في المقابل، أظهرت مجموعات شبه عسكرية أخرى درجةً أكبر من التنظيم والهرمية الداخليَّين، مع سلسلسة قيادة واضحة ترقى إلى دمشق. وفي حين تشبه بعض هذه المجموعات كتائب الجيش في كل شيء إلا الاسم، ثمة مجموعات أخرى أشبه بجهات مُقاوِلة خاصة مع مهام محدودة، مثل تأمين نقاط التفتيش ومدّها بالعناصر. في أي حال، حمت القوات شبه العسكرية الجيش من الإرهاق، وهي تُظهِر تماسكاً داخلياً أكثر مما تظهره القوات المسلحة السورية.
لعبة التوازن بين الجيش والقوات شبه العسكرية
بذل النظام مجهوداً كبيراً لإدارة توزيع العمل بين الجيش وبين المجموعات شبه العسكرية، وللحفاظ على ميزان القوى المناسب بينهما. فكان عليه أن يحرص على أن تبقى القوات شبه العسكرية معتمدةً على الجيش، لئلا يتم تجاوزه في عملية صنع القرار، أو يُنظَر إليه على أنه يفقد مصداقيته. وذلك يتطلّب، قبل كل شيء، الحفاظ على التفوّق النوعي للجيش في تمويل الأسلحة وتوزيعها. وقد حرصت دمشق، بشكل خاص، على أن يُحافظ الجيش على احتكاره للأسلحة الثقيلة المتطورة، وأن تحصل المجموعات شبه العسكرية فقط على أسلحة خفيفة أو آليات مدرّعة للاستخدام عند الضرورة.
على نحو مماثل، غالباً مايقوم الضباط السابقون في الجيش، المُنتَدَبون لنقل الأسلحة إلى المجموعات شبه العسكرية، بتوجيه هذه المجموعات واختيار مواقع نشرها استناداً إلى التطورات على الأرض والاستراتيجية العسكرية. على سبيل المثال، أنشأ بسام الحسن قوات الدفاع الوطني، لكن أوكلت مهمة قيادتها إلى هواش محمد، وهو ضابط في الجيش. وفي منطقة الشاعر القريبة من حمص، تخضع قوات البستان عملياتياً وإدراياً إلى إشراف قطاع الجيش المحلي. وينسّق ضباط الجيش لوجستيات البستان مع الفرقة الثامنة عشرة.
النظام كان يُسارع إلى التدخّل في الحالات التي شهدت نشوب نزاع بين المجموعات شبه العسكرية وبين الجيش السوري. فعقب تأجّج التوترات بين الفرع المحلي لقوات الدفاع الوطني وبين وحدات الجيش في حمص، حظّر النظام على أيٍّ كان يتجاوز عمره الخامسة والثلاثين من أن يبقى عضواً في قوات الدفاع الوطني، فخسر كثيرون مناصبهم مدفوعة الأجر، أو انضمّوا إلى قوات شبه عسكرية أخرى موالية للنظام تتمركز في أماكن أخرى. وبالتالي، تقلّص قوام الفرع المحلي للقوة المقاتلة إلى أقلّ من 5 آلاف رجل، وهو تراجعٌ حيّد الخطر الذي كانت ستُشكّله هذه القوة على الجيش أو سلطة النظام.
لكن في الوقت نفسه، دفع فقدان الأراضي النظامَ إلى الاعتماد أكثر فأكثر على المجموعات شبه العسكرية لاحتواء الخسارة واستعادة المصداقية. ومع أن الجيش كان على الخطوط الأمامية في المراحل الأولى للصراع، إلا أن ذلك انتهى بعد معركة بابا عمرو في حمص في العام 2012، حيث تكبّد الجيش خسائر فادحة في الأرواح. وقد سلّطت معركة الخالدية، وهو حيٌّ آخر في حمص في العام 2013، الضوء على مقاربة النظام الجديدة: إذ كُلِّفَت الميليشيات بإزاحة القوات المتمرّدة، فيما كان الجيش يدعمها من الخلف وهو على استعداد لبسط سيطرته عند توقّف القتال. ولمّا كانت المجموعات شبه العسكرية تدير إجمالاً العملية البرية، استطاع النظام التركيز أكثر على تسلّحه وقوته الجوية المتفوّقَين. ومذّاك، دعم الجيش مراراً وتكراراً العمليات شبه العسكرية بالأسلحة الثقيلة في أرجاء البلاد: من حصار بدعمٍ منه في درعا، ونشرٍ للدبابات في بابا عمرو، إلى حملة القصف بالبراميل ضد المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة في حلب.
هذا الدعم المفتوح الذي قدّمه الجيش السوري إلى النظام أدّى إلى حال استقطاب في المجتمع السوري إزاء المؤسسة العسكرية. ففي حين بدأت فصائل المعارضة تُطلق على الجيش اسم جيش الأسد، صوّر النظام الحرب على أنها صراع ضدّ التدخّل الخارجي والإرهاب. وقد عزّزت قدرةُ الجيش على الصمود طوال خمس سنوات من الحرب هذه السردية. وبالفعل، أصبح الجيش يمثّل القانون والنظام بالنسبة إلى العديد من السوريين القاطنين في المناطق الخاضعة إلى سيطرة النظام – بغضّ النظر عن آرائهم السياسية. لكن المفارقة أن الفساد هو أسوأ مايكون في صفوف الجيش، واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين لم يكن يوماً على قدر هذا النطاق الواسع.
التدخّل الخارجي عبر الجيش السوري
شكّلت المساندة الخارجية من داعمَي النظام الدوليَّين والإقليميَّين، روسيا وإيران، عاملاً أساسياً في تمكين الجيش من التأقلم طيلة الصراع، ولاسيما منها المساعدة المالية والموارد البشرية. فقد زوّد كلٌّ من الحليفيَن الجيش بالدعم اللوجستي، إضافة إلى تشكيل أسلاك شبه عسكرية جديدة لاتُحصى تقوّي الجيش ولاتحلّ محلّه.
روسيا على وجه الخصوص، أصرّت على تقديم المساعدة العسكرية عبر قنوات عسكرية موجودة أصلاً. تاريخياً، ربطت الاتحاد الروسي وسلفه الاتحاد السوفياتي صلاتٌ وثيقة وبراغماتية مع الجمهورية العربية السورية؛ فنظام البعث في دمشق كان الأبرز من بين حلفاء موسكو القلائل في الشرق الأوسط. كما أن الجيش السوري أفاد من الدعم التقني والمالي الروسي منذ إنشائه في العام 1946 تحت إشراف سوفياتي. وفي العام 2005، أعفت روسيا سورية من 10 مليارات دولار من أصل دينٍ مقداره 13 مليار دولار لتطوير الجيش السوري بتجهيزاتٍ روسية. كما ازدادت ميزانية سورية لشراء الأسلحة بأربعة أضعاف في خلال السنوات الأربع التالية، وقد أُنفِق نصفها تقريباً على المعدات الروسية. وتواصل دعم روسيا للجيش السوري في الصراع الحالي: ففي شهر كانون الثاني/يناير 2012 وحده، تلقّى النظام 60 طنّاً من الذخيرة من موسكو.
الأهم أن روسيا دخلت الصراع السوري مباشرةً في خريف العام 2015 لتُكمِّل هياكل الجيش القائمة. وقامت روسيا، جنباً إلى جنب مع شخصيات النظام، وبدافعٍ جزئياً من حاجة الحملة الجوية الروسية إلى تنسيقٍ عن كثب أكثر مع القوات على الأرض، بإنشاء وحدةٍ جديدةٍ تُدعى الفيلق الرابع، تجمع مابين قوات من الجيش وقوات من الميليشيات. وتضمّ هذه المجموعة، ومقرّها اللاذقية، قوات شبه عسكرية مرتبطة بالنظام السوري (مثل قوات الدفاع الوطني وقوات النمر)، تحت الإشراف المشترك لضباط سوريين وروسيين وإيرانيين.
في المقابل، اضطلعت إيران بدور فاعل أكثر في نشر الميليشيات، التي تعمل كلها ضمن الإطار العسكري للجيش السوري، على الرغم من تمتّعها بدرجةٍ معيّنةٍ من الاستقلالية. وهكذا، احتفظت مختلف فرق الجيش بسلطتها على قطاعاتها، في حين عزّزت المساعدة الخارجية القدرة القتالية لميليشيات الجبهة الأمامية. وسواء كانت هذه الميليشيات هيئات مُشكّلة حديثاً أم كانت مجموعات مستقلةً قبل الحرب، كما هي حال حزب الله، فهي تعمل في سورية فقط بمباركة النظام وتحت هيكل القيادة الخاص بالجيش. وفي هذا السياق، شكّل لؤي معلا، وهو لواء علوي نافذ، قناةً مهمةً بين السفارة الإيرانية في دمشق وبين الجيش السوري. والواقع أن دوره يشكّل مثالاً يُظهِر كيف يمكن لسلاسل القيادة غير الرسمية للنظام أن تتجاوز هيكليةَ الجيش الرسمية، مستجيبةً بسرعة وبراعة للتطورات، وضامنةً في الوقت نفسه بقاء بُنية الجيش على حالها.
أحد الأمثلة على ذلك برز في بداية العام 2015، عندما طلب قائد فرقة تابعة للنظام دعماً إيرانياً لإعادة تدريب الفوج السابع والستين من الفرقة الحادية عشرة في الجيش، حيث كانت الفرقة تتمركز في حمص، وتولّي الكتيبة مهمة الدفاع عن المنطقة شمال جبال القلمون. وقد سهّل لؤي مُعلا التدخّل السريع لفيلق الحرس الثوري الإسلامي في إيران.
ودفع الإيرانيون لكلٍّ من مدرّبيهم حوالى ضعف مايتقاضاه ضابط سوري عادي، وزوّدوهم ببزات الحرس الثوري، ماساعد في تعزيز الانطباع بأن الفوج السابع والستين أصبح وحدة إيرانية بالوكالة. وأُعيد نشر الفوج لاحقاً مع الفرقة الحادية عشرة ووُضِعَت تحت قيادتها وهيكلها اللوجستية. صحيح أن الإيرانيين تركوا بصمتهم على هذا الفوج، إلا أنه كان جلياً أيضاً أن تدخّلهم جاء ردّاً على طلب الجيش السوري، وأنهم انصاعوا إلى الجهاز الهيكلي للجيش.
مثال آخر هو قوات المغاوير، وهي فرع من قوات الدفاع الوطني أُسِّس في العام 2012 من قبل شخصيات بارزة في النظام ومدرّبين إيرانيين، ليكون قوةً قادرةً على القيام بتدخّل سريع في منطقة عمليات واسعة. ومع أن ضباط قوات الدفاع الوطني هم جزء من هذه القوات، إلا أنهم يُدرَّبون في منشآت الجيش ويُمنَعون من القيام بعمليات مستقلة. ويمكن أن تُنشَر قوات المغاوير فقط بطلبٍ من قادة الجيش، وهي حتى في هذه الحالة تُنشَر لمهام قصيرة فقط دعماً لوحدات الجيش النظامية حصراً. وبالتالي، تعمل هذه الوحدة القتالية المدعومة من إيران والمستقلة ظاهرياً ضمن إطار الهيكل القيادي الشامل للجيش السوري.
في ظلّ هذه التأثيرات الخارجية، حلّت الانتهازية محلّ الاحترافية والعقيدة العسكرية. إذ غالباً ماغيّر الضباط السوريون حلّتهم وسلوكهم وفقاً للجيش الخارجي الذين يعملون معه. فالضباط الذين يخدمون في الفرق التي تتلقّى مساعدةً عسكريةً روسية، يستخدمون المصطلحات العسكرية الروسية، في حين من الشائع أن يزرّر أولئك الذين ينسّقون مع مستشارين إيرانيين ياقات قمصانهم، كما في اللباس المعتمد للحرس الثوري الإيراني. في هذا الإطار، قال ضابط يخدم في فرقة تتلقّى المشورة من الحرس الثوري الإيراني، مازحاً حول مَيل زملائه إلى تقليد المستشارين العسكريين الإيرانيين، إن "الجيش السوري أصبح حسينية" أي محفل حيث الشيعة يحتفلون بالطقوس الدينية. وعلى نحو مماثل، يصف الضباط المستشارين العسكريين الإيرانيين وميليشيات حزب الله بـ"الأصدقاء".
جيش من الضباط
عانى الجيش السوري من خسارة متواصلة للقدرة الاحترافية منذ بداية الحرب. فنواة الجيش تتألّف الآن من طبقة من الضباط تتّصف بالفساد، وهي ذات طابع علوي أكثر من أي وقت مضى. والمهم أيضاً أن ضباط الصف في الجيش شهدوا مهامَهم تُسلَّم إلى المجموعات شبه العسكرية والميليشيات.
غالباً مايشكّل ضباط الصف العمود الفقري للجيش، إلا أن قدرتهم الاحترافية ومكانتهم العسكرية في سورية كانتا منخفضتَين أصلاً قبل العام 2011، وتدهورتا أكثر مذّاك الحين. إذ كُلِّفوا عموماً بمهام إدارية، من دون الحصول على المنافع والفرص التي يتمتّع بها كلٌّ من الضباط والعناصر شبه العسكرية. ولذا، يعتبر الشبان الذين يخدمون النظام المجموعات شبه العسكرية والميليشيات بمثابة خيارات أكثر جاذبية، فهي توفّر حسّاً بالانتماء إلى مجموعة محدّدة، وراتباً أفضل، وفرصة انتزاع المال من المواطنين والتجّار الذين ينبغي أن يمرّوا عبر نقاط التفتيش التي تتولاها عناصر هذه المجموعات.
إضافة إلى ذلك، أسفرت الحرب عن انخفاض حادّ في القيمة الحقيقية لرواتب الضباط (التي انخفضت من معدّل يتراوح مابين 400 و800 دولار إلى 100-200 دولار)، حتى وإن ولّدت فرصاً جديدة لتحقيق الثراء من خلال الفساد. فقد خسرت الليرة السورية حوالى 80 في المئة من قيمتها ماقبل الحرب. ونتيجة لذلك، يلجأ الضباط أكثر فأكثر إلى جمع الرشاوى من المجنّدين في مقابل السماح لهم بتفادي الخدمة العسكرية.
كما وسّع الضباط من ذوي الرتب المتوسطة والعالية، الذين تربطهم صلات بالنظام، شبكات المحسوبية التابعة لهم، عبر الإشراف على الميليشيات ونقل الدعم الخارجي. على سبيل المثال، يتلقّى الضابط المسؤول عن التنسيق بين الجيش وجمعية البستان الخيرية في حمص، 100 دولار إضافية من الميليشيا التي يقودها مخلوف إلى جانب راتبه الاعتيادي.
يستطيع الضباط أيضاً أن يقتنصوا المنافع من خلال إدارة نقاط التفتيش التي تُمسك بها الميليشيات. والواقع أن انتشار نقاط التفتيش وفّر عائدات لكلٍّ من الضباط وعناصر الميليشيات. وقد لقّب السوريون بعض نقاط التفتيش المربحة هذه على مداخل دمشق أو الرقة بـ"حاجز المليون"، في إشارة إلى كمية الأموال الهائلة التي تُحصَّل من الرشاوى من المواطنين الراغبين في المرور عبر الحواجز. كما أن التجار الذين يريدون نقل بضائعهم – ولاسيما المنتجات الغذائية – في أرجاء البلاد، يجب أن يدفعوا ضرائب لمكاتب الترفيق المتواجدة في دمشق، كما في المحافظات التي يمرّون فيها، من أجل أن يرافقهم أعضاء قوات الدفاع الوطني ويسهّلوا مرورهم عبر الحواجز. كما يحصل ضباط الجيش المسؤولون عن وحدات قوات الدفاع الوطني، على منافع مباشرة من رسوم الضرائب، ويحتفظون ببعض منها لأنفسهم، ثم يعيدون توزيع الباقي منها على مقاتلي الميليشيات.
فضلاً عن ذلك، اتّخذ المنتسبون الذين يجري اختيارهم للخضوع إلى تدريب الضباط، هويةً طائفيةً ومحليةً واضحة: فهم علويون بشكل حصري، ويتحدّرون في الأساس من منطقتَي اللاذقية وطرطوس الساحليتَين. ومنذ العام 2011، انضمّ 10 آلاف طالب جديد إلى نظام التعليم العسكري في سورية، الذي قُصِّرت مدّته من ثلاث سنوات إلى سنتَين. وعندما اندلعت الانتفاضة، كانت ثلاث دفعات من المجنّدين (من العام 2008 إلى العام 2010) قد انتسبت إلى الكلية الحربية في حمص. ومن العام 2011 إلى العام 2015، واصلت الكلية الحربية اختيار المنتسبين للخضوع إلى تدريب الضباط، مضيفةً دورةً واحدةً كل عام، من الدورة 67 إلى الدورة 71.
صحيح أن سلك الضباط لطالما فضّل العلويين، إلا أنه لم يكن على الإطلاق مؤسسة علوية حصراً. ففي نهاية المطاف، يبقى الجيش رسمياً علمانياً، ويُحظِّر إظهار الانتماء الطائفي بشكل صريح. فقبل انتفاضة العام 2011، على سبيل المثال، قبلت الأكاديمية العسكرية في حلب والكلية الحربية في حمص مئات طالبي الانتساب كل عام من خلفيات متنوّعة.
على الرغم من أن نظام الكوتا لدخول الكلية الحربية انحاز إلى المنتسبين من المحافظات التي يسكنها علويون (حماة وحمص واللاذقية وطرطوس)، إلّا أن الدخول كان متاحاً لكل المجموعات. صحيح أن تحوُّل الجيش لصالح طالبي الانتساب العلويين المُدقَّق بهم أمنياً، لم يُقَرّ به علناً، إلا أنه الآن سياسة التجنيد القائمة فعلاً في الجيش. فاللافت أن الكلية الحربية تستقطب معظم منتسبيها من المنطقة العلوية الساحلية بدلاً من حمص، وهي مدينة دمّرتها منذ البداية حربُ مُدُن، حيث العلويون اختاروا الانضمام إلى قوات الدفاع الوطني بدل الجيش. ومن شأن هذا التطور أن يوجّه مستقبل الجيش السوري بشكلٍ يشغل صفوفَه العليا علويون من الساحل، بغضّ النظر عما إذا كان النظام سيبقى أم لا.
في أي حال، تأتي هيمنة العلويين على سلك الضباط نتيجة متطلّبات عملية، واستراتيجيةٍ متغيّرةٍ للنظام: أولاً، نُقِلَت الأكاديمية العسكرية في العام 2014 من مدينة حلب ذات الغالبية السنّية، إلى منطقة جبلة بالقرب من اللاذقية، حيث كانت نسبة كبيرة من السكان ماقبل الحرب من العلويين. وعدم قدرة معظم السوريين على التحرّك بحريةٍ في أرجاء البلاد، تجعل من الصعب أكثر على القاطنين خارج اللاذقية أن يخوضوا امتحانات الدخول العسكرية المطلوبة. ثم أن عملية الحصول على التصريح الأمني المطلوب، تجعل من الصعب للغاية تجنيد غير العلويين. علاوة على ذلك، لايخضع المنتسبون الجدد وحدهم إلى تدقيق سياسي وأمني أوسع، بل يطال هذا التدقيق عائلاتهم المباشرة والبعيدة أيضاً. وهذا الأمر يعيق بشدّة حظوظ المنتسبين المحتملين من السنّة، الذين يُحتمَل أكثر بكثير أن يكون لهم قريب ينتسب أو يُشتبَه في انتسابه إلى مجموعة مُعارِضة. لذا، يتضمّن التدقيق الأمني التأكّد من المعلومات من المخاتير المحليين الذين يقدّمون خدمات بيروقراطية للقرى والأحياء الحضرية.
خلاصة
أصبح الجيش أكثر فساداً بشكلٍ كاسح، وأكثر انعزالاً عن المجتمع الأوسع في السنوات الخمس منذ بداية الصراع السوري. فالشبكات العسكرية من المحسوبية والزبائنية، التي كانت أصلاً مترسّخةً بعمقٍ قبل انتفاضة العام 2011، حوّلت الجيش، ولاسيما سلك الضباط، إلى منظمات سرقة وفساد. هذا وأدّى تجريد الجيش من الاحترافية والحرب القائمة إلى تجويف مؤسّسي، الأمر الذي لم يترك أمام الضباط خياراً إلا التواطؤ مع شبكات النظام، واستغلال الفساد للتعويض عن رواتبهم المنخفضة. وإذ أصبح الجيش أقل احترافاً، أصبح أكثر اعتماداً على المنتسبين العلويين للمساعدة في التصدّي إلى مكامن النقص التنظيمي فيه.
مع ذلك، كانت مفارقة صمود الجيش أساسيةً لبقاء نظام الأسد. فإسناد العمليات البرية إلى القوات شبه العسكرية أتاح للجيش أن يتفادى الكثير من الخسائر في أرض المعركة. كما أنه ساهم في تجنّب الانشقاقات الجماعية، وفي تعزيز صورة الجيش لدى مناصري النظام على أنه دعامة راسخة للوحدة الوطنية.
إذا ما انطلقت، في خاتمة المطاف، مفاوضات فعلية لإنهاء الصراع السوري، فليس للنظام ولا للمعارضة أي مصلحة في تفكيك الجيش، لأن من شأن ذلك أن يسفر على الأرجع عن الانهيار التام للدولة السورية وتجدُّد الحرب. وقد استخدم النظام هذا الواقع لمصلحته: فمن خلال حرصه على أن يبقى الجيش مجرّداً من الاحترافية، ضمن اعتماد الضباط عليه، وأطال أمد نفوذه عبر سلاسل القيادة الموازية.
مع ذلك، كانت علاقة الجيش التكافلية مع النظام مضرّةً تماماً لقدرته وتماسكه، ولذا لابد من معالجتها. والحال أن اللجوء ببساطة إلى تطهير الجيش من الضباط العلويين أو قلب هيمنتهم بكوتا طائفية أو إثنية مؤقّتة، سيبوء على الأرجح بالفشل. لذا، من شأن مقاربة أكثر فعالية لأي حكومة جديدة في سورية أن تقوم على الاستثمار في عملية إعادة الاحترافية إلى سلك الضباط بشكل منهجي. فذلك سيساعد في تقليص اعتماد الضباط على شبكات النظام، ويُضعِف بالتالي قبضة النظام على الجيش. كما ينبغي حتماً استخلاص عملية القبول في الأكاديمية العسكرية والكلية الحربية من سيطرة الأجهزة الأمنية ووضع حد لتفضيلاتها. فمن شأن هذا الإجراء أن يضمن تكافؤ الفرص لطالبي الانتساب من الطوائف والمناطق كافة في سورية، على أن يترافق ذلك مع تشديد شروط القبول. في موازاة ذلك، يجب أن يُعزّز دور ضباط الصف ومكانتهم، عبر تدريبٍ أفضل وزيادة سبل الترقّي.
ففي النهاية، من شأن تحفيز كلٍّ من الهوية المؤسسية لمؤسسة عسكرية وطنية موحّدة والولاء لها، أن يعزّز قبول عملية الانتقال السياسي.
------------
الكاتب : خضر خضور
باحث غير مقيم
مركز كارنيجي / الشرق الاوسط