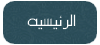دكتور محيي الدين عميمور
أخرج لحظات عن موضوع الحديث لأعيد نشرردّي على تعليق لقارئ كريم من واشنطن،حيث خشيت ألا يكون قد اطلع عليه بعد تحويل الحلقة التاسعة إلى الأرشيف بسرعة، والواقع هوأن “توقيعه” فرض عليّ الاهتمام بالأمر.
قال التعليق، وهو بتوقيع “أبو الطيب المتنبي” : ( كنت و ما زلت أتابع باهتمام كتابات الدكتور عميمور ولكني أحسست بالأمس القريب بمرارة شديدة (يا للهول، على رأي المرحوم يوسف وهبي) و أنا أقرأ له تعليقا يتعمد فيه كتابة اسم بلادي “مغلوطا”. نعم يا سيدي لقد كتبتها هكذا: “موريطانيا” مع أنك لا تكتب “طونس″ ولا “طركيا” ولا أحسبك لا تعرف اسم بلد جار لبلدك و أنت المطلع على دقائق أمور البلاد القاصية.)
ورأيت في الأمر ظلماوتسرعا فكتبت التعليق التالي في الجريدة:
المشارقة في معظمهم ينطقون ويكتبون اسم شقيقتنا الكريمة في المغرب العربي بالتاء، ربما لأنهم يعتمدون الإنكليزية مرجعا،أما نحن في الشمال الإفريقي فننطقها ونكتبها أساسا بالطاء (ط)، أي موريطانيا، لأن اللغة الفرنسية التي نرجع لها آليا تجعل حرف (T) يُنطق طاءً إذا جاء بعدهحرفُ رفعٍ مثل (O) وهو ما نراه في نطق تسمية صاروخ “طوماهوك” أو كان بعده حرف (A) مثل “طاكسي” و”اسطنبول”و”قطر” ومثل “موريطانيا” بالطبع، ولكنه ينطق تاء إذا كان الرفع مشددا بحرفي (OU) مثل طولون وتولوز (مدن فرنسية) وكذلك كلمة (Toujours) ويُنطق حرف (T) تاء إذا كان بعده حرف كسر مثل (Y) أو (i) ككلمتي هاييتي (Haïti)أو تيميشوارا (Timişoara) أو مثل (e) في ( Egypte)ولكن ليس حرف (é) المُخفف(avec accent) حيث تنطق طاء مثل طهران (Téhran)، كما تنطق طاءً إذا تكررت في آخر الكلمة مثل نواقشوط (Nouakchott) وتظل تاء إذا لم تتكرر،وتنطق (T) تاء إذاتلاها حرف (U)مثل تركيا (Turquie) أو تونس، أو حرف ساكن مثل (N) في كلمة فيتنام، ولكن ليس حرف (H) الذي لا يعتبر في اللغة الفرنسية غالبا كحرف ساكن، مثل ليزوطو(Lesotho)
وحتى في الإنكليزية ينطق حرف (T) طاءً إذا كان بعده حرف (L) مكررا، مثل كلمة Tall لأن حرف (A) هنا يُنطق على أنه (O) ويعود إلى أصله في كلمة (Tale) أو (Tail)
وأعترف أنني انتهزت الفرصة هنا لأسجل تعصبي للغة العربية، ولأبرز مدى ثرائها، والتي نلمسها أيضا في التعامل مع حرف(D) الذي قد ينطق دالا أو ضادا،وحرف(S) الذي قد ينطق سينا أو صادا،طبقا لما يأتي بعدهما من حروف (ولهذا راجعت كتابتي لاسم الفريق الغمسي) وهذا كله يجب أن يجعلنا نعتز بالثروة التي تمنحها المترادفات للغتنا كما يمنحها “الربع تون” للموسيقى العربية.
وبالتالي لا أرى داعيا لأي مرارة ، ولامجال لتهكم متسرع، مع الشكر
وأعود إلى سياق أكتوبر.
فقد كُشفت فيما بعد تفاصيل لقاء أسوان، وعُرف أن كيسنجر مارس خبثه المعتاد، فطلب من السادات، ومقابل انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية للقناة، أي منطقة الثغرة وطريق السويس، أن تقوم مصر بسحب متوازن في حجم القوات من الضفة الشرقية، التي عبرت إليها القوات المصرية بأداء رائع متميز وبتضحيات كبيرة من الدماء والأشلاء والمُعدّات.
ويقول وزير الخارجية الأمريكية موضحا ذلك بأن : “الخطوط المصرية سوف تبقى في مواقعها، وهو ما يعني أن موقف السادات سيظل قويا أمام شعبه وحلفائه، وكل ما سيحدث هو تخفيف في الكثافة بالنسبة لحجم الأفراد وكمية السلاح ونوعيته، ولن يعرف أحد على الإطلاق بكل ما سوف يحدث داخل الخطوط المصرية، وهو (كيسنجر) يتعهد بأن يظل الأمر سرّا، ولن يعرف به إلا القوات العسكرية المصرية، وبالتالي فإن الأمر سهل جدا، اللهم إلا إذا كان الرئيس السادات غير مطمئن لقبول الجيش المصري قراراته” !!??.
وكان فخا خبيثا وقع فيه السادات، وهكذا ردّ على الفور، وقد حركته الكبرياء والعنجهية التي استثارها كيسنجر عمدا : “إن جيشي يطيع أوامري، وقيادتي سوف تنفذ أي أمرٍ أصدرُه لها”.
وهكذا تعمد الجانب العربي إخفاء ما يعرفه العدو من تنازلاته والتستر عليها أمام شعبه الذي يلتف حوله ويهتف له مما جعله رهينة لابتزاز الخصم المُرابي، فيروح يطالب بتنازلات جديدة، مهددا، بشكل أو بآخر، بفضح موقف المسؤول العربي، وهو ما كان المفاوض الأمريكي يعرفه ويحاول استغلاله بكل وسيلة ممكنة وفي كل ظرف مُتاح.
وينتهز كيسنجر الفرصة فيسجل قبول السادات لتصوره ويقول له بأنه : “يلتزم بأن يحصل الرئيس المصري على ثمن كافٍ لهذا التنازل الضخم الذي يرجو أن يعتبره تنازلا له وليس لإسرائيل”، ثم يخرج من حقيبته وثيقة كانت معدة للتوقيع، وتتضمن أساسا تجريد الجيش المصري من قوته الضاربة التي يمكن أن تهدد إسرائيل أو تلزمها بأي انسحابات لا تريدها، وكان من بين ذلك حظر وضع قوات مدفعية وصواريخ دفاع جوي (أكرر …دفاع جوي، وليس صواريخ هجومية) في المنطقة التي تمتد 30 كيلومترا غرب القناة، أقول…غرب القناة.
وكان هذا هو ما قبله السادات، وصُدم به واحد من أبرز الأبطال الحقيقيين لحرب أكتوبر، وهو الفريق عبد الغني الغمسي عندما بلغه نبأ اتفاق لم يُستشر فيه، وافق عليه البطل الزائف المتعجل لركوب سيارة مكشوفة يتلقى فيها هتاف الجماهير، تماما كما تنبأ دايان.
انزعج الفريق، وسالت دموع الكبرياء من عينيه وهو يسمع مع آخرين، في حين أنه المعني الأول، عن الاتفاق الذي قبِله الرئيس السادات مع كيسنجر بدون استشارة القيادة العسكرية أو القيادة الديبلوماسية أو حتى القيادة الإعلامية التي كان يتولاها كل من عبد القادر حاتم من الجانب الإداري ومحمد حسنين هيكل من الجانب السياسي، وشعر الجنرال المصري العظيم بأن شرفه وشرف الجيش المصري قد تعرضا لإذلال شديد، فقد نزل الاتفاق بالقوات المصرية، التي عبرت القناة بنجاح رائع وبحجم بسيط من الخسائر في الأرواح، حيث لم تتعد الخسائر، كما يروي محمود رياض، 280 شهيدا، في حين كان تقدير القيادة عند بدء التخطيط للحرب سقوط عدة آلاف، وكان العبور بقوة جيشين من 150 ألف رجل و 1200 دبابة و 2000 قطعة مدفعية، وضاع هذا كله بقبول السادات لمشروع كيسنجر الذي هبط بالقوات المصرية شرقي القناة، كما يقول هيكل ويؤكده إسماعيل فهمي (ص 102) إلى 7000 رجل و 30 دبابة (وكان كيسنجر يتوقع ألا يقل عدد الدبابات التي يصر عليها الرئيس المصري عن 250 دبابة) وستة بطاريات مدفعية لا يزيد مداها عن 12 كيلومتر، وجرى تجريد منطقة المواجهة الفاعلة في الضفة الغربية للقناة من صواريخ الدفاع الجوي ومدفعية الميدان الثقيلة.
ويقول الرواة أن الفريق الغمسي قام على الفور من مقعده وتراجع إلى ركن قصي أطلق فيه العنان لدموع كبرياء لم يستطع أن يكبحها، فقد جاءته الضربة من رئيسه والقائد الأعلى لقواته العسكرية، الرجل الذي سيرتدي زي الماريشالية ويحمل عصاها، وكأنه روميل أو مونتغومري، وهو زي استلهم السادات في تصميمه الزي الألماني، ليكون زيّاً متناسبا مع لقب بطل الحرب، الذي سيضاف له فيما بعد لقب بطل السلام، وهو ما سوف أتحدث عنه في حينه.
ولم ينس كيسنجر وهو يغادر أسوان أن يطلب من السادات سرعة الحركة في رفع حظر البترول عن الولايات المتحدة، لأن ذلك سوف يُشجع الرئيس نيكسون ليكون أكثر حزما مع إسرائيل، كما طلب منه أن يرتب جدّيا لإعادة تعمير مدن القناة، وهنا طلب السادات من الوزير الأمريكي أن يساعده في تعميرها، وطلب منه أيضا أن يزور دمشق لتهدئة الرئيس الأسد، حتى لا يثير ضجة تؤدي إلى التشويش على ما وصلت إليه اجتماعات أسوان (أي أن خلفية السادات لم تكن مساعدة حليفه، “موسوليني” كما كان يسميه، لانتزاع بعض حقوقه، وإنما تفادي حدوث ضجيج يؤثر على ما أدّت إليه إملاءات الوزير الأمريكي على الطرف المصري في أسوان)
وهكذا، والقول دائما لإسماعيل فهمي : ” تنازل السادات عن كل المكاسب التي حققها الجيش المصري (..) وخضع لما فرضته إسرائيل من تخفيض الوجود العسكري في شرق القناة إلى حجم غير ذي قيمة، وأصبح بإمكان غولدامائير أن تدّعي بأنها أعادت الوضع تقريبا إلى ما كان عليه قبل العمليات العسكرية التي انطلقت في السادس من أكتوبر عام 1973، ولم تكن تلك التنازلات تعكس مقدرتنا العسكرية، بل تعكس خوف السادات من أي قتال جديد، فهو لم يكن مستعدا بأي صورة مهما كانت لكي يصطدم من جديد بإسرائيل (وهذا يؤكد ما أشار له محمود رياض) وقد دفعه الخوف من تجدد القتال إلى الموافقة على مطلبين إسرائيليين غير مدرجين في الاتفاق الأصلي، وهما إعادة فتح قناة السويس وتعمير المناطق التي دمرت غرب القناة، وكانت هذه كلها ضمانات إضافية لإسرائيل، حيث أن استثمار مصر الأموال والإمكانيات لإعادة فتح القناة وإعادة بناء مدنها سوف يجعلها تتردد قبل أن تستأنف أي عمليات عسكرية (..) كما أن مكانة السادات الدولية سوف تتأثر بصورة سيئة إذا أعيد غلق القناة (..) وسيكون من الأسهل لإسرائيل أن تشعر ببوادر الحرب في فترة مبكرة”.
وهنا يقول محمود رياض بأنه إذا كان يوم 7 نوفمبر (اللقاء الأول بين السادات وكيسنجر) هو بداية التنازلات الساداتية لكيسنجر، فإن 17 يناير (يوم اختتام لقاء أسوان) هو اليوم الذي أقر فيه الرئيس المصري للوزير الأمريكي بالتسليم الكامل لمشاريعه، وإعلان التنازل باسم الدول العربية عن السلاح الاستراتيجي القوي، والوحيد الذي بقي في أيدينا وهو سلاح البترول.
(وأرجو أن يكون هذا في الأذهان عندما نستعرض تراخي النظام المصري في تعمير منطقة سيناء والذي كان سيكون بالنسبة لمصر، لو تم إنجازه، حاجز كثافة سكانية تواجه أي محاولة إسرائيلية للعدوان وتثبط عزيمة الغزاة، وإنذارا مبكرا بأي عدوان أرضي محتمل لن يكون في حاجة لأجهزة إنذار إلكترونية لأنه سيعتمد على العين المجردة للمواطن)
ويروي هيكل (ص 281) بأن كيسنجر كان يقول لكل من يُقابله أن : “السادات يملك مرونة هائلة في اختيار مواقفه، فهو غير مقيد بتوجهات الرأي العام العربي، وإنما يهمه الرأي العام المصري، وهو يستطيع التحكم في توجهاته بوسائل الإعلام المحلية”، ولعل مما ساعده على ذلك إلى أقصى حدّ عنصران رئيسيان، أولهما قوة الإعلام المصري الحكومي والتزامه المطلق بتوجهات السلطة، وهو ما يجعل منه أحيانا أكثر ملكية من الملك، أما الثاني فهو عنصر الوفرة الكبيرة للمادة الإعلامية المحلية التي تجعل المواطن المصري يكتفي بها ولا يبحث عن وجهات نظر مخالفة، وبهذا لا يسمع إلا صوتا واحدا هو صوت أبواق السلطة.
وسنجد عبر التاريخ أن هذين العنصرين سيتحكمان إلى حد كبير في وضعية العلاقات المصرية مع الوطن العربي، خصوصا عندما تمكنت الشعوب من معرفة التفاصيل التي لم يكن الشعب المصري يعرفها.
وظل الإعلام الحكومي المصري، في معظمه، يتصرف بأسلوب أحمد سعيد، ويتصور كواكبُه أو أقماره الاصطناعية أن مجرد هجومهم على سياسي عربي يكفي ليسقطه كتفاحة ضامرة، ونسي القوم أو تناسوا أن أحمد سعيد، وأيا كان تثمين أدائه، إعجابا أو استهجانا، كان مناضلا ارتبط بمرحلة الريادة العربية، وعبّر عن قيادة سياسية متألقة يمثلها قائد وطني استراتيجي النظرة، وهي قيادة كانت، وبرغم كل ما يُمكن أن يُقال عن الأخطاء والعثرات، تجسد إرادة الصمود والتحدي التي تعبر عن كل عربي.
لكن ذلك انتهى بعد أن أجهضت السياسة أهم إنجازات العبور العظيم.
وهكذا لم يبق أمام أقمار الإعلام الاصطناعية إلا التركيز على الداخل، وهو ما سوف يُضاعف من حجم التدليس والاختلاق ليستنفر عداء المصريين تجاه كل ما حولهم ومن حولهم، مما سيصل بهم أحيانا إلى وضعية “بارانويا”، يدعمها مركب استعلاء سهر النظام دائما على استثارته كعامل رئيسي لضمان التأييد الشعبي، وهو ما سوف يتسبب في كراهية متزايدة للمصريين عبر الوطن العربي، كان مؤسفا أنها ظلمت أخيار مصر ومثقفيها وطلائعها، بل وشعبها نفسه، بعد أن أصبح التعميم قاعدة عامة.
وتوالت الأفعال وردود الأفعال بما أدى إلى خنق كل الأفكار الوطنية المتفتحة وإلى تفاقم الشوفينيةالانغلاقية في الشارع المصري، وبالتالي تزايد التعصب للسلطة والترديد الآلي لطروحاتها، وهو ما كان الهدف المطلوب، لكن المُشكل هو أن ذلك حدث على حساب المصالح الحقيقية لمصر وعلى حساب قبول الوطن العربي للمصريين.
وأصبح “بطل الحرب” لعبة في يد كيسنجر، ويقول إسماعيل فهمي بأنه خلال المراحل النهائية من مفاوضات أول اتفاق لفك الاشتباك، عقد كيسنجر اجتماعا مغلقا مع السادات، وعقب الاجتماع، الذي لم يحضره، وفي السيارة التي كانت تقل الوزيرين، ضرب الأمريكي على صدره متفاخرا ومُعتزا بانتصاره، وقال : إن الاتفاق هنا (في جيبي) ولن يستطيع أحد إلغاءه الآن، ويجيبه فهمي بسرعة : هناك رجل يستطيع تحطيم كل هذا، هو أنا، إذا أعلنتُ اليوم استقالتي، ويردّ كيسنجر منزعجا : من فضلك إسماعيل، لا تفعل، إن السادات يُعلّق أهمية كبيرة على هذا الاتفاق (ص 101 – وكان المؤسف أن إسماعيل فهمي لم يستقلْ آنذاك، لأن الاستقالة لم تكن تصرفا مألوفا في السياسات العربية، وبالتالي كان يُمكن أن يكون لاستقالته أثر على تطور الأحداث.
وقد يشكك البعض في شخصية إسماعيل فهمي بالتركيز على بعض هناته، ولكن هذا ليس كافيا ليشكك في الحقائق التي يوردها، والتي تتطابق مع ما تناولته أقلام أخرى، مصرية وغير مصرية، وأنا لم أقل يوما أن الوزير المصري هو ملاك).
http://www.raialyoum.com/?p=331982