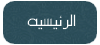في الساعات الأولى من صباح السابع من نيسان/أبريل، أطلقت الولايات المتحدة تسعة وخمسين صاروخاً جوالاً من نوع "توماهوك" من مدمّرتين في شرق البحر الأبيض المتوسط على قاعدة الشعيرات الجوية جنوب حمص. وأفادت التقارير أنّ هذه القاعدة الجوية شكّلت نقطة انطلاق الطائرات العسكرية السورية التي أطلقت الذخائر الكيماوية على بلدة خان شيخون في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل، لتعود وتستهدف أحد المستشفيات الذي كان يعالج الجرحى، مما أسفر عن مقتل ما يصل الى مائة شخص من المدنيين من بينهم عشرات الأطفال.
ووفقاً لبيان لوزارة الدفاع الأمريكية، استهدفت الغارة طائرات، وأماكن إيواء الطائرات المحصّنة، ومواقع تخزين النفط واللوجستيات، ومخازن إمدادات الذخيرة، وأنظمة الدفاع الجوي، والرادارات، لكنّها تجنّبت مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية. ومن المرجّح أن يكون تأثير هذه الغارة على العمليات الجوية السورية متواضعاً، إذ إنّ قاعدة الشعيرات ليست إحدى القواعد الأساسية لعمليات نظام الأسد. ومن المرجّح أن يكون التأثير الأولي سياسياً، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان النظام السوري سيوقف الآن هجماته بالأسلحة الكيميائية، وما إذا كانت الجهات الفاعلة الأخرى ستضغط عليه لوقف هذه العمليات.
وربما كان الهدف من الغارة هو ردع القيام بالمزيد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وبالتالي استعادة المصداقية الأمريكية. فقد أدّى فشل واشنطن في الحفاظ على "الخط الأحمر" الذي رسمته عام 2012 حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى إضعاف العلاقات مع حلفائها وتقوية خصومها حول العالم. لذلك شكّل استخدام النظام لغاز السارين في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل، في انتهاك لالتزاماته بموجب "اتفاقية حظر الاسلحة الكيمائية"، اختباراً مبكراً لإدارة ترامب. ولو لم تقم إدارة ترامب في الرد على إطلاق نظام الأسد للأسلحة الكيمائية لكان ذلك سيضر بالمصداقية الأمريكية، مع عواقب وخيمة في الشرق الأوسط وخارجه.
دروس من الماضي
كيف ستردّ سوريا على هذه الغارة؟ يمكن استخلاص بعض الأفكار المفيدة من الطريقة التي ردّت فيها دمشق على الغارات العسكرية السابقة ومن المحاولات الأمريكية السابقة في الدبلوماسية القسرية.
الغارات الإسرائيلية في سوريا. خلال العقد الأول من رئاسة بشار الأسد، شنّت إسرائيل عدداً من الهجمات في سوريا، من بينها غارة جوية على معسكر لتدريب الإرهابيين في تشرين الأول/أكتوبر 2003، وغارة جوية على مفاعلٍ نووي سرّي في أيلول/سبتمبر 2007، واغتيال العميد محمد سليمان في آب/أغسطس 2008، وهو الضابط في الجيش السوري الذي يقال أنّه كان منخرطاً في نقل الأسلحة إلى «حزب الله». وفي جميع هذه العمليات، تجنّبت سوريا الانتقام.
ومنذ عام 2013، شنّت إسرائيل عشرات الغارات الجوية على قوافل الأسلحة السورية الحاملة "أسلحةً واعدة" لـ «حزب الله»، ومنها صواريخ روسية متطورة من نوع أرض-جو وأرض-أرض وصواريخ مضادة للسفن. ولم تقرّ دمشق بهذه الغارات أو تردّ عليها حتى وقت قريب. إلّا أنّه منذ سقوط مدينة حلب في كانون الأول/ديسمبر المنصرم، شنّ الأسد هجومين بصواريخ أرض-جو على الطائرات الإسرائيلية التي استهدفت هذه القوافل، متحلياً بثقةٍ واضحة من انتصاراته العسكرية الأخيرة على قوات المتردين. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لتركيز الهجمات الإسرائيلية على منع هذه الشحنات عوضاً عن ضرب أهداف حساسة للنظام، استمرّت هذه القوافل على مر السنين، حيث أفادت التقارير بأن بعض الأسلحة قد وصلت إلى وجهتها.
ما قبل استخدام الأسلحة الكيميائية. في آب/أغسطس 2012، أدت المخاوف المتزايدة من احتمال استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد المتمردين والمدنيين، إلى دفع الرئيس أوباما إلى تحذير دمشق من أنّ أي استخدام أو نشر للأسلحة الكيميائية هو "خطٌ أحمر" سوف "يُحدث تغييراً في حساباته". وفي تصريحاتٍ لاحقة، أضاف الرئيس الأمريكي أنّ استخدام الأسلحة الكيميائية سيكون "مرفوضاً تماماً" وسيحمل "تداعيات"، ولكن دون تحديد ماهيتها.
وقد تجاهل النظام هذه التحذيرات، وصعّد استخدامه للأسلحة الكيميائية بشكلٍ تدريجي خلال العام الذي أعقب ذلك، لتبلغ هذه الممارسة ذروتها في هجومٍ بغاز السارين في إحدى ضواحي دمشق في آب/أغسطس 2013 أودى بحياة أكثر من 1500 مدني وفقاً للتقارير. وقد وقع هذا الهجوم بينما كان مفتّشو الأمم المتحدة على بعد بضعة كيلومترات فقط في زيارةٍ للتحقيق في ادّعاءاتٍ سابقة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. وفي الأزمة التي أعقبت ذلك، وافقت سوريا - وسط التهديدات العسكرية الأمريكية - على التخلي عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية والانضمام إلى "اتفاقية حظر الاسلحة الكيمائية". إلّا أنّ النظام السوري عاد واستخدم غازَيْ الكلورين والسارين ضد المدنيين والمتمردين، في إشارة إلى أنه ربما قد احتفظ بأكثر العناصر فتكاُ في مخزونه من الأسلحة الكيميائية المحظورة. وباختصار، من خلال التدرجية والتعطيل والإنكار، تمكّن الأسد من التصدّي للخطوط الحمراء والقيود المفروضة على استخدامه للأسلحة الكيميائية، والالتفاف عليها في بعض الأحيان.
وتُظهر هذه التجارب ما يلي:
1. عند مواجهة خصمٍ عازم، غالباً ما تراجع الأسد.
2. عند مواجهة خصمٍ غير محدد الالتزام والعزيمة، يختبر الأسد الحدود [حدود هذا الخصم] من خلال استنزافها أو الاحتيال عليها عندما يكون ذلك ممكناً والتراجع عنها عند الضرورة.
3. عند مواجهة خصمٍ عازم على تعطيل أعماله دون أن ينجم عن ذلك تكاليف كبيرة، سيستمر في أهدافه.
ومع ذلك، فإن العوامل الموقعية التي يمكن قد أثّرت على بعض هذه النتائج السابقة قد لا تحدث التأثير نفسه اليوم. فعلى سبيل المثال، قد يعتقد الأسد الآن أنّه أوشك أن يكسر ظهر الانتفاضة التي دامت ستة أعوام بفضل دعم روسيا وإيران و «حزب الله»، الأمر الذي قد يزيد من قدرته على المخاطرة. وبالفعل، تشير جهود سوريا للتصدّي للغارات الإسرائيلية الأخيرة إلى أن الأمر قد يكون كذلك. وقد أفادت الأنباء أيضاً أنّ النظام قد شنّ المزيد من الغارات من قاعدة الشعيرات الجوية بعد ساعاتٍ قليلة من الغارة الأمريكية مستخدماً طائراتٍ تحمل ذخائر تقليدية.
الدبلوماسية القسرية في العراق. خلال تسعينيات القرن الماضي، لجأت الولايات المتحدة إلى الغارات الجوية والهجمات بالصواريخ الجوالة ونشر القوات من أجل نزع سلاح العراق وضبطه وردع عدوانه على الكويت والأكراد. إلّا أنّ بغداد لم تتوقف أبداً عن مقاومة عمليات التفتيش عن الأسلحة وقرارات حظر الطيران، التي اعتبرتها انتهاكاتٍ لسيادتها. وسَعَتْ إلى إضعاف عزيمة الولايات المتحدة من خلال القيام بأعمال تحدية مستمرة. ومالت الولايات المتحدة إلى الردّ بشكلٍ متوقّع، وتوجيه ضربات محدودة ضد الأصول المرتبطة بالاستفزازات (مثل مواقع الدفاع الجوي التي تهدد طائرات التحالف). وقد سمح هذا الأمر لصدّام حسين بإدارة المخاطر، والحدّ من تكاليف مخاطر سياسة حافة الهاوية، وبالتالي الحفاظ على سياسة التحدي التي اعتمدها، مما دفع واشنطن في النهاية إلى التخلي عن دعمها لعمليات التفتيش عن الأسلحة. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان مقاربة أمريكية أكثر عدائيةً أن تكون أكثر فعاليةً، إذ كان صدّام يملك كمياتٍ هائلة من المعدّات العسكرية [التي أراد] التخلص منها، وكانت لديه دوافع كبيرة للمقاومة لأنّه كان يعتقد أنّه يقاتل حفاظاً على حياته وأنّه لا مجال له للظهور بصورةٍ ضعيفة.
وتحمل هذه التجربة العديد من الدروس الرئيسية التي يمكن تطبيقها في سوريا، وهي:
1. يمكن لردع الخصوم العازمين أو قسرهم أن يشكل تحدياً نظراً للاختلاف في الاهتمامات والدوافع والقدرة على المخاطرة.
2. غالباً ما يكون الحفاظ على الدبلوماسية القسرية صعباً مع مرور الوقت.
3. قد تؤدي التكاليف التراكمية للدبلوماسية القسرية إلى إضعاف الدعم المحلي والدولي للسياسة المعتمدة في نهاية المطاف.
ويقيناً، أنّ الوضع الحالي في سوريا فريدٌ من نوعه من عدّة نواحٍ لأنّ الأسد يعتمد بشكلٍ كبير على روسيا وإيران و «حزب الله» لاستمراره في السلطة. ونتيجة ذلك، من المؤكّد أنّ ردّه على غارة الشعيرات أو أي أعمال أمريكية مستقبلية سوف يتأثّر بلا شك وبشكلٍ كبير بروسيا وإيران. وسوف يتأثّر الحلفاء الثلاثة بما يسمعونه من واشنطن، فضلاً عن تقييمهم لنوايا الولايات المتحدة وعزيمتها. وبالتالي فمن غير الواضح ما إذا كانتا طهران وموسكو ستعتمدان المقاربة نفسها؛ على سبيل المثال، هل ستحثّان الأسد على التصرّف بحذر أو خداع أو صبر أو تحدي؟
وماذا بعد؟
تشير التجارب السابقة إلى أنّ الأسد سوف يستمرّ على الأرجح في تحدي المجتمع الدولي والطعن بالخط الأحمر على الأسلحة الكيميائية، وأنّ الحاجة قد تدعو إلى شن المزيد من الضربات لردعه عن القيام بذلك. وفي المرحلة القادمة، من الضروري أن توجّه الولايات المتحدة عملياتها العسكرية بناءً على الاعتبارات التالية المستمدة من الدروس المستفادة من الجهود السابقة في الردع والدبلوماسية القسرية في الشرق الأوسط، وهي:
1. عدم وضع خطوط حمراء إلّا إذا كانت الولايات المتحدة مستعدّة لإنفاذها.
2. الردّ على محاولات اختبار حدود الولايات المتحدة لأنّ عدم الردّ سوف لن يؤدّي سوى إلى ظهور تحدياتٍ إضافية.
3. ردع استخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية وغيرها من الانتهاكات من خلال الحرمان والعقاب، وكلاهما يهدفان إلى زرع الريبة في حسابات الأسد للتكاليف مقابل المنافع حول الردود الأمريكية المستقبلية وإلى فرض التكاليف.
4. نظراً لأنّ الردود غير المتناسقة محظورة بموجب "قانون النزاعات المسلحة"، فيجب التصدي للتحديات بصورةٍ غير متماثلة، أي عدم الاكتفاء بضرب مصدر الاستفزاز فحسب، بل أيضاً المواقع القيّمة حقاً بالنسبة للنظام. فضرب الأصول "القابلة للاستبدال" سوف تمكّن الأسد من الاستمرار في تحديه، ومعايرة المخاطر، واختبار حدود الولايات المتحدة بأمانٍ أكبر.
5. توضيح أنّ غارة الشعيرات ليست بالضرورة عمليةً وحيدة من نوعها. وخلافاً لذلك قد يظن الأسد أنّه يستطيع أن يتخطى واشنطن عندما يصبح الرأي العام المحلي معارضاً للتدخل، أو عندما تنشغل الإدارة الأمريكية بأزمةٍ أكثر إلحاحاً في أماكن أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الولايات المتحدة التهديد بشنّ غاراتٍ إضافية من أجل اختبار احتمالية الدبلوماسية المتعددة الأطراف، مع الضغط على سوريا للتخلّص من مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية غير المعلن عنها، وامتثالها لقرارات وقف إطلاق النار مع مختلف قوات المتمردين في جميع أنحاء البلاد. فهذا هو أمل أمريكا الأكبر في تجنّب "فخّ الالتزام" (الذي تصبح فيه الغارات التالية ضروريةً لإخضاع الخصم المعارض، حتى لو كان ذلك مؤقتاً)، فضلاً عن الخطر المستمر المتعلق بتوسّع أهداف المهمّة وتصعيدها.
وأخيراً، وبعد أن اتّخذت الولايات المتحدة إجراءً عسكرياً مباشراً ضد الأسد، ، يجب أن تضع في اعتبارها أن أفضل أمل لها في استراتيجية خروجٍ تُعزز مصالحها في سوريا (من بينها الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» والجماعات السلفية الجهادية الأخرى) هو المساهمة في إنشاء قواتٍ من المتمردين غير سلفية فاعلة قادرة على إبعاد السنّة عن المتطرّفين وممارسة ضغوط عسكرية مستمرة على نظام الأسد. إنّ هذه هي الطريقة الوحيدة التي سوف تحرص على احترام قرارات وقف إطلاق النار وتفادي المزيد من التدفقات الكبيرة الجديدة للاجئين. إن التوازن العسكري وحده، والذي يؤدي إلى مأزق مكلف للنظام هو القادر على توليد الضغوط اللازمة للتوصل إلى حلٍ دبلوماسي للحرب، التي كانت المحرك الرئيسي للتطرف الجهادي وحشد المقاتلين في هذا العقد من الزمن. وقد يكون قد فات الأوان على نجاح مثل هذه المحاولة، إلّا أنّ هذا الواقع يجب ألّا يمنع الولايات المتحدة من المحاولة. وقد يكون الحل البديل هو الاستمرار في تطوّع الجهاديين والتزام عسكري أمريكي مطلق في سوريا قد لا ينال دعم الرأي العام إلى أجلٍ غير مسمّى.
مايكل آيزنشتات هو زميل "كاهن" ومدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن.