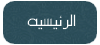هكذا تفاجئنا السياسة بجديدها من حيث نحتسب ولا نحتسب. حيث تتبدل التحالفات، وتختلّ التوازنات القائمة، وتنشأ توازنات جديدة. وتتغير المعطيات على الأرض، وفي طاولة المفاوضات صباح مساء. حتى كان الاتفاق التركي الروسي حول سوريا.
كيف أخرج الروس هذا المشهد؟
مر عام ونيِّف على استفراد الدب الروسي بالساحة السورية منذ تدخله المباشر في سبتمبر/ أيلول 2015، والذي استُقبل باستبشار إيراني، وترقبٍ أمريكي، ورضى إسرائيلي بما قدّم لها من ضمانات، وغضب وقلق تركي في حينه. أعلن الروس أن تدخلهم هو ضد داعش والإرهابيين في كافة أنحاء سوريا، وبالطبع شمل التعريف حينها كل المعارضين السوريين على اختلاف مشاربهم.
أمال ثقل الدب الروسي وعنفه وبطش مخالبه الجوية الكفة لصالح النظام وحلفائه، وأنهك المعارضة المسلحة، فوضع المدن المحررة جميعها تحت النار. وأوقف تقدمها على الأرض، والذي وصل ذروته في مارس/آذار 2015 باستيلاء فصائل ما يسمى جيش الفتح على كامل محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، والذي وضع في مرمى النار الساحل السوري الحيوي جدًا للنظام، ولرعاته الذين يريدون الحفاظ على ما يسمونه «سوريا المفيدة».
كما قطع الروس الحبل الذي بدأ يلتف حول عنق العاصمة السورية من فصائل الغوطة الشرقية وغيرها، وأهمها جيش الإسلام، والذي أوقف الروس سلسلة انتصاراته ضد النظام في عملية «الله غالب» أواخر عام 2016، والتي وصلت إلى حد استيلاء قواته على مقر قيادة الأركان السورية الاحتياطي في جبال دمشق. فكال له الروس ضربة شبه قاضية لم يُفِق منها إلى الآن باغتيال قائده زهران علوش وعدد من قادته بغارة جوية في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وكانت أبرز انتصارات الروس لحليفهم هو حسم معركة حلب – كبرى المدن السورية -، والتي حوّل الروس نصفها الشرقي المقاوم إلى جروزني جديدة. وانتهت شهور الحصار والقصف بإجلاء آلاف المدنيين والمسلحين الذي بقوا فيها، واحتفال النظام وزبانيته بتحرير أنقاضها من سكانها.
توقع الكثيرون في حمّى الانتصار الكاسح أن تلقي روسيا بالمزيد من الثقل لفرض أجندة النظام على كامل التراب السوري، خاصة وأن حوالي 60% من الأرض السورية ما زال خارج نطاق سيطرته، 20% تحت سيطرة «الدواعش»، والباقي للفصائل المعارضة المسلحة بمختلف فصائلها. ورغم أن النظام الآن يحكم – أو للدقة يُحكَم باسمه – المدن الرئيسية (دمشق، حلب، حمص، حماة …)، والساحل الحيوي، فجلُّ مناطقه الهامة في تماس نيراني مباشر مع مناطق للمعارضة. إذ أن غالبية أرياف المدن الكبرى تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.
لكن فاجأ الروس الجميع برغبتهم الظاهرة مع الأتراك – عدو 2015، حليف 2016! – في إيقاف المعارك والوصول إلى تسوية سياسية.
عزف روسي تركي منفرد، وإيران إلى مقاعد المتفرجين سياسيًا ولو مؤقتًا
أعلن منذ منتصف ليل الخميس الفائت 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، عن وقف تام لإطلاق النار في كامل الأراضي السورية، باستثناء أراضي عدوهما المشترك داعش، بضمان روسي تركي، في إهمال ظاهر للإيرانيين ولخيال المآتة المسمى بالنظام السوري، ترجمه الأخيرون على الأرض بخرق القرار في أماكن عدة بعد فرضه بسويعات عديدة، وإن أعلنوا ظاهريًا التزامهم به ورضاهم عنه.
الاتفاق في صيغته الأولى جاء بمثابة إعلان فرض وقائع روسي تركي مشترك، يكون فيه الروس الضامن لالتزام حليفهم بالاتفاق، ويكون فيه الأتراك الضامن لالتزام فصائل المعارضة، والتي أعلن سبع فصائل كبرى منهم – تضم 60 ألفًا من المقاتلين كما قدرهم المندوب الروسي بمجلس الأمن – على الأقل التزامهم بالاتفاق. حصل الروس والأتراك على موافقة مجلس الأمن على دعم نسخة معدلة من القرار، وإضافة مفاوضاتهم المقترحة بين النظام والمعارضة في العاصمة الكازاخية أستانا، أواخر يناير/كانون الثاني الحالي إلى الأجندة الدولية لحل الأزمة السورية.
هل خاف الروس من شبح مستنقع جديد؟
لم يكن متوقعًا على نطاقٍ كبير أن يبدأ الروس موسم جني الحصاد الآن. خاصة وأن الغلظة المفرطة التي تميز بها تدخلهم طوال العام أوحت أن يدهم الباطشة لن تهدأ إلا بانتصار كاسح تام على المعارضة السورية. لكن يبدو أن عدة عوامل جوهرية دفعت بالروس ألا يقعوا في معضلة النصر الكامل الذي يكون في أحيانٍ كثيرة أساس الهزيمة الكاملة.
إذ في الخلفية التاريخية مما سنذكر من عوامل، ما حُفر في ذاكرة الروس من آلام المستنقع الأفغاني في الثمانينات. حيث لا تزال لدغات صواريخ «الستينجر الأمريكية» على أكتاف المجاهدين غائرة العلامات على وجه الطيران الروسي. أنهك الكمين الأمريكي المقدرات السوفيتية، ولم يشفع لهم حينها البطش بمليون أفغاني، فخرجوا بعد أقل من 10 أعوام من تدخلهم في أفغانستان منهكين مدحورين، محمّلين بالهزيمة المذلة وبآلاف النعوش أواخر 1988، لينهار الاتحاد السوفييتي بعد أقل من ثلاثة أعوام، وتلحق به الحكومة الموالية له في كابول بعد عام.
وخلال الأشهر الماضية من التدخل الروسي بسوريا، استفاد الروس من الخط الأحمر الأمريكي الذي حال دون وصول أسلحة متقدمة مضادة للطائرات للمعارضة السورية لعدم ثقة الأمريكان بمعظم أطرافها، إذ كان هذا كفيلًا بتحييد جانب من القوة الضاربة الروسية، وقد يخل بالتوازن ولو نسبيًا لصالح المعارضة. ولا يضمن الروس أن يغير الأمريكان خطوطهم الحمر في أية لحظة.
ما وراء القرار الروسي بـ«التعجيل بالحصاد السياسي» لهذه الحرب
هذا من التاريخ القريب وغير البعيد، فماذا عن الوقائع التي دفعت الروس للتعجيل بالحصاد السياسي لهذه الحرب؟
العامل الأول: الانقلاب التركي
الأتراك المفزوعين من محاولة الانقلاب الدموية المفاجئة في منتصف يوليو/تموز 2016، والمحمّلين بالحنق الشديد تجاه إدارة أوباما، التي أقل ما يتهمونها به في خصوص الانقلاب هو السلبية والحياد تجاهه في ساعاته الصعبة الأولى، والتي عطّلت كل محاولات تركيا لحسم المسألة السورية لصالح الثورة (منعوا عمل منطقة عازلة أو منطقة حظر جوي شمال سوريا – وضعوا خطوطا حمراء على وصول الأسلحة للمعارضة)، والأدهى على الأمن القومي التركي الدعم شبه المفتوح الذي قدمته هذه الإدارة بالسلاح وبالسياسة وبالإعلام للانفصاليين الأكراد في شمال سوريا، حتى أوشكوا أن يستولوا على كامل الشريط الحدودي التركي السوري.
كل هذا دفع الأتراك لحرف البوصلة 180 درجة من واشنطن إلى موسكو. خصوصًا وقد كان موقف الروس من الانقلاب أكثر تقدمًا من الأمريكيين. أكمل الأتراك اعتذارهم عن إسقاط الطائرة الروسية، وتقبل الروس مبادرتهم بقبول حسن، وفتح الطرفين صفحة جديدة سياسية واقتصادية.
في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا بعد أزمة أوكرانيا، وانهيار أسعار النفط التي تمثل موردًا هامًا للخزانة الروسية، يحتاج الروس شريكًا اقتصاديًا محوريًا كالأتراك يقدم – كمثال – مشروعًا ضخمًا كخط الغاز الروسي التركي الذي يغني عن سابقه الأوكراني وما تعصف به من مشكلات، بقدر حاجة الأتراك لهم اقتصاديًا، ودعمًا سياسيًا. ولعل الحاجة الملحة لكل منهما للآخر هي ما دفعت الطرفين لتجاوز أزمة اغتيال السفير الروسي بتركيا بأكبر قدر ممكن من السلاسة حتى الآن.
يعرف الروس جيدًا أولويات الأتراك (تحجيم الأكراد وداعش، والخروج بأقل الخسائر الممكنة للمعارضة السورية المدعومة تركيًا، وتخفيف المحنة الإنسانية للشعب السوري والتي تحرج تركيا كثيرًا، خصوصا مع التعهدات الكثيرة لقياداتها بحماية الشب السوري)، وهذه الأولويات لا تصطدم الآن بخطوط حمراء روسية، ولذا سمحوا لهم بالقيام بدرع الفرات لكسر الطوق الكردي، والقضاء على نفوذ داعش في شمال سوريا كمرحلة أولى.
والآن أدخل الروس المعارضين من حلفاء تركيا في المفاوضات كند للنظام، بعد أن كان التعامل معهم روسيًا كإرهابيين، وبالسلاح فقط. ويحاول الروس الآن أن يتظاهروا بأنهم رسل السلام وإيقاف الحرب. وهكذا يريد الحليفان تقاسم نصيب الأسد من الكعكة السورية بأقل خسائر ممكنة وبأسرع وقت.
ما زالت آفاق هذا التعاون الروسي – التركي مفتوحة في الساحة السورية وسواها .. وسيستمر طالما وجد كل طرف في الآخر ما يريد.
العامل الثاني: ندٌّ أَرِيب خيرٌ من حليفٍ مريب
ليس النظام السوري هو الحليف الذي يستحق أن يكمل الروس من أجله معركة صفرية. نعم سينتصرون به، لكن ليس له إلا بقدر مصالحهم، خصوصًا وأنهم لا يستطيعون التعويل عليه إلا بحذر شديد. على سبيل المثال فخلال الشهر الماضي وفي غمرة معركة حلب، قام تنظيم داعش بهجوم مضاد على تدمر التي كان الروس قد ساعدوا النظام على استعادتها منه في مارس/آذار 2016، فرت القطعات العسكرية السورية، ومعها قيادات كبيرة كنائب رئيس الأركان!، وتركوا الخبراء الروس في قاعدة قريبة من تدمر، ليقوم الغطاء الجوي الروسي العنيف بإخراجهم بصعوبة من طوق داعش.
ولذا فلن يضيع الروس فرصة أن يستكملوا الحصول على ما يريدون تعاونًا مع الند التركي، بدلًا من استكمال الرهان الصفري المحفوف بالمخاطر على النظام السوري المهتريء وحلفائه الطائفيين. وهو في كل الأحوال في بيت طاعتهم شاء أم أبى.
العامل الثالث: كلما تأخر الحل ارتفعت التكلفة
لا يقوى الاقتصاد الروسي المتعثر على تحمل تكلفة حرب طويلة في سوريا. كما أن استمرار النزيف، سيضاعف احتمالات الهجمات الانتقامية ضد المصالح الروسية داخليًا وخارجيًا، وما اغتيال السفير الروسي بأنقرة من هذا ببعيد. ولذا فالإسراع بمحاولات الحل النهائي، وتبريد الصراع ولو مؤقتًا هدف روسي مطلوب. ولا أحد يكره جني المكاسب سريعًا.
العامل الرابع: تحجيم النفوذ الإيراني، ترامب وإسرائيل في الخلفية
ليس الروس أغرارًا ليسلموا سوريا بالمفتاح للإيرانيين، كما سلمهم غيرهم العراق. ولذا سمحوا للأتراك -منافسيهم الإقليميين- للدخول بقوة إلى الساحة السورية. وفرض الروس أنفسهم كأهل الحل والعقد في حلفهم، رغم أن معظم الثمن على الأرض كان من إيران وميليشياتها. ولا ننسى أن بوتين التقى نتنياهو مطولا قبل التدخل في 2015، ولا يطمئن إسرائيل -بجانب إنهاك خصومها في المعركة- إلا تعهدًا روسيًا مسبقًا وحاليًا بتقليم أظافر إيران في سوريا. وإسرائيل رقم إقليمي ودولي صعب لا يمكن لروسيا تجاوزه من أجل إيران.
كما أن ترامب الذي يفصله عن الكرسي شهر، ملتزم بأمن إسرائيل، ومعادٍ لإيران بشكل ظاهر. والروس يحاولون خطب وده، وهذا ما ظهر في تراجعهم عن الرد بالمثل على طرد أوباما لدبلوماسييهم في أزمة التجسس الأخيرة. وبالتأكيد سيكون تحجيم نفوذ إيران عربونًا جيدًا في علاقات ترامب وبوتين المرتقبة.
وكذلك من الطبيعي مع تقدم انتصارات أي حلف، أن تبدأ المصالح الفردية والتنازعات البينية في البروز. نعم لن يتحارب الطرفان، فهما أكثر براجماتية وذكاء من هذا. لكن ترى روسيا أن حجمها، وفعالية دورها يؤهلاها لتكون هي المهيمنة على الساحة التي هندستها باحترافية.
وختامًا..
بعد ست سنوات من النزيف السوري، والملحمة الاستثنائية من التضحية التي قدمها الشعب السوري الصابر، وُضع كل هذا على مائدة مفاوضات السياسيين والقوى الكبرى المحركة للمشهد. وكلنا أمل ألا يكون حظ هذا الشعب الكريم في السياسة، كحظه المتعثر في معركة السلاح التي تُرك فيها أوقاتًا عديدة يحاصَر حتى الجوع، وتنفجر أمخاخ وأحشاء أبنائه في منازلهم بالصواريخ المضادة للتحصينات والقنابل الفراغية، ويموت الآلاف من كِرامِه تحت التعذيب في سجون أكثر أنظمة العالم دمويةً وإجرامًا وطائفية، والمليشيات المتحالفة معه.