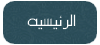دكتور محيي الدين عميمور
يورد إسماعيل فهمي العيوب الرئيسية فيما أصبح يُسمّى”معاهدة السلام”، وهي العيوب التي نتجت عن تنازلات غير مبررة للرئيس المصري، فيقول :
– أنهيت حالة الحرب بين إسرائيل ومصر “قبل” انسحاب إسرائيل من سيناء، وهو عكس للترتيب المنطقي (حيث الانسحاب هو الذي يُنهي حالة الحرب ويُعدّ للسلام)
وأصر الإسرائيليون أنهم في حاجة لثلاث سنوات من أجل إتمام الانسحاب من مناطق، احتلوها في خمسة أيام !!!، وكان تقديرهم أن ثلاث سنوات من الخضوع والإذلال سيزيد من رفض العالم العربي للسادات، ولن يكون في وسعه بعد ذلك أن يتراجع (فهمي ص 352)
– بدأت عملية التطبيع “قبل” الانسحاب الإسرائيلي.
– إجراءات خلق مناطق منزوعة السلاح وتخفيض عدد القوات في المنطقة الواقعة بين البلدين اقتصر تنفيذها غالبا على الأرض المصرية، وتم تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق، ولم يُسمح لمصر بوضع أي قوة عسكرية في المناطق التي تمتد على طول الحدود الشرقية، وسمح لها بوجود 4000 رجل وكميات وأنواع محددة من الأسلحة في المنطقة الوسطى، بل إن وجود الجيش المصري كان محدودا في أقرب منطقة إلى قناة السويس (ص 347) وهكذا فقدت سيناء أهميتها الاستراتيجية الحيوية بالنسبة لمصر، ونقل خط الدفاع الأول عمليا من الحدود الدولية مع إسرائيل، أقصى شرق سيناء، إلى قناة السويس.
ويضيف فهمي بأن الملحق رقم (3) نصّ على إقامة علاقات تجارية وثقافية وثيقة، ستكون بدون شك على حساب كل العلاقات مع العالم العربي، وهو ما يذكرنا بأن مصر وقعت بين 1979 وعام 1981 أربعين اتفاقا في مجال التطبيع مع عدو الأمس.
وتنص المعاهدة على ألا تدخل أطرافها في أي التزامات تتعارض معها، والخلفية هنا هي أن إسرائيل تستطيع أن تزعم، متى أرادت، أن كل الاتفاقات المعقودة بين مصر وأية دولة عربية تتعارض مع نصوص المعاهدة، وهو ما يعني أن “ميثاق الأمن العربي” الذي وقعته مصر منذ أربعين عاما أضحى، كما قال ياسر عرفات يوما على نص معاداة إسرائيل في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية أنه، “كادوك” (Caduc)
ويصل الوزير إلى الاستنتاج بأن المعاهدة تسببت في ضرر بالغ لمصر ولباقي العالم العربي، كما ألحقت ضررا كبيرا بالأمن القومي لمصر، حيث لم يعد لديها ما تدافع به عن نفسها ضد أي اعتداء إسرائيلي، وهي تمنع إنشاء نظام أمن عربي، ويجعل مصر والعالم العربي أكثر عجزا (ص 356)
ويقول عنها كاتب مصري لم أجد توقيعه في النت : سيادة مصر الحقيقية منتهكة ومضيعة من زمن طويل، لا نتحدث عن أسرار، بل عن حقائق مفزعة مدونة في الملاحق الأمنية لما يسمى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (حُذفت البنود المثيرة للجدل ووضعت في ملاحق خاصة)
ففي حرب أكتوبر 1973 كان لمصر 70 ألف جندي في سيناء إلى شرق قناة السويس، وكان لها ألف دبابة، ونزل التعداد ـ باتفاقي فض الاشتباك الأول والثاني ـ إلى سبعة آلاف جندي وثلاثين دبابة لا غير، وبعد مقايضات المعاهدة المذلة، صارت الصورة مرعبة، فقد جرى حجز الوجود العسكري المصري بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة إلى مسافة 58 كيلومترا شرق قناة السويس، وعرفت هذه المنطقة، في ملاحق المعاهدة، باسم المنطقة (أ) ثم جرى إخلاء المنطقة (ب) وبعرض 109 كيلومترات، من أي وجود عسكري مصري سوى أربع كتائب “حرس حدود”، وفي المنطقة (ج) وبعرض 33 كيلو مترا، وإلى حدود مصر مع فلسطين المحتلة وغزة، جرى نزع السلاح المصري بالكامل، واقتصر الوجود على قوات “شرطة مدنية”، ولم تسمح إسرائيل إلا لاحقا، وفي اتفاق سبتمبر 2005، بوضع 750 جنديا من حرس الحدود، وبغرض محدد هو مطاردة وردم “أنفاق الحياة” الواصلة من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية (لتجاوز إغلاق معبر رفح بين مصر وقطاع غزة) وفي كل سيناء جرى حظر إقامة أي مطارات أو موانئ حربية مصرية، بل أن “مقر إقامة الرئيس مبارك نفسه” في شرم الشيخ يقع في المنطقة منزوعة السلاح المصري بالكامل، أي أن الرئيس يقيم في منطقة منزوعة السيادة المصرية، وتحت حد الحراب الإسرائيلية القريبة، وفي وسط تشكيل من قوات متعددة الجنسيات، وتعرف باسم MFO، أو “ذوي القبعات البرتقالية”، وأغلبية هذه القوات أمريكية، وقيادتها أمريكية، وتدفع مصر نصف ميزانيتها البالغة سنويا 65 مليون دولار، ولهذه القوات ثلاث قواعد، أولاها في “الجورة” شرق سيناء بالقرب من الحدود، وثانيتها في جزيرة “تيران” السعودية الأصل بخليج العقبة، وثالثتها إلى جوار شرم الشيخ، ووظائف هذه القوات الأجنبية معروفة، فهي تراقب أي إخلال محتمل بترتيبات نزع سلاح سيناء، ولها حق التدخل عند اللزوم، والبدء في تطبيق مذكرة تفاهم أمريكية ـ إسرائيلية موقعة في 25 آذار(مارس) 1979، أي قبل أيام من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتتضمن تعهدا أمريكيا بالتدخل عسكريا ضد مصر في حال تهديد أمن إسرائيل.
ويتساءل الكاتب: ماذا تعني هذه الصورة؟ تعني، ببساطة، أن قصة السيادة من أحاديث الخرافة، والموجود هو العكس، فقد أعيدت سيناء إلى مصر منزوعة السيادة، أعيدت على طريقة الذي أعطوه قدما خشبية وأخذوا عينيه، فجرى نزع سيادة السلاح في شرق مصر، (وتغيرت الصورة نسبيا بعد الانقلاب المصري في يونيو/ يوليو 2012 فسمحت إسرائيل بدخول قوات وعتاد مصري بل وطائرات حربية تتولى القيام بما عجزت عنه قوات العدو الصهيوني في سيناء)
وفي القاهرة تكفلت بالباقي الأصابع الأمريكية و قفازاتها الخليجية، فتكونت طبقة جديدة تذكر بطبقة أغنياء الحرب التي عرفتها مصر في الأربعينيات، و راحت موارد المحروسة تبدد أو تنهب تنهب كما لم يحدث في تاريخها الألفي، وطفت وطغت طبقة من مليارديرات المال الحرام، فيما تحول الشعب المصري، في غالبه، إلى أفقر شعب في المنطقة، وبين الثراء الناهب والفقر الكادح، وجرت إقامة أضخم جدار أمني مهول وصل بقوات الأمن الداخلي إلى مليون و700 ألف شخص، وهو ما يتعدى ثلاثة أضعاف حجم جيش مصر العظيم.
وكان السلاح الرئيس للرئيس السادات في فرض إرادته الترسانة الإعلامية الهائلة التي سحقت خيرة أبناء مصر وأحسن كتابها، فرضت عليهم قيادات إعلامية مأجورة تخصصت في تشويه الحقائق وخداع الجماهير، وقال عنها يوما وزير الحربية المصري أمين هويدي (صحيفة الأهالي يوم 27 مارس 1985) حينما يضغط الحاكم على الزرّ ينطلقون كالكلاب المسعورة، تنبح وتشتم، وعندما يتوقف الضغط على الزرّ يخرسون.
ويُعلق هيكل قائلا على معاهدة السلام قائلا بأن توقيعها لم ينقذ جيمي كارتر، فسقط أمام رونالد ريغان، ولم ينجح السادات في انتزاع شيء من الرؤساء المتتاليين الثلاثة، نيكسون وفورد وكارتر، في حين أنه أعطاهم الكثير، ليس من أرصدة مصر وحدها، وإنما من الرصيد العربي كله، وساعد على محاولة كبح جماح الثورة الإسلامية في إيران، وحرّض عليها علماء الأزهر متسببا بذلك في سقوط هيبة الجامعة الكبرى كمرجعية إسلامية سنية، وانحصر وجودها بالتالي في كونها إدارة دينية مصرية لا تلزم غير المصريين المسلمين من السنة/، وهكذا وصل الأزهر اليوم إلى استعماله في شرم الشيخ للترحيب بالسياح الأجانب، في حين لم يظهر قسيس واحد في المنتجع المصري الذي راهنت بع وعليه السياحة المصرية لإنقاذ الجنيه من جبروت الدولار.
ويجب أن نتذكر بأن الرئيس السادات سمح بإقامة الشاه المخلوع في مصر، بعد أن رفضه العالم كله بمن في ذلك حليفه الأول في واشنطون، وهو ما كان تنبأ به بو مدين في رسالته لكاسترو، بالإضافة إلى أن السادات سمح للقوات الأمريكية أن تنطلق في عملية إنقاذ الرهائن الأمريكيين المحتجزين في السفارة الأمريكية في طهران من قاعدة قنا المصرية، وهكذا كانت مصر، بتواطئها، شريكة في فشل العملية التي عرفت باسم الصحراء (Desert -1).
وأذكر هنا بالدور الذي لعبته الجزائر لحل تلك القضية، والذي كان أول نجاح دولي تحققه جزائر الرئيس الشاذلي بن جديد، وكان من الرجال الذين بذلوا جهودا كبيرة في هذا المجال سفيرنا في طهران آنذاك عبد الكريم غريب، والذي كان على اتصال مستمر بوزير الخارجية محمد الصديق بن يحيى، الذي استقبل الأسرى في مطار الجزائر في نفس اللحظات التي كان ريغان يستهل رئاسته للولايات المتحدة خلفا لكارتر، الذي أصر الإيرانيون على ألا يعطوه لذة القول بأنه ساهم في الإنقاذ، عقابا له على العملية التي انتهت بمأساة أمريكية.
ولقد أشرت إلى هذا لأنه تردد يومها أن الجزائر تعمدت المساهمة في تأخير عملية الإنقاذ إلى حين انتهاء ولاية كارتر عقابا له على تفريطه في الحقوق العربية، وواقع الأمر أن الذي فرط في الحقوق كان صاحب الحق نفسه وهو الرئيس المصري، ولم يكن كارتر ليستطيع أن يكون أكثر ملكية من الملك.
والواقع أنه كان هناك أمر آخر نبه له هيكل وهو أن المعاهدة المشؤومة لم تكن بالدرجة الأولى صلحا مع إسرائيل، وإنما رغبة الالتحاق بالغرب، وهو يُذكر بقرار قمة بغداد تقديم دعم عاجل لمصر قيمته خمسة ملايير دولار، قال عنها السادات، الذي رفض استقبال الوفد العربي، لأحمد بن سودة، مبعوث العاهل المغربي : هل تظن أنها مسألة مال ؟ لقد انتهى الموضوع، ولست حريصا على البقاء في صفوفكم، ذاك عصر مضى، وأنا لا أريد أن أظل مع المتخلفين، وإنما مكاني هناك، مع المتقدمين (هيكل خريف الغضب – ص 120)
وهنا أذكر بما سبق أن رويته عن فكرة نقل الجامعة العربية بعيدا عن مصر، والتي كانت فكرة أمريكية إسرائيلية تبناها السادات، وعمل على تحقيقها، وإن بيدِ عمرو (وليس عمرو موسى بالطبع) لكن ما لم يقله الرئيس المصري هو تصوره لموقعه بين المتقدمين الذين يريد أن ينضم إليهم، وهل هو جلوس على نفس المستوى أو انبطاحا عند الأقدام، وبغض النظر عن جحوده للحجم الهائل من الأموال العربية التي انهالت على مصر في عهده، وكان يصر على أن توضع في حساب خاص، ولا تحول إلى البنك المركزي، كما طالبت الكويت، وكان يُدرك أنه لا يستطيع إقناع الجزائر بنهجه أو بمنطقه.
وبدأت أشعر أحس بأن المال هو الذي يقف وراء ما يحدث، وليس اعتبارات السياسة وحدها.
وأضطر إلى العودة ثانية إلى السبعينيات، أو المرحلة التي أسماها هيكل مرحلة “أوهام عصر البترول” التي لم تنحصر في مناطق إنتاجه، بل كان هناك: “من وجدوا أنه من الأفضل أن يرحلوا هم إلى البترول بدلا من الوقوف في انتظاره (هيكل – حرب الخليج ص 108) ويقول هيكل في كتابه الشهير “خريف الغضب” أنه ما بين 1974 و 1976 كان هناك تسعة ملايين عربي يتحركون وراء الفرصة السانحة في الخليج وفي العراق (..) ولم يجئ مال البترول وحده (..) وإنما جرّ وراءه عددا من القيم، قيم الربح السريع والاستهلاك الزائد ومداراة الغنى والخضوع السهل لنزواته ورغباته”.
والواقع أنه من الصعب على من عاش مع ذلك الشعب الطيب الكريم في الخمسينيات أن يفهم ما حدث في السبعينيات والثمانينيات وما بعدها إذا لم يتوقف عند دور المال، وهو ما يؤكد الدور المخرب لما سمي بمعاهدة السلام، التي كانت قاطرة شؤم جاءت معها بأحمال من الجراثيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضعت الشعب بين المطرقة والسندان، أي أن الأثر السلبي لتلك المعاهدة غير المتكافئة لم يكن الجانب العسكري السياسي وحده وإنما أيضا الجانب المالي الأخلاقي، لكن بعض المثقفين المصريين واصلوا مواجهته بكل نزاهة وموضوعية، تماما كما حدث مع الأستاذ أحمد زكي أبو المجد في حديثه الأسبوع الماضي لهايدي عبد الوهاب في القدس العربي (السبت 20 فبراير ) نقلا عن صباح الخير ومتحدثا عن نتائج حركة المال المشار إليها في مصر على المواطن، الذي أصبح، كما قال بشجاعة لا تعرف في بلدان كثيرة :”كسولا وغادراً نتيجة التغيرات التي تعرض لها الشعب المصري خلال الأعوام الماضية، وسقطت لديه قيمة الواجب، وانصرف كثير من الأفراد إلى تحقيق مصالحهم الذاتية بغض النظر عن التزامهم نحو المجتمع بالإضافة إلى غياب الإتقان وهبوط مستوى الأداء وانهيار كثير من القيم الحافظة، وهي القيم التي تشد الناس إلى بعضها وتحمي مؤسسات المجتمع كالأسرة والمدرسة وقيم التكافل والود المتبادل داخل الأسرة”.
وأتذكر أنني حضرت في السبعينيات لقاء بين الرئيس بو مدين والصحفي المصري لطفي الخولي، الذي راح يروي للرئيس ما أصاب المجتمع من تخريب لبنيانه واهتزاز في قيمه وضياع لتقاليده نتيجة لأموال النفط وتصرفات بعض من يملكونه، خصوصا في المجال الأخلاقي الذي وصل إلى حد المتاجرة بالمراهقين والمراهقات لإرضاء بعض الشواذ العرب، وكان لبعض ما رواه لطفي أثر رهيب على الرئيس، الذي كان بالغ الحساسية عندما يتعلق الأمر بمعاناة الشعوب، وخصوصا الشعب المصري الذي عاش في أحضانه سنوات، وبدا ذلك على وجهه وهو يستمع للتفاصيل ويهز رأسه يمينا ويسارا وهو يردد: أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد كان واضحا أن عملية مقصودة تجري لتدمير توازن المجتمع وللقضاء أساسا على الطبقة الوسطى، وهي قلعة العمل الوطني في أي بلد كان.
http://www.raialyoum.com/?p=350880