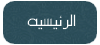بدأتالطفرة البترولية تعطي الفرصة لبعض بلدان المشرق العربي للانفتاح على العلم والتكنولوجيا في أوروبا وأمريكا، ولتستعين بكفاءات كثيرة استوردت من كل دول العالم المتقدم، وبالتالي بدأ الوجود المصري يغيب عن موقع الريادة، وأضيف هذا إلى السخط العربي على إجهاض نتائج حرب أكتوبر بالتلاعبات السياسية، ليؤدي إلى بداية انحسار النفوذ السياسي المصري على الساحة العربية، حيث بدأ الشارع يحس بأن مصر السبعينيات ليست هي مصر الخمسينيات والستينيات التي ألهبت المشاعر من “المحيط” إلى “المحيط”، والتي كانت المرجع الأول في كل تحرك على الساحة الإقليمية، وهو ما أدركته وسائل الاستشعار المصرية، وبدأت تعمل على مواجهته بتزكية المشاعر الوطنية الضيقة داخل مصر، أو الشوفينية الممزوجة بالبارانويا، وكانت وسيلتها أقمار الإعلام الاصطناعية (وأنا أفرق بين نجوم الفكر المضيئة، من كتاب وإعلاميين وفنانين، وبين الأقمار الإعلامية الاصطناعية، وأقصد بهذه كل من يدور في سواقي السلطة كذلك الذي يستعمل في إدارة سواقي الحقول).
وقد كنت ممن أحسوا في بداية الثمانينات بالقلق من الدور السلبي لأموال النفط إذا لم يُحسن استثمارها على الوجه الصحيح، ولعلي كنت متأثرا بالخطاب الرائع الذي ألقاه الرئيس هواري بو مدين في قمة لاهور الإسلامية في فبراير 1974، وألح فيه على ضرورة أن نملك مال النفط وألاّ نسمح له بأن يملكنا، وأن نعمل على استثماره عبر الوطن العربي والعالم الإسلامي، وهوالخطاب الذي قال فيه، في مجال دعوة الدول النفطية لدعم الدول الفقيرة : لا يمكن أن نطلب من المسلمين أن يدخلوا الجنة بمعدة فارغة، وهو ما استثار مرتزقة الدعوة الإسلامية.
وكتبت في مايو 1983 (انطباعات – ج/3 : ص 362) لتحذير النخب في الجزائر، فاستعرضت “الدور الهائل الذي بدأت تلعبه أموال النفط على امتداد الساحة العربية والإسلامية والإفريقية، وما نتج عن ذلك من انقلابات اجتماعية نتجت عن حقن المجتمع بحجم هائل من الأموال، فارتفعت السيولة النقدية، وبشكل يثير الدوار، في مستوى شرائح اجتماعية، لم تكن دائما أكثر فئات المجتمع ثقافة أو وعيا، أو أهم الطبقات إنتاجا وأقدرها إنتاجية، بالإضافة إلى أنها كانت تفتقر، غالبا، إلى الضوابط الاجتماعية التي ميزت البورجوازيات العريقة (..) وانفجرت ظاهرة اللهفة الاستهلاكية في مستوى طبقة طفيلية جديدة، أصبحت تلعب بالملايير، على مرأى من شرائح عريضة تعرق وتحصل بالكاد على ملاليم (..) وأصبح المثل الأعلى هو : هفّ تعيش (أو باللهجة المشرقية: بكّشْ تُرزق) ، وأصبحت الرجولة والشهامة والنزاهة أو كادت تكون كعملة أهل الكهف (..) وفقد التاريخ في الشرق عذريته، فهو يُكتب على المقياس″.
آنذاك كانت الأغنية المفضلة لدى بعض وسائل الإعلام المصرية اجترار الحديث عن تضحيات مصر في سبيل العرب، وهي صيحة حق أريدَ بها باطل.
فتضحيات الشعب المصري واقع لا يُنكره إلا جاحد، إلا أن الحروب التي خاضتها مصر كانت دفاعا عن مصر نفسها، وسواء تعلق الأمر بالمساهمة في الحروب الصليبية التي قادها الكردي صلاح الدين الأيوبي، أو في حروب المماليك بالشام والتي استشهد فيها السلطان قنصوه الغوري (وهو آخر سلاطين المماليك البرجية) ، لكن ليس هناك عربي واحد طالب يوما بالحرب حتى آخر جندي مصري، كما ردد البعض لاستثارة الشارع المصري ضد الانتماء العربي.
والواقع أن مزيج الشوفينيةوالبارانويا كان سلاح السلطة للسيطرة على الأوضاع في مصر، ولضمان الالتفاف حول السلطة، بمنطق أنه بقدر ما يتزايد شعور المصريين بالعزلة بقدر ما يتزايد التفافهم حول النظام، أيا كانت مساوئه.
لكن لا بد هنا من الاعتراف بفضل عدد من المثقفين المصريين الواعين، ومن بينهم هيكل نفسه، في رفض المزاعم القائلة بأن مصر أنهكتها الحروب دفاعا عن العرب.
وللتذكير، فإن حرب 1948 لم يطالب بها الفلسطينيون، بل ورفضتها القيادات السياسية المصرية والقيادات العسكرية المؤهلة، وكان أقصى ما طلبه المجاهدون تزويدهم بالأسلحة لمواجهة العصابات الإسرائيلية بحرب من نفس النوع، وهو ما أدركه الشهيد العظيم أحمد عبد العزيز، الذي قاد مجموعة من زملائه ضباط الجيش المصري، طلبوا عطلة خاصة “بدون مرتب”، وسافروا إلى فلسطين للقتال، إلى جانب أبناء فلسطين أنفسهم ومتطوعين من بلدان أخرى من بينها بلدان المغرب العربي، الذي سافر بعض أبنائه إلى المنطقة على الأقدام للمشاركة في قتال الصهاينة.
وقد كان المنطقي أن تعلن دولة فلسطينية في القدس إثر انتهاء الانتداب البريطاني في 15 مايو 1948، وإذا رؤي عدم الاصطدام مرحليا بالملك عبد الله تقام الدولة في قطاع غزة، ويتم الاعتراف بها أولا من قبل مصر لتليها الدول العربية والصديقة وليفرض وجودها دوليا، لتكون نقطة الانطلاق نحو استعادة ما ضاع، لكن ذلك لم يحدث، وأصبحت غزة مجرد قطاع يسيره حاكم عسكري، وتمت التضحية بها في 1956 ثم في 1967، ويتواصل الأمر بما يعرفه الجميع في الألفية الجديدة، ويكون حصار الشقيق أقسى من حصار العدو.
والواقع أن دخول الجيش المصري إلى فلسطين كان مبادرة تكاد تكون شخصية للملك فاروق، وبغض النظر عن حُسْن نواياه، والظن أنه خدع من قبل بعض نظرائه لأهدافربما كان من بينهاتصفية حسابات تاريخية مع أطراف أخرى، وهنا كان الدخول إلى فلسطين ساذجا، بحيث صدرت التعليمات إلى اللواء “المواوي بك” (كما يروي محمود رياض) يوم 14 مايو، أي قبل المعركة بيوم واحد، وبدون أن تكون لديه معلومات عن تسليح العدوّ وحجم قواته ونوع دفاعاته، وأرسِلَت، للتشجيع، قوات سعودية لم يكن لها، كما رُويَ، دور فاعل في القتال (أظن حوالي 500 نفر) وكاناللواء مقيدا بورود التعليمات مباشرة من القاهرة، ولأن الاتصالات السلكية واللاسلكية كانت على باب الله،اضطر إلى استخدام قواته بطريقة لا تمت إلى فن الحرب بصلة، ثم جاءت الهدنة، وتفاصيل ذلك كله أصبحت معروفة، والنتائج البائسة لا تتحمل الشعوب العربية مسؤوليتها بأي حال من الأحوال.
وكانعدوان1956 نتيجة لعملية التأميم الرائعة لقناة السويس،التي استرجع بها جمال عبدالناصر حق مصر التاريخي في القناة التي حفرها المصريون بأظافرهم وسقط فيها آلاف الشهداء، وبجانب رفع هامة التحدي للقوى الإمبريالية وإثبات تبعية البنك الدولي للإرادة الأمريكية، كان هدف الرئيس المصري استثمار دخل القناة في بناء مفخرة مصر المعاصرة، وهي “السد العالي”، وتضامن العرب آنذاك مع مصر لصد العدوان الثلاثي، كلٌّ حسب طاقته، وإلى درجة أن الطلبة الجزائريين في القاهرة، وكنتُ من بينهم، تطوعوا في الحرس الوطني، وبالطبع فقد كان ذلك تصرفا رمزيا لأن مصر لم تكن في حاجة لرجال.
وحقيقي أن أحد أطراف العدوان الثلاثي، وهو فرنسا، أرادأن يضرب عصفورين بحجر واحد، فينتقم من عبد الناصر ويصفي حسابه مع الثورة الجزائرية.
ووجدت فرنسا في التأميم الفرصة، ولكن العدوان أكدأن كفاح مصر والجزائر واحد، وهو ما فضحه الموقف الفرنسي باختيار سفاح الجزائر الجنرال “ماسو” للهجوم على بور سعيد، مما أعاد إلى الأذهان قصة معركة “نوارين” البحرية التي تضامن فيها الأسطول الجزائري مع الأسطول المصري في 1827، وأثبت للأشقاء في مصر أن هيكل على حق وهو يقول إن “حدود الأمن القومي تتجاوز الحدود الجغرافية للبلد المعني”، وهو ما أدركته القيادة الجزائرية دائما وعملت على ضوئه.
وكانت حرب 1967 نتيجة منطقية لسلسلة من الأخطاء السياسية والعسكرية التي ارتكبتها القيادة المصرية منفردة، وبدون تشاور مع أي طرف عربي، وقد قال لي الملك حسين شخصيا خلال زيارته للجزائر في بداية الثمانينات أنه حذر الرئيس عبد الناصر من غزو إسرائيلي مباغت، وقال الرئيس المصري ذلك في اجتماعه مع القوات الجوية في سيناء خلال شهر مايو 1967، لكن القيادات العسكرية لم تأخذ الأمر على محمل الجد، وراح البعض فيما بعد يلوم عبد الناصر لأنه رفض أي عمل هجومي على إسرائيل، انسجامامع ما أعلنه الجنرال شارل دوغول من وقوفه ضد المعتدي، وهو موقف بالغ الذكاء من ناصر، لو اقترن بقيام القيادات العسكرية بدورها في صد العدوان، وقبل ذلك قيام المخابرات بدوها في التعامل مع تحذير عبد الناصر وحسين والقيام باستكشاف جاد لنوايا العدوّ، وهو عجز مهنيّ جرت التغطية عليه فيما بعد بمسلسل رأفت الهجان، الذي شكك هيكل فيما نسب إليه من بطولات، فأفسد علينا فرحتنا به.
لكن الأمة العربية وقفت يومها بكل إمكانياتها مع مصر، وجسدت حجما من التضامن لم يحدث له مثيل في التاريخ إلا فيما بعد، خلال معركة أكتوبر، التي أجهض الرئيس السادات نتائجها العسكرية الرائعة، كما سبق القول وكما سيتأكد فيما بعد.
هذه صورة عامة اضطررت إلى استعراضها برقيا لأنني أحسست أن تجاهلها سيجعل كل حديث عما حدث في الألفية الثالثة كلمات لا تشرح وضعا ولا تحلل واقعا ولا ترسم طريقا للخروج من المستنقع الذي توجد فيه السياسة العربية.
وأعود إلى التسلسل التاريخي لأقول بأن سنة 1977 سجلت تطورا بالغ الخطورة في العلاقات المصرية مع الوطن العربي.
كان الشعب المصري ينتظر الكثير مما وُعد به إثر إجهاض نتائج حرب أكتوبر، التي أعلن الرئيس المصري أنها آخر الحروب، وهو خطأ سياسي بكل المقاييس، لأن مجرد معرفة العدو بأنك لست مستعدا لقتال جديد يجعله أكثر اطمئنانا، وبالتالي أكثر حرية في الحركة وأقدر على المساومة والمزايدة، وكان هذا ما تبين بعد رسالة السادات الشهيرة إلى كيسنجر يوم 7 أكتوبر، أي اليوم التالي لاندلاع الحرب، والتي أكد فيها، عبر حافظ إسماعيل، محدودية تحركه العسكري.
ويفاجأ الشعب المصري برفع أسعار المواد الاستهلاكية يوم 17 يناير 1977، وهناك ينفجر الشارع في الانتفاضة الشهيرة التي وقعت في اليومين التاليين، والتي أطلقت عليها الصحافة الدولية اسم “انتفاضة الخبز″، لأن خلفيتها كانت قرار حكومة السيد عبد العزيز حجازي برفع ثمنه.
والواقع أن الشارع المصري انفجر في 18 و 19 يناير 1977 احتجاجا على خيبة الأمل من النتائج الاقتصادية الاجتماعية الهزيلة بعد حرب أكتوبر، ويقول اللواء فؤاد علام، الوكيل الأسبقلجهاز مباحث أمن الدولة عنها في حديث له على صحيفة الأحرار المصرية في يناير 2010، ونقلته صحيفة القدس العربي، بأنه: “عاد من مأمورية خارج البلاد (..) فوجد متغيرات كثيرة حدثت في المجتمع (..) كان حُكمُ جمال عبد الناصر (..) حكما سادت فيه الاعتبارات الوطنية على كل فئاتالمجتمع، ومن هذا المنطلق كانت القرارات (..) تنبع منالوطنية والصالح العام(لكن) الوضع الحالي مخيف ولا يبشر بخير، وارتفاع الأسعار ليس وحدهالمحرك والسبب الرئيسي لقيام ثورة شعبية تشمل أنحاء مصر بالكامل، فهناك عدة أسبابأهمها التغييرات الواضحة في سلوكيات الإنسان المصري، الذي اتجهنحو العنف بشكل غير عادي في كل تصرفاته (..) ومن الممكن أن يؤدي إلى كارثة (لأن) التفاوت الطبقي ارتفعبشكل غير طبيعي في مصر، وبدت الهوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء، فهناك بضعة أفراد أصبحوا مليارديرات، مقابل أكثرمن 42 في المائة تحت خط الفقر، هذا بالإضافة إلى التفاوت الكبير فيالأجور، واستغلال الأغنياء للثروة بشكل سيئ يثير مشاعر الفقراء، فالأوتوبيسات مكدسة بشكل غير محتمل في الوقت الذي تمتلئ فيه شوارع القاهرة بالسياراتالفارهة التي يتعدى ثمنها الملايين، بالإضافة إلى ما يُنشر من أخبار الأغنياء الاستفزازية،فنقرأ عن حفلة عيد ميلاد تتكلف 2 و3 ملايين جنيه، في الوقت الذي يعيش فيه الكثيرونفي المقابر”.
كان هذا الاستعراض الذي قدمه رجل أمن مصريّ مرموق هو التحليل الصحيح لما أصبح يُسمّى انتفاضة الخبز، لكن السادات أسماها:”انتفاضة الحرامية” وقد كان يتصور، كما يؤكد هيكل، أن : “أكتوبر أعطاه شهر عسلٍ طويلا نسبيا، وإذا به يكتشف أن مصداقيته اهتزت وكرامته مُسّتْ، وبدا مُستقبله السياسي مهددا، حتى أن الشاه اتصل به هاتفيا يعرض عليه “اللجوء إلى طهران إذا أراد” (والرئيس المصري لا ينسى، فقد حرص على استضافة بهلوي عندما فرّ من بلاده إثر ثورة الخميني ورفضت بلدان العالم قبوله بما في ذلك حليفه الكبير، أمريكا، تماما كما تنبأ هواري بو مدين في رسالته يومها لفيديل كاسترو.)
وادعى السادات أن استضافة الشاه كانت تقديرا لموقفه، عندما زوّد مصر بالنفط خلال حرب أكتوبر، وهو ما يُكذبه هيكل، وتأكد أن كرمُ السادات كان في واقع الأمر ردّا على مكالمة محمد رضا بهلوي إثر أحداث يناير 1977، وربما تذكيرا له بها، ويمكن لمن أراد أن يُفسّر تصرف السادات كما يريد، وهل كان وفاء وتقديرا أم تشفيا وانتقاما.
وطلب رئيس الوزراء المصري آنذاك إنزال الجيش إلى الشارع للسيطرة على الأوضاع التي فشلت الشرطة في مواجهتها، لكن الفريق الغمسي، وهو واحد من أبطال أكتوبر الحقيقيين، رفض ذلك، ولعل هذا كان وراء التخلص منه بعد فترة لم تطل كثيرا.
ونصح الغمسي بإلغاء الزيادات التي طرأت على أسعار المواد الاستهلاكية أولا، وهو ما استجاب له الرئيس صاغرا، لكن اضطراره للموافقة أحدث جرحا كبيرا في كبريائه، جعله لا يتوقف عند السبب الحقيقي للمظاهرات بل يحاول أن يتخيل مدبرا لها، وهكذا، وكما يقول هيكل “بدلا من أن يتجه إلى تفسير اجتماعي لما حدث اختار أن يلجأ إلى تفسير بوليسي له”، وبداية، فكر في أن ينسب الأحداث لمؤامرة سوفيتية، ولكنه لم يجد دليلا مقنعا على ذلك، لكنه سيجد طريقا آخرا للمحاولة، وهو طريق الغرب.
د محي الدين عميمور
http://www.raialyoum.com/?p=335803