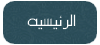لا تبدو سوريا اليوم أكثر قربا من سيناريو «حافة الهاوية». فهي، بسلّتها الكاملة من حرب أهلية و «ثورة» و «إرهاب» وانقسام سياسي ومجتمعي، غير مستعدة ربما لتجريب الاحتمالات النهائية صاحبة المردود الحاسم، وكأن الداخل أو «الفاعل» الداخلي ارتضى قدرا معينا من الرتابة في القتال ومفاعيله. كما لا تبدو العناصر «الخارجية» أيضا أكثر استعدادا لإنزال أثقال جديدة في الساحة تفضي الى تغيير درامي، برغم استشعار الروس بحدوث تغيّر في الوجهة النهائية «المرغوبة» للحرب السورية بعد الاتفاق النووي الإيراني - الغربي، وما يفرضه الامر من ضرورة تثبيت موقع موسكو لمقعدها على طاولة الحل النهائي. لكن بين هذا وذاك، الواضح الوحيد أن المسار التصاعدي للأعمال الحربية لن يتغير نزولا في المدى القريب، خاصة أن حلفاء النظام وخصومه يظهرون انكبابا واضحا على عملية واسعة لإعادة هيكلة شاملة في المنظومة العسكرية المقاتلة وفي مختلف الخنادق.
الاهتمام الدولي الزائد بمجريات الايام الماضية كان دليلا على وجود «تحسس» لدى الغربيين تحديدا من كل ما هو قادر على إعادة فرز الأوزان العسكرية في سوريا. فالروس في المنطقة العربية أظهروا للمرة الاولى منذ تفكك الاتحاد السوفياتي في كانون الاول 1991 وحتى الى ما قبل ذلك التاريخ، رغبة بالنزول الى الميدان، وبما تفرضه الوقائع على الأرض من عدة وعتاد و «اندفاع». فموسكو اختبرت دمشق لعقود عدة، وهي تعلم ان أي حل نهائي للأزمة، لن يكون على حساب مصالحها الاقليمية، كما حصل مع انخراط قيادة السادات في التسويق لمرحلة ما بعد اتفاق «كامب ديفيد» العام 1978. وفي النسخة الجديدة لـ «اختبارات التحمل» في العلاقة القديمة بين الروس والسوريين، أثبتت الاعوام الاربعة والنصف الماضية، ان نظام الأسد الابن، لا يقل حماسة أو تبنيا لما أمكن من مصالح الكرملين في بلاده وفي الجوار.
لا ارتباك في العلاقة بين سوريا وحلفائها الروس، ولا اضطرابات صعودية ونزولية مبنية على تناقض المصالح. فالسوريون تعلموا الكثير واستطاعوا تكوين صيغة خاصة للعمل مع الروس انطلاقا من تجربتهم الخاصة وكذلك من الارث المرتبك للعلاقة بين مصر والاتحاد السوفياتي منذ عهد الراحل جمال عبد الناصر، مرورا بلقاء مستشار الأمن القومي المصري في عهد السادات حافظ إسماعيل مع الزعيم السوفياتي ليونيد بريجينيف وما تخلل الامر من تحضير لحرب تشرين 1973، وصولا الى احتواء الغرب لمصر حسني مبارك. لهذا تحاول دمشق دوماً الركض أمام الروس لا خلفهم، وبالتالي فإن الديبلوماسية السورية عكفت دوماً على السير بالتوازي مع الادبيات الروسية في المحافل الدولية. وغالبا ما كانت دمشق تظهر اندفاعا «مبالغا فيه» لدى العمل مع الروس كما حصل في اجتماعات جنيف الماضية.
وبما ان النتائج المرحلية للمعركة باتت شديدة الوضوح امام منظومة المصالح الروسية، وكذلك الاحتمالات السوداء لما بعد السقوط المدوي للنظام في دمشق، اذا ما حصل الامر، فقد باتت موسكو أمام عدد محدود من الخيارات، يقوم اولها على الاستمرار بالدعم «الجاري» للجيش السوري ومثله الدعم السياسي للحكومة، وما يعنيه الامر من استمرار التآكل اليومي في آلة الحرب النظامية بكامل تكوينها البشري والتجهيزي والتذخيري، وما يعنيه الامر من خسارات إضافية للنظام في حربه مع الجماعات المسلحة وعلى رأسها تنظيم «الدولة»، نظرا للتطوير الدائم في العمل وأدواته، الذي تخضع له غالبية الميليشيات المناوئة للحكومة المركزية في سوريا.
الخيار الروسي الثاني تمثل بالانخراط المباشر في المعارك، باستنساخ «ممانع» للتجربة السعودية الحيّة في اليمن، مع فارق القوة والتأثير بين الساحتين والمنخرطين والمتقاتلين فيهما. وهذا يفرض تعبئة موسكو لمئة الف وربما أكثر من قواتها مع مئات المدرعات والطائرات، وما يعنيه الامر من أعباء مادية وسياسية وديبلوماسية قياسية، وكذلك حتمية تصاعد قدرة الاستقطاب لدى التنظيمات الإرهابية الناشطة في سوريا في وجه ورثة الجيش الأحمر «الأصيل» بتهمة الكفر مقارنة مع الجيش السوري، إضافة لاحتمال تحول الامر الى توتر «استراتيجي» يستجلب ردودا اميركية لا تقل وزنا عن خطى الروس. هكذا، بدا الخيار الوسطي الاكثر منطقية في العقل الروسي، وهو الخيار المعتمد على مبدأ تقليدي وأساسي، والمتمثل في إعادة هيكلة المنظومة العسكرية السورية من سرايا من المشاة وصولا الى قيادة الفرق، إضافة لبدء عملية تحديث واسعة في الترسانة التقليدية السورية من مدرعات ومروحيات ومنظومات متطورة للدفاع الجوي.
من مدرسة التعبئة إلى مدرسة التفوق الكمي والنوعي، هكذا تبدو مرحلة التبدل المقبلة في الميدان السوري. فالإيرانيون أخذوا وقتهم على ما يبدو، من وجهة النظر الروسية، في عملية تدعيم النظام السوري وقواته المسلحة بأسباب «الصمود» في وجه أعدائهم وكذلك التحضير الدائم للمقبل من خيارات مجنونة قادمة من خلف الحدود القريبة. فالعمل الايراني كان يعتمد على تسلسل جاء كردود فعل متراكمة طبقا لتغيّرات الميدان، حيث كانت البداية في تقديم الدعم الأمني والاستخباري، ثم الدعم عبر طرف ثالث، من خلال انخراط «حزب الله» اللبناني وتنظيمات عراقية كـ «عصائب أهل الحق» و «لواء ابو الفضل العباس» وكتائب من «جيش المهدي» السابق، وصولا الى الدعم المباشر من خلال خبراء في إنشاء وتدريب وقيادة التنظيمات المدنية المسلحة، كـ «اللجان الشعبية» والحشد الرديف للجيش النظامي.
تحاول روسيا اليوم العمل في الميدان السوري ارتكازا على ألف باء الحروب، حيث كثافة النيران والتفوق العددي والنوعي، كلها عوامل تضمن انتصار «النظاميين» أو صمودهم. وبالتالي فإن إنشاء مركز قيادة مشترك للتحكم والسيطرة في اللاذقية من ضمنه غرفة موحدة لإدارة الحرب الجوية، وتزويد الجيش السوري بدبابات حديثة قد لا تكون «تي 90» من بينها، وكذلك اعادة ترميم سلاح الجو السوري، اضافة لحديث القيادة العسكرية السورية عن دورات مكثفة يجريها خبراء روس لألوية مقاتلة جديدة بالكامل، كلها عناوين تؤشر الى قرب انطلاق عملية كاملة لإعادة تنظيم وهيكلة القوات السورية المسلحة، بما يضمن لها تفوقا في صراعها المحلي، وقدرة اكثر على المناورة في وجه التهديدات القادمة من خلف الحدود وفي مقدمها المنطقة العازلة بنسختيها الشمالية والجنوبية.
قد تحجب أجنحة «الانتونوف 124» وهي تهبط في مدرج حميميم في ريف اللاذقية عملا يجري منذ سنوات على مقربة من القاعدة الروسية قيد الانشاء، لكنه حجب نفسي ومؤقت بانتظار نتائجه وسردياته المقبلة. فالإيرانيون، بمعزل عن الدعم السياسي والمالي المباشر، ومن خلال جسرهم الجوي الممتد من طهران الى عاصمة الساحل السوري، تمكنوا من تحقيق توازن مقبول في السنتين الماضيتين في مقابل التوسع الهائل في الرقعة التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة في سوريا. فعملية تذخير الجيش السوري التي تعتمد بالاساس على آلة التصنيع الحربي المحلي، يضاف اليها تحضير عشرات الاف المقاتلين ضمن الميليشيات غير النظامية التي توالي دمشق، وكذلك المجهود الحربي القياسي لـ «حزب الله» اللبناني في عدد من المناطق السورية، كلها كانت تجليات للرؤية الاستراتيجية وكذلك التكتيكية لخبراء قيادة الحروب في ايران، والتي ترتكز في الاساس على مفهوم الحرب الشعبية.
روسيا أنزلت في اللاذقية طلائع جيشها صاحب «المهمة السورية الغامضة»، بينما نزل الإيرانيون قبل ذلك بكثير، ومع فارق واضح في التفكير والتطبيق، تبدو النسخة الجديدة من ادارة المعركة، أكثر تشويقا، وهي تقوم ربما على تنسيق مرحلي في عمل حلفاء دمشق في الميدان. فالايراني يتابع عمله القائم على تطويع الاف الشبان الجدد في «الحشد الشعبي» السوري و «الدفاع الشعبي»، وهي قوات تعتمد في أدبيات استقطابها على عناوين تفضي في نهاية المسار الى جسم راديكالي حتمي في بعديه العسكري والعقائدي، حيث ان العمل على حماية الاقليات بقدراتها الذاتية، وبمعزل عن غاياته واسبابه، يؤسس لمنتج نهائي طائفي بامتياز انما بنكهة «اقلويّة». وهنا تبدو اليد الروسية أكثر قدرة على تقديم مقاربة مختلفة تقوم على مبدأ اعادة احياء القوات النظامية السورية، على شاكلة تذوب معها التشكيلات العسكرية غير النظامية في بدن «نظامي واحد»، وهذا النموذج يكفل الى حد بعيد تبريد جزء من الاحتقان المجتمعي، المرتكز على نمطيّة في تصنيف المتقاتلين طبقا للدين والطائفة.

--------
الكاتب : عبد الله زغيب