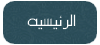هزيمة المعارضة في حلب ستضعها أمام طريق مسدود، وستكون فرصها شبه معدومة لعكس مسار الحرب.
----------
وقعت أحياء كاملة من شرق مدينة حلب في قبضة الحكومة السورية خلال الأسبوع الفائت بعد أن كانت خاضعة إلى سيطرة المعارضة. وقد أحرزت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد هذا التقدّم بوتيرة سريعة فاقت جميع التوقعات.
وفيما تضعف قبضة الثوار على شرق حلب، لا بدّ من أن النظام السوري يشعر بأن كفة الانتصار تميل لصالحه. لقد تكلّلت استراتيجيته القائمة على شنّ هجمات عنيفة ومتواصلة بالنجاح. فمن دون حلب، لن تتمكّن المعارضة السورية وداعموها الخارجيون، عملياً، من المضيّ قدماً في الحرب ضدّ نظام بات محصّناً في وسط البلاد أكثر من أي وقتٍ خلال السنوات الخمس الماضية.
في خضم انعدام اليقين السائد مع اقتراب انطلاق ولاية الرئيس الأميركي الجديد، الذي تساوره شكوك بشأن المعارضة السورية، وأيضاً مع استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياسته حول سورية، يُرجّح أن تُبدّل التطورات الأخيرة في حلب موازين الصراع السوري الدائر.
التقدُّم في حلب
بدءاً من 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تهاوت دفاعات القسم الشرقي من مدينة حلب الذي يسيطر عليه الثوار، ما سمح لقوات النظام بإطلاق عملية عسكرية سعياً إلى فصل حلب الشرقية (معقل المعارضة في حلب) إلى قسمين. وخوفًا من أن يحاصرها النظام، فرّت قوات المعارضة التي كانت متواجدة في القسم الشمالي من حلب الشرقية إلى القسم الجنوبي منها، فيما تبعثر المدنيون في شتّى الاتجاهات، منهم من ذهب إلى عمق القسم الشرقي من المدينة الذي يسيطر عليه المسلحون، ومنهم من اتجه نحو غرب حلب الذي تسيطر عليه القوات الحكومية. سمحت الفوضى الناجمة عن ذلك للنظام بتحقيق مزيدٍ من المكاسب. ومع تقدّم قوات النظام أيضاً داخل حي الشيخ سعيد الجنوبي، بالتزامن مع القصف الجوي على المدينة، باتت تضيّق الخناق على المعارضة من المحاور كافة تقريباً.
لاتزال أسباب هذا الانهيار المفاجئ للمعارضة غامضة. وقد تُعزى، كما يتكهّن البعض، إلى خيانات وصفقات أُبرمت في الكواليس، أو إلى تململ الثوار عقب الاقتتال الداخلي الذي نشب بينهم في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت. لكن السبب الحقيقي قد يكون بصريح العبارة أن الثوار، الذين استُنزفت مواردهم بعد حصار دام ستة أشهر، لم يتمكّنوا من الصمود في وجه قوى أعتى منهم بكثير.
لكن القتال في منطقة مثل حلب شاقٌّ للغاية، وبالتالي لايزال من الممكن وقف العملية العسكرية التي أطلقها النظام. إذ يُذكَر أن المفاوضات التي تجريها روسيا مع كلٍّ من الولايات المتحدة والثوار السوريين حول اتفاق هدنة تسير على قدم وساق، وقد تكون بديلاً لتحقيق الجيش السوري انتصاراً كاملاً، لكن من المُستبعد أن يؤيّد الأسد هذا الطرح. وقد يتطلّب الوضع إطلاق جولة أو جولتين من المعارك، قد تستمرّ أياماً أو أسابيع أو أشهر عدّة، ريثما تواصل القوات الموالية للأسد إحكام سيطرتها الكاملة على المدينة مع حلول شهر كانون الثاني/يناير. بغضّ النظر عن المهلة الزمنية التي سيقتضيها ذلك، يبدو أن الحصيلة النهائية التي لا مفرّ منها هي أن الأسد سيستعيد القسم الشرقي من حلب.
سيُلحق هذا الأمر، في حال تحقّق، هزيمة نكراء بالمعارضة السورية، سيترتّب عليها تداعيات سياسية خطيرة. ومع أن الكثير من المعارضين تعهّدوا بمواصلة القتال، يُرجّح البعض الآخر أن احتمالات إلحاق الهزيمة بالأسد ستكون معدومة، بعد خسارة حلب وتسلّم دونالد ترامب مقاليد الرئاسة في الولايات المتحدة.
غايات أخرى في نفس أردوغان
الهزيمة التي قد تُمنى بها المعارضة السورية في حلب ستوقعها في مأزق، ليس فقط بسبب فقدان أكبر مساحة من الأراضي الخاضعة إلى سيطرتها، بل أيضاً لأن سائر معاقل الثوار غير قادرة على قلب مسار الحرب.
المنطقة الأبرز هي تلك التي تمكّن الثوار من السيطرة عليها بفضل العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي شمال شرق حلب خلال المعارك ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية. هنا، شكّل احتمال الحصول على دعم عسكري من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يكنّ عداوة شديدة للرئيس الأسد، بارقة أمل للثوار بفكّ الحصار عن حلب. لكن هذا الأمر مستبعد لأسباب ثلاثة.
أولاً، كان هدف التدخل العسكري التركي تطهير المنطقة من جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية وضمان ألا تقوم القوات الكردية المُرتبطة بحزب العمال الكردستاني، بملء هذا الفراغ. ومهما بلغت كراهية أردوغان للأسد، إلا أنها لا توازي الكره الذي يضمره لحزب العمال الكردستاني. فلو كان الشغل الشاغل لأردوغان يتمثل في إطاحة الرئيس السوري، لما أرسل آلاف الثوار السوريين لمساعدة الأسد على تطهير المنطقة الحدودية، فيما كانت جبهة حلب في أمسّ الحاجة إليهم.
ثانياً، استند التدخّل التركي على تفاهم مع روسيا المُلتزمة بحماية الأسد. ولا يزال من غير الواضح كيف يخطّط كلٌّ من أنقرة وموسكو لتقاسم المنطقة الحدودية، وقد تُطرح لاحقاً على بساط البحث والنقاش، وقد تحدث صدامات بين القوات التي تحظى بدعم تركيا وروسيا (وربما حتى بعض المناوشات بين الجنود الروس والأتراك). لكن المعروف أن كلّاً من روسيا وتركيا لا تريدان نشوب صراع كبير بينهما، بعد أن أمضَتا وقتاً طويلاً تحاولان توطيد أواصر علاقتهما، وأيضاً لأن عضوية تركيا في حلف الناتو تزيد إلى حدّ كبير مخاطر أي مواجهة قد تطرأ.
ثالثاً، لو كان أردوغان ينوي فكّ الحصار عن حلب، لكان فعل ذلك منذ فترة طويلة. فلا جدوى من الانتظار ريثما يدمّر الأسد معقل الثوار الذي يُفترض أن أردوغان يريد إنقاذه.
بعد أن التزم أردوغان الصمت لمدّة طويلة كانت مُترَحة بالدلالات، ألقى مؤخّراً كلمة تطرّق فيها إلى الوضع في حلب، قائلاً: "دخلنا سورية ]في آب/أغسطس الماضي[ لإنهاء حكم الطاغية الأسد". ومن غير المُستغرب أن هذا التصريح قوبِل فوراً بردٍّ روسي، إذ أعلن المتحدّث باسم الكرملين أن روسيا بانتظار توضيحات من تركيا.
وسيحاول أردوغان على الأرجح أن يحفظ ما تبقّى من ماء الوجه.
إن لم تكن النوايا التركية في شمال شرق حلب كما كانت تأمل المعارضة، فانخراط أنقرة في إدلب كان حتى الآن متماشياً بشكل أوضح مع قضية الثوار. فالمنطقة، التي سقطت بالكامل في يد الثوار السوريين في ربيع العام 2015، ما زالت تحظى بدعم قوي من وراء الحدود التركية، وتُعتبر مركز تخطيط لشنّ هجمات في حلب وحماه واللاذقية.
إن الثورة في إدلب قوية وراسخة بشكل كبير، إلى درجة أنها تشكّل تهديداً حقيقياً للأسد. لكن على الرغم من أنها تضمّ العديد من المجموعات المتنوعة، يتولى السيطرة عليها من الناحية الاستراتيجية إسلاميون متشدّدون على غرار حركة أحرار الشام وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تضمّ العديد من الجهاديين الأجانب. وتُعتبر هذه المجموعات من ألدّ أعداء النظام، إلا أنها خطرة جدّاً وبالتالي لم تتمكّن من كسب تأييد الغرب. أما صنّاع القرار في الدوحة وأنقرة فبدَوْا أكثر تقبّلاً للجهاد من نظرائهم في واشنطن، لكن جبهة فتح الشام تخطّت في نهاية المطاف حاجز المقبول لدى الجميع.
وبعبارة أخرى، في حين أن إدلب ستبقى شوكة في خاصرة الأسد، من المستبعد أن تشكّل نقطة انطلاق لاعتماد استراتيجية مدعومة من الخارج تهدف إلى إنهاء حكم الأسد.
صمتٌ مدوٍّ على الجبهة الجنوبية
يعتمد التمرد في جنوب سورية على مجموعات منضوية تحت لواء تحالف الجبهة الجنوبية، الذي يحظى بقبول أكبر من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، ويخضع إلى مراقبة شديدة من مركز العمليات العسكرية المدعوم من الولايات المتحدة ومقرّه الأردن. وتجدر الإشارة إلى أن استعداد هذه المجموعات للعب وفق القواعد التي يفرضها الخارج هو ما جعلها شريكاً جذاباً.
لكن الاضطلاع بدور قوة بالوكالة له سلبياته. فحركة التمرد في جنوب البلاد كانت متوقفة إلى حدّ ما خلال العام الماضي. إذ انحسرت المعارك بعدما تفاوضت روسيا حول شروط اتفاق ما مع الأردن نيابةً عن بشار الأسد، أيّده رعاة المعارضة الذين كانوا يخشون انتقال الفوضى إلى الأردن ولبنان. وبعد أن ربطوا مصيرهم بالتمويل الأجنبي، لم يعد أمام ثوار الجبهة الجنوبية العديد من البدائل.
كما أنه من الممكن، بالطبع، أن يوافق مركز العمليات العسكرية والأردن على إعادة إحياء الثورة في الجنوب للتعويض عن خسارة حلب. لكن حتى لو حدث ذلك، من الصعب تخيّل أن توافق الأطراف الخارجية الداعمة للمعارضة (نظراً إلى سلوكها الخجول حتى الآن والأهمية التي توليها إلى استقرار الأردن ولبنان) على شنّ هذه الأخيرة هجمات من شأنها أن تشكّل خطراً جديّاً على سيطرة بشار الأسد على دمشق. وإذا لم يكن السبب كذلك، فما الهدف؟
في الواقع، أحرز النظام تقدّماً ملحوظاً في ريف دمشق خلال العام 2016، ويسعى راهناً إلى تطهير جيوب الثوار في هذه المناطق. وأعقب سقوط داريا في آب/أغسطس ضغوط للاستسلام في الضواحي الأخرى والبلدات النائية. وقد بدأ الثوار في بلدة خان الشيح غرب دمشق بالخروج نحو إدلب، ومن المرجّح أن يحصل الأمر نفسه في مدينة التل شمال دمشق.
تشكّل الغوطة الشرقية شرق دمشق أبرز المعاقل المتبقية للثوار، لكنها في وضع يرثى له. فخلال الربيع الفائت، أصبحت هذه المنطقة المحاصَرة مسرحاً لعمليات اقتتال عنيفة أدّت إلى تقسيمها. استهدف النظام السوري حتى الآن مجموعة سلفية تُعرف باسم جيش الإسلام، واستولى على أراضٍ واسعة في إطار ما يبدو أنه استراتيجية فَرِّق تَسُدْ. قال لي أحد الناشطين المحليين ويُدعى علاء خلال محادثة عبر سكايب إن "النظام السوري نظام شرير"، مضيفاً: "هم يحاولون باستمرار إحداث الاضطرابات. وأحياناً يهجمون على جبهات محدّدة، ويحجمون عن التعرّض لجبهات أخرى".
ويعمد الجيش الآن إلى تضييق الخناق على مدينة دوما التي يسيطر عليها جيش الإسلام للتفاوض على وقف إطلاق النار، كخطوة أولى نحو إرخاء قبضة الثوار على الغوطة الشرقية. ووفقاً لمصدر موالٍ للحكومة في دمشق، بدأت محادثات الهدنة للتوّ أيضاً مع مجموعة أخرى من الثوار في حرستا المجاورة. ويُعدّ هذا المعقل أكبر من حلب الشرقية من حيث المساحة وعدد السكان، وقد يصمد لبعض الوقت، لكن من الصعب تخيُّل أن يتمكن الثوار من قلب المعادلة في وجه زحف النظام.
آفاق قاتمة للمعارضة
سيكون من الساذج محاولة توقّع مجرى الأحداث. فعادةً ما تؤدي الفوضى في سورية إلى تقويض أفضل الخطط المرسومة. وربما سيدعم رجب طيب أردوغان، الذي لا يمكن التنبؤ بخطواته المقبلة على الإطلاق، هجوماً يشنّه الثوار في حلب في نهاية الأمر.
لكن إذا نظرنا إلى المعطيات الحالية، تبدو الأمور سيئة للغاية بالنسبة إلى المعارضة. فمع احتواء الوضع في حلب الشرقية والغوطة الشرقية وتوافر إمكانية التوصّل إلى تسوية تصبّ شروطها في صالح الحكومة، يبدو الأسد في طريقه نحو بسط سيطرته على المناطق المحورية في سورية. وإذا ما بقيت المعارضة عاجزة عن شنّ هجوم مضاد فعّال، قد يقرّر الأسد عندئذٍ التفاوض أو مواصلة القتال للسيطرة على مناطق جديدة، بعضها واقعٌ راهناً في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.
وبطبيعة الحال، يتوقف الكثير على قدرات النظام الذي يُعاني من نقاط ضعف حقيقية: فقد استُنزف من الناحية الاقتصادية، كما أنه يفتقر إلى المقاتلين. وأدّى فشله في التوصّل إلى تسويات بناءة أو إظهار انفتاح سياسي تجاه معارضين أبدوا استعداداً لتغيير موقفهم، إلى مفاقمة عزلته. لكن هكذا هي الحرب، وعاجلاً أم آجلاً ستُترجم مكاسب الأسد العسكرية على الأرض إلى مكاسب سياسية.