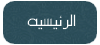هذه المقاربة الإقليمية المعمَّقة أُعِدَّت كجزءٍ من مشروع "إعادة النظر في العلاقات المدنية-العسكرية 2014-2015: الحوكمة السياسية والاقتصادية في المرحلة الانتقالية" الذي وضعه مركز كارنيغي للشرق الأوسط، والذي يسعى إلى ترقية البحث حول القوات المسلحة في الدول العربية وتحديات مرحلة الانتقال الديمقراطي.
كوّن الفرار من الجيش ديناميكيات الصراع السوري إلى حدٍّ كبير. وفي حين ساهم الهروب في ظهور التمرّد المسلّح منذ أوائل خريف العام 2011، إلا أنه فشل في إضعاف جيش النظام السوري بصورة حاسمة. ولذا فإن الأطراف الدولية الفاعلة في حاجةٍ إلى فهمٍ أفضل لدوافع الهروب والولاء في الجيش السوري، بغية وضع سياسات فعّالة لإضعاف النظام من دون تقوية الجماعات المتمرّدة المتطرّفة.
الاقتصاد السياسي للفرار من الجيش وتجنيد المتمرّدين
- لم تؤدّ عمليات العصيان العسكرية الضخمة إلى تفكّك الجيش السوري. وأصبح الهروب من الجيش، مع مايترتّب عليه من رفض التواجد لأداء الخدمة، ظاهرة متفشّية بين الجنود وضباط الصف والضباط من ذوي الرتب الدنيا في العام 2012. وفي الوقت نفسه، يترتّب على عمليات الانشقاق التخلّي عن الجيش والانضمام إلى المعارضة بصورة رسمية، وهي أقلّ شيوعاً. لكن لاحالات الفرار ولا الانشقاقات، أضعفت الجيش أو تسلسل قيادته إلى حدّ كبير.
- سعى النظام إلى ردع حالات الهروب من الجيش، من خلال تعزيز آليات الرقابة، بما في ذلك الترويج لسرديّة طائفية تعزّز انعدام الثقة المتبادل في المؤسسة العسكرية. وفي حين أدّت الطائفية إلى انعدام الثقة وعرقلت التنسيق بين الضباط الساخطين (وإلى درجة أكبر بين الجنود والضباط)، إلا أنها لم تكن الدافع الرئيس لعمليات الهروب. وهذا مايفسّر، جزئياً على الأقل، عدم وجود حالات تمرّد جماعي وتفشّي حالات الهروب الفردية.
- في الوقت الذي تمّ فيه تشديد الرقابة في الجيش، حاول النظام تشجيع الولاء من خلال زيادة الحوافز المادية. وهكذا، زادت رواتب العسكريين مرّات عدّة، على الرغم من أن مثل هذه الزيادة فشلت في مواكبة التضخّم.
- تفشّى الفساد في الجيش، وأدّى ذلك إلى توفّر فرص الثراء، خصوصاً بالنسبة إلى الضباط، وبالتالي توفّر حافز اقتصادي هام للولاء. ومع ذلك، وفّر الفساد أيضاً فرصاً للجنود كي يفرّوا، لأنه كان بإمكانهم شراء الإجازات أو الانتقال إلى مناطق يُسهل فيها الهروب.
- تتأثّر عمليات تجنيد المتمردين بشدّة بالعوامل الاقتصادية. وغالباً ماتدفع الضرورات الاقتصادية الفارّين من الجيش إلى الانضمام إلى حركة التمرّد إلى جانب الميليشيات الجهادية المتطرّفة ذات التمويل الجيد. وقد ساهم التنافس على الموارد الاقتصادية في تفتيت المتمرّدين، وبالتالي إلى نشوب صراع مستعصٍ على نحو متزايد.
خيارات السياسات بالنسبة إلى الأطراف الدولية
تشجيع الفرار من الجيش وليس تجنيد المتمرّدين. إضافةً إلى توفير المساعدة للتمرّد المسلح، ينبغي على داعمي المعارضة الغربيين تشجيع الانشقاقات، ولاسيما في صفوف المجموعة الهامّة من الضباط من ذوي الرتب المتوسطة، من خلال زيادة المساعدة المالية المستهدفة.
توفير بدائل اقتصادية للانضمام إلى الجماعات المسلّحة. تحسين الظروف الاقتصادية لمجتمعات اللاجئين السوريين الكبيرة في الدول المجاورة قد لايعمل باتجاه حلّ أزمة اللاجئين وحسب، بل أيضاً الحرب الأهلية السورية، في المدى المتوسط. كما أن توفير بدائل اقتصادية للانضمام إلى الجماعات المسلّحة سيشجّع المتهرّبين من أداء الخدمة على الامتناع عن القتال. وإذا مابقي الهروب من أداء الخدمة خياراً جذاباً، ولم يكن القتال كذلك، فقد يتعرّض الموالون للرئيس السوري بشار الأسد والمتمرّدون إلى ضغوط لقبول حلّ عن طريق التفاوض.
مقدمة
ساهم الفرار من الجيش في انتقال الوضع في سورية من انتفاضة سلمية إلى حرب أهلية واسعة النطاق. وقد لجأ النظام إلى إعدام الجنود الذين تهرّبوا من تنفيذ أوامر قمع المظاهرات في أوائل نيسان/أبريل 2011.
غير أن الفرار يختلف عن الانشقاق. ذلك أن الانشقاق يستتبع التخلّي عن الجيش والانضمام إلى المعارضة بصورة رسمية. ومنذ صيف العام 2011، ساعدت حالات الانشقاق الجنود وضباط الصف والضباط من ذوي الرتب الدنيا والمتوسطة المعارضة في تأسيس وحدات دفاعية أجّجت التمرّد المحلي ضد قمع الدولة. وقد حسّنت خبرتهم العسكرية القدرات القتالية لهذه الميليشيات الصغيرة. وبحلول حزيران/يونيو 2012، أخذوا زمام المبادرة في تأسيس الجيش السوري الحر وهو الجناح العسكري للمعارضة الذي تعهّد بقيادة المراحل الأولى للتمرّد.
تشير التقديرات إلى أن مايصل إلى 100 ألف جندي فرّوا من الجيش السوري حتى تموز/يوليو 2014. ولايشمل هذا الرقم المجنّدين الذين رفضوا الالتحاق بالخدمة العسكرية عندما تمّ استدعاؤهم للمرة الأولى. وخلال سنوات ثلاث، أدّت حالات الفرار من الجيش وسقوط ضحايا في العمليات القتالية إلى خفض عدد العسكريين العاملين من 295 ألفاً في ربيع العام 2011 إلى 120 ألفاً في ربيع العام 2014. وكان نقص القوى العاملة في جيش النظام كبيراً جداً إلى درجة أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر عفواً عن الفارّين من الجيش يوم 25 تموز/يوليو 2015، في محاولة واضحة لتشجيعهم على استئناف خدمتهم. لكن، على الرغم من العديد من التنبؤات التي تشي بعكس ذلك، فإن الجيش السوري لم يتفتّت بعد.
المقابلات التي أجريناها مع مايقرب من 90 عسكرياً سابقاً خلال عامَي 2014 و2015، وفّرت لنا فهماً عميقاً للدوافع والحوافز المادية للفرار والولاء في القوات المسلحة السورية. ولعل مايؤكّد التقارير التي تشير إلى أن معظم الفارّين هم من العرب السنّة، هو أن واحداً فقط من الفارّين ممن قابلناهم كان درزياً. ووصف الجميع أنفسهم، باستثناء جندي كردي واحد، بأنهم من أصل عربي. وقد فرّ معظمهم بين أواخر العام 2011 وأوائل العام 2013.
من الضروري فهم الاقتصاد السياسي لحالات الفرار من الجيش في الأزمة السورية، وذلك لوضع سياسات فعّالة تهدف إلى إضعاف جيش النظام من دون تقوية الميليشيات الجهادية المتطرّفة.
فرار الجنود وانشقاقات الضبّاط في سورية
استخدم معظم الفارّين الذين قابلناهم، على غرار الجنود السابقين الذين أعلنوا عن قرارهم بالتخلّي عن الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي، مصطلح "انشقاق" لوصف قرارهم. ومع ذلك فإن ترجمة هذا المصطلح على أنه "انشقاق" يشوّه المعنى الفعلي. وكما لاحظ أحد الذين شاركوا في الإجابة على أسئلتنا:
"في الواقع لم تكن محاولتي الأولى انشقاقاً، إذ تركتُ الجيش خلال فترة الإجازة. وكلمة انشقاق ليست الوصف المناسب لذلك، فأنا تركت الجيش. وقد تسبّب ذلك بمشاكل لي ولعائلتي. واجهتُ العديد من المشاكل، خاصة مع والدتي وإخوتي. وقد طلبوا مني أن أعود إلى الجيش بسبب ذلك".
كما توضح هذه القصة، فإن الفرار يعني ترك الجيش من دون إذن، قبل نهاية الخدمة العسكرية للشخص المعني. أما الانشقاق فهو ينطوي على قضية سياسية ترتبط بتخلّي المرء عن وحدته العسكرية.
نستخدم مصطلح "انشقاق" في سياقَين محدّدَين. الحالة الأولى هي عندما نفترض أن الخدمة العسكرية لم تكن مجرّد وظيفة، بل تشمل أيضاً التزاماً أعمق بالنظام السياسي، مثلما هو الحال بالنسبة إلى كبار الضباط. ثانياً، لاينشقّ العسكريون عندما يتركون الخدمة العسكرية وحسب، بل أيضاً عندما ينقلبون على النظام ويقاتلون في صفوف المعارضة.
في سياق الصراع السوري، حدثت انشقاقات ذات دوافع سياسية أساساً بين الضباط. وبين حزيران/يونيو 2011 وآذار/مارس 2013، أعلن ما لايقل عن 70 من كبار الضباط في الجيش وأجهزة الأمن انشقاقهم، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أولاً. مايقرب من نصف هؤلاء الضباط من ذوي الرتب العالية كانوا برتبة عقيد، وكان الكثير منهم شغل وظائف في فروع البنية التحتية والخدمات اللوجستية للجيش والأجهزة الأمنية. ولأن معظم هؤلاء الضباط لم يشاركوا في أنشطة قتالية، فقد كان تأثير هذه الانشقاقات محدوداً على تماسك الجيش وأجهزة الأمن وقدراتهما القتالية.
من بين هؤلاء الـ70 عسكرياً منشقاً، حوالى 30 منهم من كبار الضباط. ومن الأمثلة البارزة العميد محمد يحيى بيطار، الذي انضم إلى الجيش السوري الحر في الأول من نيسان/أبريل 2012؛ والعميد عبد المجيد عشتار، الذي كان قائداً سابقاً في المنطقة العسكرية الوسطى وانشقّ عن الجيش في 7 تموز/يوليو 2012؛ واللواء عدنان نورس سلو، الذي أصبح شخصية مهمة في المعارضة.
ثمّة عدد محدود من الانشقاقات التي حظيت بالاهتمام بسبب طبيعتها الرمزية وليس لأي سبب آخر. وتمثّلت إحدى هذه الضربات الرمزية للمؤسّسة العسكرية والأمنية للنظام في انشقاق مناف طلاس، وهو عميد في الحرس الجمهوري للنظام وابن وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس، في أوائل تموز/يوليو2011، إضافةً إلى 23 ضابطاً. وفي 20 حزيران/يونيو 2012، حلّق حسن حمادة، وهو طيار مقاتلة من طراز ميغ 21، بطائرته إلى الأردن لطلب اللجوء السياسي. وفي 4 آب/أغسطس 2012، ندّد الطيار محمد أحمد فارس، وهو أول رائد فضاء سوري، علناً بنظام الأسد وهاجر إلى تركيا؛ وشهد يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، انشقاق أول ضابطة علوية امرأة، العقيد زبيدة الميقي.

حدت هذه الانشقاقات بالعديد من المراقبين إلى توقّع سقوط سريع لبشار الأسد ونظامه. وقد غذّى رئيس الوزراء السابق رياض حجاب، الذي غادر سورية في آب/أغسطس 2012، هذه التوقعات، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عنه قوله:
"بناءً على خبرتي وموقفي، النظام ينهار أخلاقياً ومادياً واقتصادياً". وأضاف أن "جيشه يتآكل ولايسيطر سوى على 30 في المئة من الأراضي السورية".

مع ذلك، وعلى الرغم من ضعف قوات النظام وترسيخ الانتفاضة المسلّحة، ظلّ نظام الأسد صامداً ونجح في إعادة تنظيم قدراته .
في ظلّ تماسك قواته المسلّحة النظامية تحت التهديد، اعتمد النظام أكثر فأكثر على تكتيكات مكافحة التمرّد على نطاق واسع مثل القصف أو الضربات الجوية، فضلاً عن الشبيحة غير النظاميّين (الميليشيات الموالية للنظام) وحزب الله اللبناني شبه العسكري. وقد أدّى ذلك إلى تحويل الصراع إلى حرب أهلية شاملة بين المجموعات المتمرّدة المختلفة والنظام الذي يتعاون جيشه مع القوات غير النظامية الموالية للنظام. في الوقت نفسه، بُذلت محاولات لتعزيز تماسك جيش النظام من خلال تكثيف آليات الرقابة وزيادة حوافز الولاء.
عملية عسكرة المعارضة وتحويل القوات الموالية للحكومة إلى ميليشيات، تعني أنه على الرغم من احتمال أن يكون نظام الأسد ضعيفاً للغاية بحيث لايستطيع كسب الحرب واستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، إلا أنه يبقى قوياً جداً بحيث لايخسرها. فلم يؤدِّ عصيان الجيش إلى سقوط النظام، إلا أن عدد وتوقيت حالات الهروب الجماعي كان لهما تأثير كبير على طبيعة الصراع وحياة الضباط والجنود وأسرهم.
الطائفية وانعدام الثقة
ينتمي الفارّون من الجيش إلى كل المهن والبيئات من حيث الدخل الفردي والتعليم والخلفية الاجتماعية، غير أن معظمهم من العرب السنّة. من الناحية الشكلية، يدعم هذا الوضع تصوير الصراع على أنه يتأثّر إلى حدّ كبير بالديناميكيات الطائفية. ومع ذلك، فإن هذه لاتعدو كونها قراءة مبسّطة. فالتوتّرات الطائفية هي نتيجة للصراع، وأيضاً في جزء كبير منها نتيجة للخطاب الطائفي الذي اعتمده النظام. أمّا في الجيش، فقد ساهم انتشارُ السردية الطائفية في انتشار عدم الثقة في الوحدات العسكرية وبذلك شكّل عقبة في طريق الفرار.
على الرغم من أن معظم الفارّين من السنّة، إلا أن الهوية الطائفية ليست هي السبب الرئيس للفرار. ويبدو ذلك جلياً في اتجاهين تمت ملاحظتهما بين الفارّين:
أولاً، وهو الأمر الأكثر أهمية، لم يترك كل السنّة الجيش السوري، ونادراً ماقام الجنود السنّة بأعمال جماعية ضد الضباط العلويين. على سبيل المثال، ذكر أحد الفارّين أنه بعد أن تواصل مع خمسة عشر من زملائه الجنود بشأن خططه، وكانوا جميعاً من السنّة، لم ينضم إليه سوى واحد منهم فقط. وأشار الآخرون، من بين أسباب بقائهم في الجيش، إلى مخاوف أمنية وتوقعات بأن يجري تسريحهم خلال وقت قصير. كانت هذه التجارب هي القاعدة، وليست الاستثناء، ولم تكن الهويات الطائفية أساساً لحالات الفرار الجماعية.
ثانياً، مايقرب من نصف من استُطلعت آراؤهم اختاروا الهروب ومغادرة البلاد بدلاً من القتال ضد النظام. ولا يعبّر ذلك عن وجود تظلّمات عميقة تجاه النظام العلوي باعتباره سبباً أساسياً يدفع إلى الهروب، بل بالأحرى كان للكثير من الأفراد العاملين في الجيش شكاوى إزاء الردّ العسكري للنظام على المظاهرات التي بدأت سلمية. لكن، بالنسبة إلى العسكريين السابقين الذين تركوا وحداتهم، لم تؤدِّ الهويات الطائفية والدينية سوى دور جزئي في تحفيزهم على العصيان.
كان الكثير من الفارّين حريصين على التأكيد أنهم لايشعرون بأي عداء طائفي قبل الانتفاضة. في بداية انتفاضة العام 2011، كان تكوين ضباط الصف والجنود يعكس التنوّع الديني في المجتمع السوري على الرغم من أن الأقليات، والعلويين على وجه الخصوص، كان لهم تمثيل زائد بصورة كبيرة في سلك الضباط. كانت بعض وحدات النخبة العسكرية والأمنية، مثل الحرس الجمهوري أو الفرقة المدرّعة الرابعة، تستقطب مايقرب من 80 في المئة من ضباطها من الطائفة العلوية. وحده تجنيد الضباط المكلّفين وغير المكلّفين كان يتم على أساس طوعي. على النقيض من ذلك، يتم تجنيد الجنود وضباط الصف بشكلٍ إلزامي عموماً، وهم يشكّلون الغالبية العظمى من أفراد الجيش.
بينما كان الجيش السوري يزخر دائماً بالعلويين، ولاسيما في سلك الضباط، وصف المشاركون في الاستطلاع الجيشَ بأنه قوة مهنية لم يكن الدين يلعب دوراً هاماً فيها. وأفاد كل المشاركين في الاستطلاع تقريباً بأن العلويين حافظوا على علاقات زمالة مع أبناء كل الطوائف، وتفاعلوا بانتظام مع غير العلويين في الكليات العسكرية وفي الثكنات وفي البيئات الاجتماعية. وعندما طُلب منهم تقييم العبارة التي تقول: "في آذار/مارس 2011، كان أفراد وحدتي الآخرون أصدقاء شخصيين ومقرّبين"، وافق عليها 74 في المئة من المستطلعين أو وافقوا بقوة. وعارض 89 في المئة من العيّنة نفسها أو عارضوا بقوة العبارة التي تقول: "عموماً، من المهم أن يتشارك أفراد الوحدة العسكرية المعتقدات الدينية نفسها".
غير أن الطائفية تطوّرت أيضاً مع تطوّر الحرب. فقد أكّدت العيّنة السنّية من المستطلعين أن وجود الجنود والضباط العلويين أثّر على قدرتهم على نقل شكاواهم حول النظام إلى زملائهم الجنود. وتكوّنت درجة كبيرة من عدم الثقة بين السنّة والعلويين، على وجه الخصوص، حيث كان السنّة يعتبرون إخوانهم في الدين أجدر بالثقة. وقال أحد الفارّين: "كان معظم الأشخاص في وحدتي من السنّة. أنت تعرف ماذا يعني ذلك؛ يمكنك أن تثق بهم بطريقة أو بأخرى. كانوا جميعاً مع الثورة". وكما ذكر خبير الشؤون السياسية هشام بو ناصيف، فقد كانت الشكاوى المنسوبة إلى الهوية واضحة ولاسيما بين الضباط السنّة.
مع ذلك، وعلى الرغم من أنه كان هناك قدرٌ أكبر من الثقة بين أبناء الدين الواحد، فإن هذا لايستثني كل حالات الثقة والاحترام بين الطوائف. أحد الفارّين السنّة كان صريحاً بصورة خاصة في التقليل من شأن الطائفية:
"لقد كنت أثق حتى بصديق علوي مقرّب. هو موالٍ للنظام، ولكنني لاأزال أثق به. وهم جميعاً كانوا يثقون بي أيضاً. ناقشنا القضايا السياسية كثيراً. لكننا كنا نثق ببعضنا بعضاً، ولذلك لم يحدث شيء. تحدثنا مرتين حتى بعد هروبي. سمعتُ أن شقيقه قُتل في دمشق، لذلك اتصلت به لأقول له إنني آسف لخسارته. كان حزيناً جداً لأنني لم أتواصل معه بعد هروبي".
كشفت الاستبيانات والحوارات المفتوحة أن انعدام الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين كان أكثر وضوحاً حتى بعد اندلاع الصراع، إذا ماقورِن بانعدام الثقة بين الطوائف. وعندما طُلب منهم الرد على العبارة التي تقول: "في آذار/مارس 2011، كنتُ أثق برئيسي المباشر في وحدتي العسكرية"، عارضها مايقرب من 80 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أو عارضوها بقوة. وقد شكّل الانتشار المتزايد للسردية الطائفية عقبة أخرى أمام الفرار من الجيش.
المجنّدون والمتطوّعون
منذ اندلاع الحرب وحتى قبل ذلك، لم تكن الخدمة العسكرية تحظى بشعبية، وكان التهرّب من التجنيد ظاهرة واسعة الانتشار نسبياً بين المجنّدين. في المراحل الأولى من الصراع، كان النظام السوري قلقاً إزاء ضمان استمرار تدفّق المجنّدين الجدد. وفي محاولة لتعزيز عمليات التجنيد، تمّ تخفيض مدّة الخدمة العسكرية الإلزامية من واحد وعشرين إلى ثمانية عشر شهراً في آذار/مارس 2011. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أصدر الأسد مرسوماً تشريعيّاً يمنح عفواً عاماً للمتهرّبين من أداء الخدمة، شرط أن يحضروا إلى مركز التجنيد في غضون ستين يوماً. كما بُذلت جهودٌ أخرى للتجنيد. على سبيل المثال، ألقت المخابرات العسكرية القبض على أحد الأشخاص الذين قابلناهم، وتمّ إرساله لأداء الخدمة الإلزامية في أواخر العام 2011، بعد أن نجح في تجنّب الخدمة العسكرية لسنوات عدّة.
مع ذلك، كان التطوّع في الخدمة العسكرية يعكس التزاماً أكبر بالجيش كمؤسّسة، ولقضيته السياسية في نهاية المطاف. بالنسبة إلى المتطوعين، ينطوي الانضمام إلى الجيش أيضاً على عددٍ من الامتيازات المهنية، بدءاً من الحصول على سكن عسكري خاص، وقروض تفضيلية، ومعاشات تقاعدية، وفوائد غير رسمية مستمدّة من الأنشطة غير المشروعة. وبالتالي، فقد صدّق المتطوعون النظام الذي وعدهم بقدرٍ من الأمن الاقتصادي والمكانة الاجتماعية. وعندما طُلب إليهم الرد على عبارة: "عند اتخاذ قرار حول ما إذا كان علي البقاء في وحدتي أو تركها، كنتُ قلقاً بشأن عدم تمكّني من توفير الدعم المالي لعائلتي"، وافق نصف المجندين فقط من أفراد العيّنة أو وافقوا بقوة. في المقابل، وافق 82 في المئة من المتطوّعين أو وافقوا بقوة على العبارة نفسها. وهذا يشير إلى أن المتطوعين كانوا يعتمدون على الدخل الناتج عن الخدمة العسكرية إلى حدٍّ أكبر بكثير من المجنّدين.
كان المتطوّعون أيضاً من الصاعدين على السلم الاجتماعي. وبينما أكمل آباؤهم عادةً الدراسة الابتدائية وعملوا في الغالب كمزارعين أو أصحاب محال تجارية، فقد أنهى هؤلاء المتطوعون الثانوية العامة على الأقل. والواقع أن 25 من 29 متطوعاً من أفراد العينة حصلوا على مستوى تعليمي أعلى بكثير من آبائهم. وعلى النقيض من ذلك، أشار خمسة عشر فقط من أصل 32 مجنّداً إلى النمط نفسه. كما أن الأوضاع الاقتصادية المتردّية التي سادت في السنوات التي سبقت انتفاضة العام 2011، جعلت الخدمة العسكرية التطوعية أكثر جاذبية من الناحية المالية للمتعلّمين العاطلين عن العمل. وقد غيّرت الإصلاحات الليبرالية الجديدة خلال العقد الأول من القرن الحالي، والنمو السكاني في المناطق الحضرية الناجم عن الجفاف الشديد وانخفاض الإنتاج الزراعي بعد العام 2006، مشهدَ الحراك الاقتصادي في سورية. وانضم مايقرب من نصف المتطوعين الذين قابلناهم إلى القوات المسلحة كضباط صف أو ملازمين، وسط الظروف السيئة التي عانى منها الاقتصاد الكلّي في الفترة بين 2006 و2010.
الاقتصاد السياسي للفرار من الجيش في الحرب الأهلية السورية
اتّسمت الحوافز الاقتصادية بأهمية متزايدة في عملية تجنيد أفراد الجيش قبل الثورة السورية. ومن غير المستغرب ربما أن قيادة الأسد العسكرية أبقت، خلال الحرب الأهلية، على هذه الحوافز الاقتصادية وحسّنتها إلى حدّ ما، سعياً منها إلى الإبقاء على الجنود والضباط.
الواقع أن النظام رفع رواتب أفراد الجيش ورجال الأمن ثلاث مرات منذ اندلاع الحرب. ففي 24 آذار/مارس 2011، نصّ المرسوم الرئاسي الرقم 40 للعام 2011 على زيادةٍ لمرة واحدة على رواتب الموظفين الرسميين قدرها 1500 ليرة سورية (حوالى 32 دولاراً آنذاك)، وزيادة نسبتها 30 في المئة على رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين الرسميين الذي يتقاضون أقل من 10 آلاف ليرة سورية شهرياً، وزيادة نسبتها 20 في المئة على رواتب مَن يتقاضون أكثر من 10 آلاف ليرة. هذه الخطوة أعقبتها جولة أخرى من الزيادات أُقِرَّت في 22 حزيران/يونيو 2013. فقد نصّ المرسوم الرقم 38 للعام 2013 على زيادة بنسبة 40 في المئة على أول 10 آلاف ليرة، وزيادة أخرى بنسبة 20 في المئة على ثاني 10 آلاف ليرة للجنود والموظفين الرسميين. كما نصّ المرسوم الرقم 39 للعام 2013، والذي صدر في اليوم نفسه، على زيادة رواتب العسكريين التقاعدية.
مؤخراً، في 18 كانون الثاني/يناير 2015، مُنِح الموظّفون الرسميون وغير الرسميين كافة دفعةً لمرة واحدة قدرها 4 آلاف ليرة سورية تُضاف إلى رواتبهم في الشهر التالي، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الرقم 7 للعام 2015. لكن في ظلّ تضخّم أسعار المواد الغذائية، والذي قُدِّر بـ169 في المئة في بعض الأشهر، إضافةً إلى عوامل أخرى، بالكاد عوّضت هذه الزيادات التراجعَ في المداخيل الفعلية لأفراد الجيش.
لقد شدّد الفارّون الذين تكلّمنا معهم كلهم تقريباً على التظلّمات المعنوية والأخلاقية الكامنة وراء قرارهم ترك الجيش. فبالنسبة إلى مَن شهد منهم القمعَ العنيف للمدنيين السوريين، وشارك فيه أحياناً، لم تكن خسارةُ راتبٍ ضئيلٍ أصلاً حاجزاً أساسياً أمام الفرار من الجيش.
أما الضباط ذوو الرتب العالية، فخاطروا بخسارة المزيد لدى مغادرة الجيش. بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد، عنى الانشقاق التخلّي عن فرص اقتصادية مهمة. فعلى سبيل المثال، لفت ضابط عالي الرتبة إلى أن الانشقاق قد يكلّفه راتباً جيداً، وعدداً من السيارات، ومزرعة جميلة. يُذكَر أن مزايا الضباط قد تكون مربحة بشكل خاص في سلاح الجو. فقد زعم عقيد أنه كان يتقاضى راتباً شهرياً قدرة 40 ألف ليرة سورية، وكان يحصل على إجازة في فرنسا لمدة خمسة عشر يوماً، إضافةً إلى المكانة والرضى عن مكان العمل اللذين يرتبطان بمهنة الطيّار.
ثمة حوافز أخرى أيضاً، مثل نظام مكافآت يتضمّن زيادات على الرواتب ودفعات مالية مقابل كشف معلوماتٍ عن فارّين محتملين وأي شخص يتعامل مع "إرهابي". والواقع أن حوالى 15 في المئة ممَّن قابلناهم قالوا إن علاوةً ماليةً عُرِضَت عليهم قبل فرارهم، مقابل البقاء في الجيش. فقد وصف أحد كبار ضباط الصف ممَّن خدموا عشرين عاماً في الجيش، كيف عرض عليه النظام مالاً مقابل قيادة مجموعة تتيح له سرقة الناس كما قال. وقد خاض لواء سنّي انشقّ عن النظام تجربةً مروّعةً عندما اعتقلت قوات النظام نجله وعذّبته كما ادّعى. فتدخّل مسؤول عالي المستوى في مخابرات سلاح الجو لإطلاق سراحه، وعُرِض على اللواء تعويضٌ مالي عن محنة نجله في محاولةٍ واضحةٍ لشراء ولائه.
إضافةً إلى الحوافز الرسمية، أتاحت الانتفاضة في سورية فرصاً مربحةً ولكن غير شرعية، ولاسيما للقادة الضباط. إذ أقدم الجنود مثلاً على رشوة رؤسائهم لتفادي أن يتم اختيارهم للقيام بدوريات. فكما شرح أحد المجنّدين، كان الجنود كلهم يخافون من مغادرة الثكنات أثناء تلك المهام، ولاسيما ليلاً، لأنهم لم يكونوا متأكّدين أين يذهبون، وماسيفعلون هناك، ومَن سيواجهون. هذا ويُجرى تبادل الأموال مابين الجنود ليتم تعيينهم في مناطق معيّنة. فقد روى أحد الفارّين من الجيش القصة التالية:
"اتصلت بنسيبي... الذي كان مع الجيش السوري الحر، فطلب مني أن أذهب إلى حماة لأنهم قد يساعدونني هناك. فرشَوْت الضابط المسؤول عني بـ50 ألف [ليرة سورية] ليسمح لي بالذهاب إلى حماة بدلاً من درعا. عادةً لايمكن أن نُعيَّن في أي مكان قريب من مسقط رأسنا، لأن من شأن ذلك أن يسهّل انشقاقنا. إذ يمكننا الحصول بسهولة على المعلومات والمساعدة من عائلتنا".
كما أن الرشاوى كانت حاسمة أيضاً لتعيين فترة الإجازة التي جرى تقييدها لخشية النظام من أن تُسهِّل الفرار من الجيش. فعلى سبيل المثال، دفع ضابط في القوات الخاصة مالاً لرئيسه ليمدّد له إجازته الطبّية بعد خضوعه إلى عملية جراحية، ما أتاح له وقتاً لتخطيط انشقاقه. وقد روى مجنّد آخر تجربته قائلاً:
"بعد أقل من عام على اندلاع الانتفاضة، قبضت المخابرات العسكرية عليّ وأرسلتني إلى الخدمة العسكرية في القوات الخاصة في دمشق. خضعت إلى تدريبات هناك لستة أشهر تقريباً، ثم رشوت ضابطاً ليعطيني إجازة مدّتها خمسة أيام. أمضيت تلك الأيام مع عائلتي، وأثناء إجازتي تمكّنتُ من الفرار من الجيش بمساعدة بعض الأصدقاء والمعارف".
لقد تفشّى الفساد في الجيش، إذ كان بالإمكان رشوة الجنود لمساندة الثورة المسلحة، أما العناصر الذين أُدينوا لقيامهم بذلك، فكانوا يحصلون أحياناً على فرصة لشراء حريتهم. على سبيل المثال، روى أحد الضباط السابقين كيف استغلّ موقعه في مخرن للوقود، في أحد المطارات العسكرية بالقرب من دمشق، ليبيع الوقود للمتمرّدين في محافظة حماة. ولم ينشقّ عن الجيش إلا بعد أن اكتُشِفَت أنشطته واعتُقِل.
تشير التقارير إلى أن الضباط الفاسدين في الجيش باعوا أيضاً أسلحة لمجموعات المتمرّدين. فعلى سبيل المثال، قال أحد أعضاء مجموعة صقور الشام الثورية التي تنشط في جبل الزاوية، مراسلاً في حزيران/يونيو 2012 إن المتمرّدين حصلوا على حوالى 40 في المئة من أسلحتهم وذخيرتهم من خلال صفقات مع النظام. وشرح قائلاً إن "هؤلاء الضباط يتاجرون معنا لا لأنهم يحبّون الثورة، بل لأنهم يحبّون المال". وروى ضابط آخر، أيّد سرّاً الانتفاضة في تدمر، تجربته في الفرار من سجن النظام بعد أن اكتُشِفَت أنشطته:
"بعد أربعة أيام من الاستجواب، وضعوني في زنزانة لخمسة وأربعين يوماً. أتى ضابط من فرع الأمن إلى باب زنزانتي... همس في أذني أن الضباط في الفرع يستطيعون إخراجي مقابل المال، وإلا سأُنسى في السجن. وهكذا، إذا أردت الخروج من السجن، عليّ أن أدفع. خفت وظننت أنه فخّ. إذ بما أنهم لم ينجحوا في الحصول على أيّة معلومات منّي عن طريق التعذيب، فسيحاولون بطريقة أخرى. لذا رفضت. لم أرتكب شيئاً، إذ لم أكن على ارتباط مع الجيش السوري الحر، ولذا لم أرِدْ أن أدفع. بعد يومين أو ثلاثة، فقدت الأمل، فحاولت التكلّم مع الرجل مجدداً... عندما عاد، أخبرته بأنني أقبل عرضه. أراد 100 ألف [ليرة سورية]، فقبلت. قال لي إنه سيأتي بورقة وقلم... أخذت الورقة وكتبت عليها رقم أحد الأصدقاء، الذي كان ضابطاً أيضاً. رفض الرجل في البداية أن يتّصل بضابط، إلا أني أخبرته بأنبي أثق بذلك الرجل. فاتصل رجل الأمن بصديقي، وصديقي دفع المال. كلّفني الأمر 250 ألف [ليرة سورية]، ولكنني كنت حراً مجدداً".
وقال نقيبٌ لجأ إلى تركيا مُلخِّصاً، إن "الذين لم ينشقّوا حتى الآن يحصلون على منافع من النظام. إذ يمكنهم مثلاً أخذ الوقود وبيعه. إنهم يجنون أرباحاً كثيرة. كما أنهم يكسبون لأنهم نافذون للغاية والناس يحترمونهم".
في المقابل، كانت الانشقاقات في صفوف الضباط رفيعي المستوى نادرةً نسبياً، إذ أن لهؤلاء الكثير ليخسروه من الناحية الاقتصادية. أما الضباط الذين انشقّوا، فبعضٌ منهم غادر لأنه وُعِد بمكاسب مالية في مكان آخر، مع أن هذه العروض لم تثمر عن شيء يُذكَر. فقد تلقّى عقيد انشقّ إلى الأردن دفعتين على راتبه في البداية مصدرهما المملكة العربية السعودية، ولكنه لم يتلقَّ أي دفعات بعد ذلك، ماجعل فراره مكلفاً للغاية. وقال عقيد آخر إنه تلقّى راتباً بقيمة 475 ديناراً أردنياً (حوالى 670 دولاراً) شهرياً لدى وصوله، إلا أن الراتب سرعان ماتراجع إلى 150 ديناراً (210 دولارات) لمدة ستة أشهر أو أكثر. كما روى عقيد آخر قصة مماثلة، إذ قال إنه بين العامَين 2011 و2012، كانت حكومات عربية أخرى تشجّع الضباط على الانشقاق. لكن المنشقّين كانوا يحصلون على 600 دولار ثم يواجهون مشقّات جمة. وقال إنّه شعر بأن الضباط في سورية أرادوا الرحيل، لكنهم سرعان ماعاينوا كيف يعيش المنشقّون في الخارج، وأدركوا أن من المستحسن لهم أن يلازموا أمكنتهم.
كانت تأثيرات اقتصاد الحرب على الجيش السوري متباينة. فالمكافآت المحدودة للجنود العاديين لم تَحُل دون فرارهم، لأن هؤلاء الجنود كانوا يحصلون على رواتب وحوافز مالية وفرصاً غير شرعية محدودة للإفادة في خضم الانتفاضة. في المقابل، كان للضباط مكاسب اقتصادية أكبر يحصلون عليها من مواقعهم العسكرية، وبالتالي كانوا ليتكبّدوا خسائر أكبر إذا انشقّوا عن نظام الأسد.
الفرار أم القتال؟ الفارّون من الجيش واقتصاد تجنيد المتمرّدين
مع أن العديد من العسكريين تركوا الجيش لأسباب غير إيديولوجية، إلا أن مقابلاتنا أظهرت أن نصف الذين قابلناهم تقريباً تركوا الخدمة العسكرية للقتال مع المعارضة. لكن حتى بعض هؤلاء الجنود السابقين فعلوا ذلك لضرورة اقتصادية على الأقل جزئياً، لا لحافز سياسي من أجل القتال. وفي حين أن معظمهم لم يفرّ من الجيش استناداً إلى أسباب اقتصادية، تأثّر العديد منهم بشدّة بالحقائق الاقتصادية حالما غادروا مواقعهم. ولذا، أخذ كلٌّ من الجنود والضباط المنشقّين في الاعتبار العوامل المادية عندما عُرِض عليهم الخيار الحاسم: أي ما إذا كان ينبغي القتال ضد نظام الأسد أم الفرار من البلاد.
بالنسبة إلى أفراد الجيش السابقين، أتاح لهم الانضمام إلى الثورة الحصول على الحاجات الأساسية. صحيح أنه لم يكن بإمكان مجموعات المتمرّدين كلها أن تدفع رواتب منتظمة لمقاتليها، إلا أن اقتصاد حربٍ أهليةٍ غير رسمي برز في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وأتاح لمجموعات المتمرّدين تنظيم تدفّق الموارد المهمة. فقد موّل المتمرّدون أنشطتهم من خلال السيطرة على حقول النفط، والمصافي صغيرة الحجم، وإنتاج الحبوب وتوزيعها؛ ومن خلال فرض الرسوم على المعابر الحدودية أو الطرق السريعة، والقيام بعمليات خطف أحياناً. فعلى سبيل المثال، حصّلوا ضريبة قدرها 20 ألف ليرة سورية (حوالى 106 دولارات) من كل شاحنة تعبر الحدود مع تركيا في باب السلام في حلب. هذا وقد شكّل سوقٌ بالقرب من منبج، شرق مدينة حلب، مركزاً أساسياً للاتجار بالنفط الخام بين مجموعات المتمرّدين. وطبعاً، أدّت الحوافز الاقتصادية إلى تقاتلٍ مابين مجموعات المتمرّدين، تركّز حول السيطرة على الموارد القيّمة من الناحية الاقتصادية.
يُضاف إلى ذلك أن المجتمع الدولي كان وراء تغذية اقتصاد المتمرّدين إلى حدٍّ كبير، بسبب قراره بالإبقاء على قنوات الدعم الاقتصادي لمجموعات المتمرّدين المناهضة للأسد، بدلاً من التدخّل مباشرةً. وفي حين أن التمويل الغربي للمجموعات المسلحة المرتبطة بالجيش السوري الحر كان محدوداً للغاية، ازدهر التمويل من بلدان الخليج ووُجِّه إلى مجموعات المتمرّدين التي تشدّد على الهوية الدينية السنّية، . وقد اشتمل الدعم الاقتصادي الخليجي على كلٍّ من المنح الخاصة والدفعات الحكومية المباشرة. وكانت المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي تعهّد بتقديم الدعم للانتفاضة المسلحة في اجتماع أصدقاء سورية في تونس العاصمة، في 24 شباط/فبراير 2012. وفي اجتماع أصدقاء سورية الذي عُقِد في اسطنبول، في 1 نيسان/أبريل 2012، وعد كلٌّ من السعودية وقطر بتقديم دعم إضافي لدفع رواتب مقاتلي المعارضة.
أتاح اقتصاد الحرب الأهلية في سورية لمجموعات المتمرّدين أن تضمن الوصول إلى الحاجات الأساسية، وتؤمّن حتى الغنائم للمقاتلين من حين إلى آخر. وبالفعل، استطاع بعض مجموعات المتمرّدين الأكثر ثراءً من توفير أجر متواضع. فقد شرح ضابط ذو رتبة متدنية، خدم أكثر من عام في إحدى الوحدات المنضوية تحت مظلة الجيش السوري الحر، أن مجنّدي هذا الأخير كانوا يجنون آنذاك راتباً قدره 50 دولاراً في الشهر. وهذا المبلغ من المال يُعَدّ معقولاً للفارّين من الجيش، الذين تخلّوا عن عملهم ومدخولهم.
شكّلت إمكانية الوصول إلى السلع الأساسية بانتظام، وإلى التعويض المالي من وقتٍ إلى آخر، عاملاً جاذباً للعديد من السوريين الشباب، بمَن فيهم الفارّون من الجيش. فعلى سبيل المثال، خطّط العديد ممَّن قابلناهم في تركيا للفرار إلى أوروبا أو العودة إلى سورية للقتال بعد نضوب مواردهم المالية. ومع أن واحداً منهم فقط قال إنه عاد إلى سورية للقتال بعد وصوله إلى تركيا، أقرّ آخرون كثرٌ بأنهم فكّروا في الانضمام إلى الثورة ضد الأسد لدواعٍ مالية، باعتبار ذلك ملاذاً أخيراً. والحال أن سلامة أُسَر الفارّين من الجيش أثّرت إلى حدّ كبير على قراراتهم، كما روى ضابط ذو رتبة منخفضة ارتبط بالجيش السوري الحر لأكثر من عام قبل أن يتعرّض إلى إصابة. وفي حين أننا لانملك أي أدلّة تثبت أن أفراد الجيش السابقين أُكرِهوا على الانضمام إلى مجموعات المتمرّدين، دفعت الحاجة الاقتصادية البحتة عدداً من الفارّين إلى الانضمام.
في الوقت نفسه، خاب أمل العديد ممَّن قاتلوا ضد نظام الأسد بعد تجربتهم في الثورة المسلحة، بسبب الفساد المستشري في صفوف مجموعات المتمرّدين. قال أحد المجنّدين السابقين الذين قاتلوا مع الجيش السوري الحر لمدة خمسة أشهر، إنه غادر بسبب النقص في الذخيرة، والممارسات الفاسدة لقائده، والرواتب المتأخّرة. ولمّح أخيراً إلى أن القادة وحدهم يفيدون من الجيش السوري الحر. وقد خمّن ضابط عالي الرتبة أن الجيش السوري الحر حرمه ونجله من الوصول إلى مواقع القيادة، لمنع العسكريين ذوي الخبرة من فضح الفساد المستشري في الجيش السوري الحر. كما أشار طيّار سابق منشقّ إلى أن 20 في المئة على الأقل من وحدات الجيش السوري الحر فاسدة وتعمل لمصالح القادة فقط.
خلاصة القول هي أن الروايات التي أوردها الأشخاص الذين قابلناهم، تشير إلى أن الانضمام إلى قوات المتمرّدين كان مربحاً من الناحية المالية للفارّين من الجيش. ولذا، فرص تحقيق الثراء الذاتي متاحة لا في الجيش السوري النظامي وحسب، بل أيضاً في الميليشيات التي أُسِّسَت لمقاتلة هذا الجيش.
خاتمة
اتّبع كلٌّ من الولاء والفرار من الجيش أنماطاً واضحةً في الصراع السوري.أولاً، حصلت معظم عمليات الفرار في صفوف الجنود العاديين، وكان الحافز وراءها عدمُ رغبةٍ في القتال، لامعارضةً للنظام استناداً إلى الإيديولوجيا والهوية. في المقابل، بقيت الانشقاقات المدفوعة بدافعٍ سياسي نادرةً نسبياً.ثانياً، ساهم الفساد المتفشّي في جيش النظام في تعميق هذا النمط. ففي حين أفاد العسكريون من ذوي الرتب الأعلى بشكل متزايد من فرص تحقيق المكاسب غير المشروعة، استخدم العسكريون العاديون الرشوة للتحايل على آليات الرقابة في الجيش. وبالتالي، كان للفساد تأثير تناقضي على التماسك الداخلي للجيش السوري، إذ كان له مساهمة في كلٍّ من الولاء والفرار.ثالثاً، وجد الفارّون أنفسهم عموماً في ظروف اقتصادية صعبة بعد تركهم الجيش. وهذا الأمر لم يحدّ من جاذبية الفرار من الجيش وحسب، بل جعل أيضاً الانضمام إلى الثورة ضرورةً عمليةً للعديد من الفارّين. ونظراً إلى الأفضلية المالية لمجموعات المتمرّدين الجهادية المتطرفة على نظيراتها المعتدلة، ساهمت العوامل الاقتصادية في تقوية المجموعات المتطرفة في المعسكر المناهض للأسد.تشير ديناميكيات الفرار والولاء في الحرب الأهلية السورية إلى أن الداعمين الغربيين للمعارضة المناهضة للأسد يمكنهم أن يُضعِفوا تماسك الجيش، وأن يحدّوا في الوقت نفسه من جاذبية مجموعات المتمرّدين المتطرفة، من خلال معالجة محنة الذين اتّخذوا قرار المغادرة. فمعالجة أزمة اللاجئين في البلدان المجاورة لسورية لايُعَدّ همّاً إنسانياً وحسب، بل ينبغي أن يُنظَر إليه أيضاً على أنه جزء من استراتيجية أوسع للتأثير في مجريات الأزمة السورية. مركز كارنيغي للشرق الاوسط