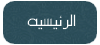حرصت منذ قيام ثورة يوليو عام 1952 على تحاشى الرئيس جمال عبدالناصر، رغم حبى وصداقتى له قبل قيام الثورة. وزاد الأمر مع توليه إدارة شئون البلاد؛ حيث زاد إصرارى على الابتعاد عنه هو ودائرته المقربة منه. كانت نفسى تأبى إتيان ما يفعله البعض من رياء ومداهنة، إلا أن هذا لم يقلل من احترامى وثقتى فى زميل الدراسة وصديق العمر الذى كنت أقدّر فيه حسّه الوطنى، ونظافة اليد. كنت أراه فقط حينما يستدعينى لأمر ما، أو يلتقى بى فى زيارة أو مناسبة عسكرية، فكان يسألنى ويستفسر منى عن أى أمر يود السؤال عنه لأنه كان يعلم أننى سأصدقه القول.
كان شعورى دائماً نحو الرئيس جمال عبدالناصر هو المحبة والثقة والزمالة والصداقة، وقد تكون هذه الأمور التى كنت أتعامل معه على أساسها سبباً فى خروجى من القوات المسلحة، فكثيراً ما كنت أناقش الرئيس وأعارضه فى أفكاره بحثاً عن المصلحة الوطنية وعلى أساس أنه مدرّس بطبيعته؛ حيث كان مدرساً فى الشئون الإدارية فى كلية أركان الحرب وكان يحب المناقشة والإقناع، لكنه على ما يبدو رأى أن هذه الفترة والظروف التى تحيط بالوطن لا تحتمل المناقشة والجدل، حتى إنه فى أول اجتماع رسمى للقادة عندما هممت بالـرد على أحد المواضيـع، استشعر موقفى وقال لى قبل أن أتكلم: «لا أريد مبررات يا أحمد إسماعيل».
عموماً، كنت أرى أنه فعلاً رئيس الدولة وله مركزه العالمى والدولى، ولكننى أيضاً لى فكر وعقل وكنت أرى أنه من حقى أن يسمع رأيى، وله الحق فى أن يأخذ به أو يتجاهله فهو صاحب الشأن والقرار والمسئولية. كنت أؤمن بأنه لا يمكن لمخلوق أو بشر أن يقوم بمثل ما يقوم به هذا الرجل. لقد كان يبدى قرارات وآراء فى كل ما يمس الدولة داخلياً وخارجياً، ويمتلك من الثقة بالنفس ما يمكّنه من إصدار قراراته فى كل ما يتعلق بالدولة حتى فى بعض الأمور التى لا تحتاج إلى رئيس الجمهورية. وكنت ألاحظ أن الجميع يبعدون المسئولية عن أنفسهم ويستشيرون الرئيس فى كل أمر من أمور الوزارات؛ الأمر الذى زاد الأعباء عليه وقد ذكرت له ذلك كثيراً ولكنه لم يكن يسمع لأحد.
ورغم أننى خرجت من الخدمة بموافقته الشخصية سواء كان بأمر أو بما عُرض عليه، سواء كان لأسباب حقيقية أو لأسباب مفتراة علـىّ، وسواء كان نتيجة مناقشاتى أو آرائى المختلفة، أو سواء توهم الوزير أننى غير متعاون معه.. كل ذلك لم يغير شيئاً من شعورى نحو الرئيس، وأكتب هذا الآن بعد مضىّ نحو شهر على وفاة الرئيس وما زلت أحبه وأقدّره وأحترمه وأثق به مثلما كنت أشعر تجاهه وأنا فى الخدمة. وبعد خروجى من الخدمة كثيراً ما كنت أسمع من أشخاص كثيرين يظنون أننى قد تحولت عن محبة الرئيس بسبب إحالتى إلى التقاعد، فسمعت كلاماً كثيراً لم أكن أسمعه وأنا فى الخدمة خوفاً منى أو حفاظاً على شعورى أو لثقتهم بأننى أدافع عن الرئيس بحكم وظيفتى. ولكن الحقيقة أن دفاعى عن الرئيس كان كما هو وكان ردى دائماً أنه ليس لدينا لا فى مصر ولا فى الدول العربية من يحل محل الرئيس جمال عبدالناصر، فهو رجل موهوب فذ، وهبه الله من صفات الزعيم والقائد ما لم يمنحه غيره، وقضى 18 عاماً كلها آمال وآلام ومعارك. لا أذكر عاماً واحداً مرّ دون مشاكل داخلية أو عالمية أو خارجية، لكن عبدالناصر كان رجلاً ذا خبرة وحنكة، وليس لدينا شبيه له، فهو يوضع أولاً ثم بعده بمراحل يأتى من يليه؛ لذلك عندما علمت بوفاته تصورت أولاً أنه اغتيل ثم علمت أنه مات بانسداد الشريان التاجى فبكيت. بكيت الصديق وبكيت على مصر وحظ مصر. بكيت لأن الله لم يمهله حتى يحل مشكلة مصر وهو الوحيد الذى كان بمقدوره أن يحلها محافظاً على كرامة البلاد وكرامة القوات المسلحة، فالمشكلة الآن إما أن تُحلّ عسكرياً، وهذا موضوع يحتاج لباب منفصل للحديث عنه، وهل ستسمح لنا الولايات المتحدة بالنصر عسكرياً؟ وهل سيوافق الاتحاد السوفيتى على أن يمدنا بالأسلحة التى تسمح لنا بالنصر؟ أو أن يكون الحل سياسياً مشرفاً، وهذا يحتاج إلى مناورات عديدة وشخصيات فذة قادرة لتتمكن من التأثير عالمياً حتى تضغط على إسرائيل وتجبرها على الانسحاب. ولم يكن فى مصر أحد سوى جمال عبدالناصر يستطيع القيام بذلك.
بعد علمى بخبر الوفاة، فى حوالى العاشرة مساء، لم أتمكن من النوم؛ لأن جمال عبدالناصر زميلى ودفعتى وصديقى. وكان السؤال الذى يؤرقنى: كيف سنعوضه؟ وأخذت بعض المهدئات والمنومات، الأمر الذى أثار قلق زوجتى لأننى كنت وقتها فى طور النقاهة من مرض انسداد شريان بالقلب واتصلت بمستشفى المعادى فأخبرونى أن جميع الأطباء هناك يبكون جمال عبدالناصر، ونصحونى بالبقاء بالمنزل. يومها لم أستطع وقف تداعى ذكريات تلك الأيام التى جمعتنا منذ زمن بعيد، منذ تزاملنا فى الكلية الحربية. ولا أملك إلا أن أقول: رحم الله الأخ والصديق والرئيس الذى لم يتوانَ لحظة عن أن يحلم للوطن بكل خير.
بعد توليه المسئولية، كان الرئيس السادات قد اتخذ قراراً حاسماً بالقضاء على مراكز القوى فى مصر، وهو ما عُرف بثورة التصحيح فى 15 مايو 1971، فخلص الإنسان المصرى من قبضة أساطير الاستبداد التى كانت تتحكم فى مصيره، وفى نفس العام أصدر السادات دستوراً جديداً لمصر. كنت فى منزلى أشاهد على التليفزيون مع زوجتى البيان الذى أصدره أنور السادات للتخلص من المؤامرة التى كانت تُدبَّر له، وقبل أن ينتهى البيان رن جرس التليفون، ولأنى لم أكن أرد على أى مكالمة تليفونية منذ أُحلت إلى المعاش، قامت زوجتى بالرد على التليفون، وفوجئت بمدير مكتب الرئيس السادات يتصل طالباً أن أذهب إليه على الفور، كان الوقت متأخراً، وكانت الساعة الحادية عشرة ليلاً، كنت عائداً من المستشفى وما زلت فى فترة النقاهة وأمرنى الطبيب بعدم قيادة السيارة، والوقت متأخر، فعرضت زوجتى قيادة السيارة بدلاً منى، وأن تنتظرنى لحين الانتهاء من المقابلة عند أحد أقاربها، وعند خروجنا من باب الفيلا وجدت بالصدفة سائقى الخاص فى القوات المسلحة لسنوات طويلة، جاء ليزورنى، وبلهفة ممزوجة بفرحة قال السائق مصطفى سليم: «البلد مقلوبة.. سمعت خطاب الرئيس أنور السادات؟»، فقلت: «أيوه يا مصطفى وسأذهب إليه الآن»، فأعطت زوجتى مفتاح السيارة للسائق، وذهبنا لمقابلة الرئيس أنور السادات، لأعود مرة ثانية إلى الخدمة، بعد عام ونصف فى المنزل، بسبب إحالتى للمعاش على يد الرئيس جمال عبدالناصر.
ولمصطفى سليم هذا قصة؛ فهو سائقى منذ أن كنت برتبة مقدم، وظل معى طوال خدمتى فى الجيش منذ عام 1955 حتى رئاسة الأركان عام 1969، وعندما خرجت من رئاسة الأركان إلى المنزل، رفض مصطفى سليم أن يبقى فى الجيش ولو للحظة واحدة، وعندما حاولت معه كى يبقى فى الجيش مراعاة لمستقبله، خاصة أنه أصيب إصابة جزئية أيام حرب 1956، وليس معه رخصة تاكسى، وبذل المساعى للخروج منذ فتره طويلة، لكنه قال: «لو هاموت من الجوع لن أسوق لضابط آخر بعد سيادة اللواء»، وكنت أحاول إقناعه لمصلحته ولأننا مادياً لا نستطيع أن نعيّنه فى منزلنا كسائق للعائلة، وندفع له راتباً شهرياً، لكنه خرج دون أن يبقى لحظة واحدة، بعد ذلك ساعدته كى يحصل على معاش معقول بسبب الإصابة، وأن يستخرج رخصة قيادة أجرة، وفعلاً عمل على سيارة تاكسى، وظل يحضر بها من وقت لآخر لزيارتنا، ويسأل إذا كنا نحتاجه فى أى مشاوير، فيترك التاكسى ويقود سيارتنا الملاكى فيات 1300 الخضراء.
أعود بكم لتلك الليلة التى أعلن فيها الرئيس السادات عن التخلص من كل رموز مراكز القوى، فعند متابعة تطور الأحداث من خلال الراديو، فوجئنا بقرار استقالة سامى شرف وشعراوى جمعة ومحمد فوزى ومحمد فايق وباقى المجموعة. قبل خروجى من المنزل اتصلت زوجتى بابننا الأكبر محمد، فى منزله، كانت علاقتى به بعد إحالتى للمعاش قد أصبحت أكثر قوة، وسألته بصوت منخفض عما إذا كان سمع بالأخبار، فنفى لها ذلك، فطلبت منه الاستماع للراديو مؤكدة له إعلان شعراوى جمعة وسامى شرف استقالتهما وأن الرئيس السادات طلبنى وأننى ذهبت له. وصلت لمنزل الرئيس السادات وقابلته فأخبرنى أننى سأعود للخدمة مرة ثانية، وسأتولى رئاسة المخابرات العامة. لحظتها عدت بالذاكرة إلى الخلف، متذكراً علاقتى بالرئيس السادات التى بدأت منذ كنا فى البكالوريا، وكان أنور تربطه علاقة صداقة قوية بأبناء خالى، وكان يذهب إليهم فى حى شبرا الذى كنا نسكن فيه. وتواصلت العلاقة بيننا عبر تزاملنا فى الكلية الحربية، وتعمقت جداً ما بين الكلية وقيام ثورة يوليو 1952، إذ كان السادات وقتها مطلوباً من الأمن القومى؛ لذلك كان يأتى إلى منزلى متخفياً مرة كتاجر فاكهة وأخرى كسائق سيارة نقل، إلى أن تمت الثورة، وتغير حال البلد، وكان السادات يقدر كفاءتى وعلمى ومشوار تدرُّجى فى الجيش، وكان يعلم أيضاً أن السبب الحقيقى فى إحالتى للمعاش وإزاحتى من دائرة جمال عبدالناصر، هو شلة عبدالحكيم عامر والفريق محمد فوزى؛ لذلك وبمجرد أن قام بإعادة هيكلة الحكومة والجيش، طلبنى لتولى قيادة المخابرات العامة التى لا تقل أهمية عن مهامى فيما بعد فى القوات المسلحة.
عدت من رحلة الذكريات التى لم تستغرق لحظات، ووجدت الرئيس يقول لى: «أنت تذهب يا أحمد للمخابرات العامة وتأخذ مجموعة من الحرس إذا اقتضى الأمر، وتتولى رئاسة المخابرات وتخطرنى تليفونياً عند إتمام هذه المهمة»، فقلت له: «حاضر يا افندم» فقال لى الرئيس ضاحكاً: «انت عارف المخابرات العامة فين؟» فرددت: «طبعاً يا افندم، محمد ابنى يعمل بها منذ 5 سنوات». تركت الرئيس السادات وتوجهت لمنزل ابنى الأكبر محمد الذى كان يسكن بجانب مستشفى العجوزة، كان يقف فى شرفة شقته ومعه زوجته يستمعان للأخبار فى راديو ترانزستور، حين وجدا سيارتى تقف أمام المنزل لم يصدق عينه وظن أنه يحلم، فرك عينيه مرة ومرتين وثلاثاً، وإذ به يجد والده ينزل من السيارة، فلم يتمالك محمد نفسه وودع زوجته، وأخبرها أنه سينزل لى وسيتصل بها تليفونياً، وإذا لم يتصل فلا تقلق. كان محمد يعمل ضابطاً فى المخابرات العامة، ومن شدة تأثره لم ينتظر المصعد ونزل على السلم من الدور التاسع، وهو يرتدى بنطلوناً وقميصاً وبلوفر، وسألنى «وزير حربية؟» فقلت «لا، عندكم فى المخابرات». فصاح: «ألف مبروك، دا أحسن من وزارة الحربية»، فضحكت وسألته: «هل أحضرت معك شيئاً ثقيلاً لتلبسه؟»، فقال: «لا، كده كويس»..
كانت المرة الأولى التى أتكلم فيها معه فى عمله، وقد أحس وقتها بثقتى فى رأيه وتقديره للأمور، ودار بيننا هذا الحوار.. «شوف بقى يا محمد، إحنا سنذهب للحرس الجمهورى لنأخذ قوة لنذهب بها للمخابرات العامة، ولكننى أفكر أن أقوم بعملية الذهاب معاً دون قوة من الحرس الجمهورى، أنت طبعاً عارف إيه اللى حصل فى الساعات الأخيرة، ولكن وجود قوة سيضر أكثر مما يفيد»، فقال محمد: «تقريباً وبالنسبة لدخولنا دون حراسة هذا أستطيع أن أضمنه بصفتى ضابطاً بالجهاز»، فقلت: «إحنا سنذهب للحرس أولاً».
اتجهنا بالسيارة إلى كوبرى القبة، وتوجهنا لمكتب اللواء الليثى ناصف لإخباره باستغنائى عن الحرس وذهابى بصحبة ابنى محمد، فمعظم الناس هناك من أصدقائه، فوجدنا عند الليثى اللواء عادل جبريل الذى كان نائباً لرئيس هيئة الأمن القومى بالمخابرات العامة، وأصبح بعدها رئيساً للهيئة بدرجة وكيل لرئيس المخابرات العامة، وهو منصب يستحقه بالفعل لكفاءته، وفوجئ به ابنى محمد عندما رآه وانتابه قلق غير متوقع؛ خوفاً من أن يكشف هذا الشخص الموقف ويتنبه لفكرة ذهابنا إلى المخابرات، لكن سرعان ما وجدنى آخذه بالحضن، فقد كان صديقاً لليثى، وفى نفس الوقت تلميذاً سابقاً لى، وأحد عشاقى -كما قال- وكان يعمل تحت قيادتى بعد تخرجه من الكلية الحربية. تنفس محمد ابنى الصعداء عندما وجد اللواء «عادل جبريل» يعانقنى، وعلمنا منه أنه كان لدى اللواء الليثى ناصف عند سماعه بيان الرئيس، فأخبره بأننى قد عُيّنت مديراً للمخابرات العامة، فانتظر عادل جبريل فى مكتب الليثى الذى كان مجهزاً بقوة لتصحبنا للمخابرات، ولكننى رفضت ذلك، وأيّدنى عادل فى هذا الرأى وطلب أن يذهب معنا على أن ندخل من باب الأمن القومى، لكن محمد صمم على الدخول من الباب الرئيسى، ووافقنا على رأيه، وكان يجلس بجوار السائق. أثناء وجوده معى فى السيارة تذكر محمد، ابنى الأكبر، كيفية دخول المخابرات العامة، فشرح لى نظام الحراسة بالكامل وشرح لى أنه، بصفته ضابطاً صغيراً هناك يمسك نوبتجية، فإن كل الحرس يعرفونه جيداً، فضلاً عن أنهم يلعبون معه كرة القدم مرتين فى الأسبوع فى الصباح، ويعرف كلا منهم باسمه. وإذا طلب منهم أى شىء سيُنفَّذ، كما أن الضباط النوبتجية زملاؤه، وغالباً ما سيكونون إما دفعته أو يعملون معه، وقال محمد لى: «سأطلب منهم (الماستر) بتاع حجرة المدير». كنت أعرف أن زملاء ابنى يحبونه حباً غير عادى، فقلت له: «لما نشوف يا سى محمد»، فرد علىَّ: «المهم أننى لا بد أن أستدعى كافة القيادات وأبلغهم وتتم عملية السيطرة».
وقفنا أمام الباب الرئيسى، فدقق الحارس فينا وتردد فى فتح الباب، فقال محمد له بصوت حاد: «افتح يا محفوظ»، فكان رده: «مساء الخير يا افندم»، وفتح الباب وأدى التحية العسكرية كاملة لى، خاصة أنه تصادف أن محمد كان فى اليوم السابق الضابط المناوب على جهاز المخابرات العامة بأكمله، وأثناء مروره قبل الفجر مروراً مفاجئاً وجد محفوظ ومعه الراديو مفتوح بصوت عالٍ، فنهره عن ذلك، ولم يكن يعرف إذا كان سيشير إلى ذلك فى تقريره عن المناوبة فى الصباح، وبالتالى معاقبته أم لا. صعدنا إلى مكتب المدير وتركنا محمد، الذى ذهب للضابط النوبتجى فحصل منه على الماستر، وكان صديقاً لمحمد فقال له: «مبروك يا ابوحميد»، فرد عليه: «لست على استعداد لتلقى أى تهانى إلا بعد أن تستقر الأمور»، وفتحت المكتب وبدأ السيد عادل جبريل يستدعى القيادات، وبعضها حضر من نفسه دون استدعاء، خاصة أنهم كانوا يتوقعون حدوث ذلك بين لحظة وأخرى، ومنهم الوكيل محمد ياقوت، ومنهم الشخص الذى كان يتولى التسجيل لمراكز القوى -على صبرى ومجموعته- والذى روى لى أن أحمد كامل رئيس الجهاز السابق استدعاه فى أحد أيام شهر أبريل 1971 بعد مقابلته للرئيس السادات، وبعد أن استشعر من خلال المقابلة أن التسجيل يتم دون علم الرئيس، وطلب منه حرق كافة الشرائط وإعطاءه «تمام» بذلك، فأعطاه التمام لكنه لم يحرقها، وقدم لى الشرائط كلها عند تولى رئاسة الجهاز، وقال إنه فعل ذلك بدافع وطنى، ولحرصه على الشرعية، ولتقديره أن ما حدث كان لا بد أن يحدث.
اتصلت بالرئيس أنور السادات حوالى الساعة 1 صباحاً، وأعطيته التمام، وصعد محفوظ، مسئول الأمن الذى فتح لنا باب الجهاز حوالى الساعة 5 صباحاً إلى محمد، ربما بعد أن علم من السائق مصطفى سليم أو من صعود قيادات الجهاز لمكتب المدير الجديد بما حدث، ليقول له وهو يضحك: «مبروك يا افندم خلاص التيم بتاعنا مش هيقدر يكسب التيم بتاع سيادتك»، فرد محمد عليه بالقول: «أبداً يا محفوظ، إذا كان دا هيحصل أنا هاعتزل الكورة وأسيب الجهاز خالص». وفعلاً قرر محمد منذ الخامسة صباحاً بعد استقرار الأمور لى فى إدارة الجهاز ترك عمله والانتقال لعمل آخر؛ إذ كيف يعمل مع والده فى مكان واحد؟ وطلب منى ذلك فيما بعد ووافقت، لأننى كنت مقتنعاً بوجهة نظره تماماً، وفعلاً نُقل للعمل فى وزارة الخارجية، لأنها كانت أقرب الجهات إلى عمله؛ حيث كان يعمل فى مجال المعلومات والتقديرات، وبدأ يشق طريقه من جديد معتمداً على نفسه.
ودارت أيام العمل فى الجهاز بكل التفاصيل والأحداث التى شابت تلك الفترة، وبعد ستة أشهر، قضيتها فى رئاسة المخابرات العامة، طلبنى الرئيس السادات، ودار بيننا هذا الحوار..
السادات: ما رأيك يا أحمد فى الوضع الحالى لمصر والجيش وما الحل من وجهة نظرك عسكرياً؟
إسماعيل: لا نستطيع أن ندخل فى حرب استنزافية ولا نستطيع أن نقوم بعملية عسكرية ضخمة، لكن من الممكن القيام بعملية تحرير لسيناء على مراحل، نعبر القناة ونقتحم الساتر الترابى، نتشبث بالأرض ونأخذ قطعة أرض ونبدأ مفاوضات .
السادات: مين ينفع يتولى هذه المسئولية؟
إسماعيل: هناك من القادة المتميزين من يصلح لهذا الدور الصعب.
ومرت الأيام ولم يتجدد هذا الحوار بيننا مرة ثانية، وكان السادات مشغولاً بعدة قضايا هامة اكتشفتها أثناء إدارة المخابرات العامة، منها قضايا التجسس على مصر، وتجنيد مصريين فى إسرائيل دون علمهم، ونجحنا فى العديد من هذه القضايا، ورغم قصر الفترة التى عملت بها فى المخابرات العامة، فإن الضباط الذين عملوا معى ألقوا القبض على العديد من المتورطين فى القضايا الهامة والكبيرة، التى كان لها أثر إيجابى فيما بعد على حرب أكتوبر. منها قضية هبة سليم، الجاسوسة التى كلفتنا الكثير، ولو لم يتم القبض عليها قبل الحرب كانت ستحدث فارقاً فى حرب أكتوبر بشكل كامل، خاصة أنها كان لديها أحد المصادر الهامة داخل الجيش، وجاءت إلى مصر بمعجزة؛ حيث قمت بإحضار ضابط المخابرات المسئول عن قضية هبة سليم، وقلت له: «مخول لك سلطات رئيس الجمهورية، وهبة لن تأتى إلا عن طريق والدها لأنه نقطة ضعفها الوحيدة». فجعلنا والدها يمثل أنه مريض، وأنه فى المستشفى فحضرت لرؤيته، رغم أن المخابرات الإسرائيلية حذرتها من السفر إلى مصر، وقالت لها إن مرض والدها مجرد خدعة، إلا أنها رفضت تماماً، وقالت إنه أبوها ولابد من أن تذهب لرؤيته، وكان لديها من الغرور والثقة بنفسها لدرجة أن تعتقد أن السلطات المصرية لن تستطيع القبض عليها. لقد كانت المعلومات التى ترسلها هبة سليم على مستوى عال جداً من السرية والأهمية، وكانت فارقة فى مكسب أو خسارة حرب أكتوبر 1973 حال استمرار تدفقها.
القضية الثانية التى كشفنا عنها قضية «راندوبولو» وهى من القضايا الهامة فى المخابرات، حيث كان صاحب مزارع عنب وعلى اتصال بسلطات عالية جداً فى الدولة، وكان من أهل البيت كما يقال، وقُبض عليه، والسفارة الأمريكية التى كان يعمل لحسابها قلبت الدنيا عليه، لكنه اعترف، وكان يرسل معلومات عسكرية وسياسية هامة لإسرائيل. هذا غير العديد من القضايا فى أوروبا، ونجحنا فيها بفضل الضباط المصريين فى جهاز المخابرات. كانت البداية على بُعد بضعة أميال جنوب غربى الإسكندرية فى منطقة اسمها جاناكليس حيث كان يوجد بها مزرعة كبيرة مخصصة كلها لزراعة العنب وإنتاج النبيذ تملكها شركة تحمل ذات الاسم «جاناكليس»، وكان يملكها واحد من أكبر رجال الأعمال وينتمى لأسرة بيراكوس. وكان من بين موظفى المزرعة الكبار رجل ينحدر من أبوين كانا هاجرا إلى مصر وأقاما فيها وحصلا على الجنسية المصرية، كان اسمه «طناش راندوبولو»، وحين صدرت القرارات الاشتراكية فى يوليو سنة 1961. طُبقت قوانين التأميم على المزرعة وتقرر أن يبقى راندوبولو فيها كمدير لها. وكان راندوبولو فى نحو الستين من عمره، على قسط كبير من الجاذبية والمقدرة وانتُخب مرتين عضواً فى مجلس الأمة عن الدائرة التى تقع فيها المزرعة والتى كانت بالفعل إقطاعية لتلك الشركة، وكان يقيم معظم الوقت فى استراحة جميلة فى المزرعة، مثالاً لرجل العلاقات العامة الناجح بما يوزعه على الجهات المختلفة من النبيذ والبراندى والفواكه. إلى أن كان العام 1970 حين اكتسب جاراً جديداً على حدود المزرعة مباشرة، حيث خُصص المطار القائم هناك للطائرات السوفيتية للدفاع عن الأسطول السوفيتى فى البحر الأبيض المتوسط وعن المواقع المصرية فى العمق. واستطاعت المخابرات الأمريكية أن تصل إلى طناش راندوبولو وتقنعه بأن يبلغها بكل أوجه النشاط السوفيتى فى القاعدة الجوية، وكان مرد نجاح المخابرات الأمريكية فى إقناعه أن له ابناً هاجر إلى الولايات المتحدة وكان شديد الاهتمام إلى حد كبير بمساعدته وقد تم اتصال المخابرات الأمريكية به عن طريق فتاة اسمها «مس سوين» كانت تعمل فى الظاهر كسكرتيرة فى قسم التأشيرات فى القنصلية الأمريكية، فى ذات الوقت الذى حامت فيه الشبهات من قبَل رجال المخابرات المصرية حول راندوبولو وبدأوا يراقبونه والتقطوا ثلاث رسائل مكتوبة بالحبر السرى تتضمن معلومات عن القاعدة وألقوا القبض عليه فى منطقة العجمى وكان معه يومها أمريكى قدم بطاقته الدبلوماسية فأُخلى سبيله. أما مس سوين فكانت لا تحمل جواز سفر دبلوماسياً، وبالتالى ليست لها حصانة. وكانت على وشك الهروب إلى خارج مصر بعد القبض على طناش راندوبولو، لكن خلال عودتها من منزل صديق لها، وبينما كانت تتجه نحو منزلها، بعدما تركت سيارتها، تقدم منها رجلا مخابرات بالملابس المدنية فحاولت الهروب لكنهما تمكنا من القبض عليها واصطحابها إلى إدارة المخابرات العامة وتفتيش شقتها. وحرصتُ كمدير للمخابرات العامة على أن يتم تصوير العملية كلها بآلة سينمائية حتى لا يكون هناك مجال للمناقشة بشأن حقيقة ما حدث وأسلوب القبض على «سوين» من قبَل السفارة الأمريكية التى أقامت الدنيا ولم تقعدها بعد القبض على مواطنة أمريكية، واتهمنى «دونالد بيرجس»، مندوب المخابرات فى السفارة وقتها، بأننى قدمت للرئيس السادات معلومات خاطئة، ولكن كان كل شىء مثبتاً باعتراف المتهم راندوبولو بالصوت والصورة. وبذل الأمريكيون كل الأساليب الممكنة لإطلاق سراح سوين، وقد تم ذلك بعد شهور عدة. وأما طناش راندوبولو فقد كان فى حالة انهيار تام منذ اللحظة الأولى لاعتقاله ومات بأزمة قلبية.
من القصص الغريبة التى واجهتها فى بداية عملى بالمخابرات، أنى وجدت لزاماً علـىّ استبعاد العناصر القريبة جداً من مراكز القوى، ولأنهم كانوا متميزين جداً، قلت لهم: اختاروا المكان المناسب الذى تريدون أن تنتقلوا إليه. ومن ضمن الحالات الإنسانية التى لا أنساها أن قانون المخابرات العامة وقتها كان يمنع أن يكون أى ضابط على علاقة قرابة أو نسب بأى من الشخصيات الكبيرة أو الضباط الكبار فى نفس المكان، وكان يوجد ضابط اسمه حسن حفنى كان محل تقدير جدا بالنسبة لكل العاملين معه، وكان مرتبطاً بابنة شعراوى جمعة، فقاموا بتخييره بين أن يترك خطيبته ليظل فى عمله، أو الانتقال إلى مكان آخر غير المخابرات العامة، لكنه اختار التمسك بخطيبته فاستدعيته وقلت له: أنا معجب بك لأنك تمسكت بخطيبتك. لقد ساعدنى فى عدم القيام بعملية تطهير فى جهاز المخابرات، وجود عدد من تلاميذى عملوا معى فى الجيش، وكنت أعرفهم جيداً؛ ولذا لم أستبعد أياً منهم، واكتفيت باستبعاد رئيس الجهاز السابق وثلاثة من القيادات لعلاقتهم بمراكز القوى.
فى تلك الفترة، كانت أعيننا على جبهة القتال، ونصحت المسئولين باصطحاب الأسرى الإسرائيليين فى العمليات فى جولات على الأهرامات والمتاحف المصرية، وكان القصد منها كسر الروح المعنوية لدى الجندى الإسرائيلى وأن يعرف أن الشعب المصرى من أرقى الشعوب.
بعد عام من عملى فى المخابرات التقيت الفريق محمد عبدالغنى الجمسى بالمصادفة فى مطار القاهرة الدولى، وكان كل منا يودع أحد المسئولين الأجانب، وأثناء خروجنا معاً من المطار قلت له هامساً: «متى ستحاربون يا جمسى؟» فكان رده: «سنحارب عندما تصبح أنت وزيراً للحربية وقائداً عاماً للقوات المسلحة وعندما تتولى هذه المسئولية ستعلم لماذا لم نحارب كل هذه الفترة السابقة والحالية». وقتها كنت ما زلت رئيساً للمخابرات العامة، وألتقى الرئيس السادات بشكل مستمر بحكم عملى، وكان لا يملّ من سؤالى عن أوضاع الجيش والبلد كله، وكنت أرد بنفس الإجابة التى كان مقتنعاً بها دائماً: «مصر لا تستطيع أن تحارب بشكل كامل، لا بد من خطة مختلفة».
وكان أن عرضت على الرئيس أنور السادات أن يزور المخابرات، وكانت المرة الأولى فى تاريخ مصر التى يزور رئيس الجمهورية فيها المخابرات العامة، لرفع الروح المعنوية للضباط، ويومها قال السادات كلمة للضباط، وزار غرفة العمليات وبدأ يؤكد على العمليات التى تخدم الحرب.
ونشطت فى تلك الفترة دراسات الحدود الآمنة وباب المندب، التى تولتها المخابرات العامة، كما أن دراسة الأعياد اليهودية لاختيار اليوم قامت بها المخابرات العامة أيضاً، وساعتها علم الجميع معى أن مصر ستخوض الحرب ضد إسرائيل. قبلها كان يراودنى شك فى محاولة عمل انقلاب على السادات، لكن انقطع الشك باليقين بعد أن استمعت لتسجيلات المؤامرة وقتها، وعلمت أن الرئيس كان على حق فيما فعل. كنت أومن بأن مهمة المخابرات الأولى هى حماية المصريين من العدو، وأن أول ما ينبغى القيام به هو إعادة الثقة بين الجهاز والناس، ومن هذا المنطلق بدأت خطوات من قبيل تبديل الصورة المرسومة عن المخابرات فى أذهان الناس، وأعلنت أنه يجب أن نمسح مصطلحات غسيل المخ وإدارة التعذيب من قاموس المخابرات. بالطبع لم يكن الأمر بالسهل، لكنى كنت دائم التأكيد على أن جهاز المخابرات العامة لن يكون فى يوم من الأيام سيفاً مصلتاً على رقاب الشعب المصرى أو العربى، لكنه سيكون الند والصديق المخلص لكل مواطن فى الداخل وفى الخارج. واستطعنا توظيف الخبرة فى تحقيق العديد من أهم إنجازات عهد الرئيس السادات، مثل القضاء على الحالة المتوترة، التى وصلت إليها العلاقات العربية المصرية بسبب الأنشطة التى كانت المخابرات المصرية تمارسها داخل دول عربية، وكنت ألقن الضباط ضرورة الإيمان بالحرية الفردية والمجتمع المفتوح.
كان رجال المخابرات يسابقون الزمن، لا لكشف عمليات التجسس التى تحاول إسرائيل من خلالها اختراق الجبهة المصرية سياسياً وعسكرياً وحسب، ولكن أيضاً كانوا يواصلون الليل بالنهار لجمع أكبر كمّ من المعلومات عن العدو وتحركاته وعتاده الحربى، والموقف على الجبهة الداخلية له؛ ولذا أنشأنا فى جهاز المخابرات إدارة أطلقنا عليها اسم «إدارة الخداع» كانت مهمتها تزويد العدو بمعلومات مضللة عن مصر عبر عملائنا المنتشرين على خط المواجهة. وربما لن أكشف سراً إن قلت: إنه كان لدينا قبل نشوب حرب أكتوبر أكثر من عشرة عملاء نجحنا فى تجنيدهم من بين القوات الإسرائيلية المتمركزة فى خط بارليف. ولم يستطع «الشين بيت» أو إدارة الأمن العام المختصة بمكافحة التجسس داخل إسرائيل اكتشافهم، أو معرفة أن من بين جنودها وضباط جيش دفاعها فى حصون بارليف من يتجسس لصالح مصر، ولا أخفى سراً آخر إن قلت: إن نحو 85 ٪ مما حصلت عليه إسرائيل من معلومات عسكرية وسياسية عن مصر تم تسريبه لها من جهاز المخابرات العامة.
كنا نعلم أنه، وبعد نكسة يونيو 1967، قد وقع فى يد إسرائيل الكثير من الخرائط والمعلومات والبيانات عن وحدات قواتنا المسلحة، وكان ذلك نتيجة الانسحاب المتسرع غير المخطط له؛ ولذا كان علينا مضاعفة المجهود المخابراتى لجعل تلك المعلومات لا قيمة لها، أو على الأقل تقليل أثرها. لقد حصلت المخابرات المصرية على معلومات عبر عملائنا على الجانب الإسرائيلى فى غاية الخطورة، منها خرائط حقول الألغام التى زرعتها القوات الإسرائيلية حول مواقع المدافع الثقيلة ومرابض الدبابات، وخرائط أخرى سرية لمولدات الكهرباء فى خط بارليف، وأماكن خزانات النابالم، ومواقع غرف الضباط والجنود فى خط بارليف ونظام الحراسات الليلية على الجبهة الشرقية للقناة، وأنواع الذخائر وخرائط مخازنها فى سيناء وغيرها من المعلومات التى ساعدت فى الإعداد للحرب.
كثيراً ما لمح لى مراقبون سياسيون أن اختيار السادات لى لرئاسة المخابرات العامة ما هو إلا تمهيد لتولى أمور القوات المسلحة، لكن بعد أن تتهيأ الأمور، وكان هذا صحيحاً فيما بعد، وعلمت أن السادات كان ينوى أن يعهد إلىّ بمهمة قيادة القوات المسلحة من البداية، ولكن لحكمته لم يفعل ذلك مباشرة، وجعل من محطة المخابرات الخطة الأولى لهدفه. وكنت لذلك الرجل العسكرى الوحيد الذى رافق الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء المصرى فى زيارته إلى موسكو بينما بقى وزير الحربية فى القاهرة. الواقع أن مسئولية إدارة جهاز المخابرات المصرية جعلتنى غير بعيد بل ربما قربتنى جداً من القوات المسلحة ورفاق السلاح والعمر، لكننى برغم تلك المشاركة والاقتراب المباشر من القوات المسلحة، لم أتوقع أن يجىء اليوم الذى أعود فيه إلى القوات المسلحة مرة ثانية وإلى صفوف الجيش.