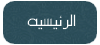روى وينستون تشرشل في مذكراته، أن التهديد الوحيد الذي خشي عواقبه في الحرب العالمية الثانية، هو الغواصات الألمانية.
وأدى ظهور سلاح الغواصات في 1914، الى تغيير نظريات الحرب البحرية وتحوّلها. فشأن المصفحة البرية، والطيران في الجو، أتاحت المصفحات الانتقال الى الحرب «الشاملة». وأحلت عولمة النزاعات «المراكب السود» محل القلب من السعي الى خنق العدو وقطع إمدادته من البحر.
لكن دور الغواصات بلغ الذروة في الحرب الباردة، وألقي على عاتقها مهمات القتال المتبقية بعد رفض الدول الكبيرة الاشتباك براً أو جواً، وقصرها مسرح القتال المحتمل والمغلق على البحار. وأوكل السلاح النووي الى الغواصات، الاضطلاع بمعظم عمل الردع. وقيام الدول الناشئة ببناء قوة غواصات مستقلّة في المحيط الهادئ على الخصوص، قرينة بيّنة على دور هذا السلاح على المسرح العالمي.
وتملك فرنسا 10 غواصات نووية. فهي واحدة من أقدم القوى البحرية «الجوفية»، وأكثرها تقدماً. وتحمل 4 غواصات نووية أجهزة قاذفة مزوّدة برؤوس (نووية). وتقوم هذه الغواصات مقام حجر الزاوية من استراتيجية الدفاع، أي الردع النووي. ومنذ 1972، لا يفارق 110 جنود مياه البحار والمحيطات، متأهّبين لإطلاق النار النووية إنفاذاً لأمر صادر عن رئيس الجمهورية. وتبلغ قوة النار والتدمير التي بين أيديهم نحو ألف ضعف قوة القنابل التي ألقيت على هيروشيما في آب (أغسطس) 1945، ويتصرفون بـ «التأمين على الحياة» الذي تعوّل عليه الأمة (الفرنسية).

ويبلغ متوسط عمر جنود الغواصات 28 سنة، ويبحرون مدداً طويلة تترجح بين 60 و90 يوماً، من غير رابط في الأثناء بأسرهم أو بالعالم. وبعضهم انخرط في سلك الغواصات رغبة في المغامرة، وبعض ثان عن هوى بالتكنولوجيا العالية، وبعص ثالث التزاماً بتقليد عائلي. وبعض رابع لا يتستر على انتظاره جوائز مالية ثمينة. ويشاركون كلّهم في تطوّعهم الإرادي والتلقائي، على ما تشترط قوة الغواصات على الجنود في صفوفها. ويتبوأ طاقم الغواصات بين بحارة سلاح البحرية، مكانة على حدة ولا يخطئ زملاؤهم تعرّفها أو ملاحظتها. وعلاقتهم العمودية والعميقة بالبحار والمياه تختلف عن علاقة زملائهم الأفقية بسطح المياه المترامي. وإبحارهم، أي غطسهم، هو تجربة بدنية تقودهم الى جوف المياه. وعلى رغم هذا، ليست بين بحار الغواصة وبين المياه آصرة مباشرة. فالغطس لا يترتب عليه لمس ولا حس ولا رؤية.
ويشبّه بعضهم الغطس بالرحلة الى القمر. وقد يغرف الاثنان من معين واحد، هو الرغبة في الاستيلاء على فضاءات لا تؤهلنا طبيعتنا الى التحافها أو الإقامة بها. والحق يقال أننا نعرف سطح القمر معرفة قريبة، بينما لا تزال 95 في المئة من القيعان البحرية مجهولة وبعيدة من متناول آلاتنا وأجهزتنا. فعلى عمق 150 متراً تحت سطح الماء، تمتصّ الظلمة 99 في المئة من الضوء، وتسود عتمة حالكة المواضع التي تقع على عمق 300 متر. ويتعاظم الضغط وحدة جوية كاملة كل 10 أمتار. والمحيط في هذه الحال، بيئة منكفئة يقود أقل خطأ منها الى الهلاك المؤكد. وفي أحيان كثيرة، ينقلب البحر مقبرة. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، ثوت 9 غواصات ألمانية من عشر في أعماق المياه. والخطأ في زمن السلم لا يرحم، فالعالم يذكر حادثة غواصة «إيمرود» (الياقوتة) في 1994. فيومها، أدت ثغرة في جهاز البخار الى احتراق 10 ملاحين، بينهم قائد الغواصة الذي كان يقوم بجولة تفتيش. وأودى غرق الغواصة الروسية، «كورسك»، بطاقمها كلّه، وكان يعد 118 روسياً.

ولا تقرِّب الحياة في الغواصة العوالم في ما بينها، بل تباعدها. فالغوص يفترض استقلالاً مطلقاً لا يترك محلاً للعلاقة بالخارج. ومريض الغواصة لا يرجو إسعافاً. وإذا أصابها عطل في أثناء الغطس، فليس على طاقمها انتظار مساعدة. والقيام التام بالنفس هو الأساس الذي ينهض عليه بناء الغواصات، فهي في آن واحد مصنع أوكسجين، وجهاز تنظيف الهواء، وجهاز تشويش، وأجهزة الغواصة كلّها مزدوجة فلا يعوق عطل يصيب أحد الأجهزة عمل الآلات المتّصل.
والغواصات آلات بالغة التعقيد، وهي ربما أشدها تعقيداً. وعلى سبيل المقارنة، يقتضي صنع طائــرة نقل 50 ألف ساعة عمل، بينما اقتضى إنجاز آخر الغواصات الفرنسية المجهّزة بعمود قاذف يحمـــل رأساً نووياً 75 مليون ساعة. وتحمل الغواصة مــفاعلاً نووياً في مقدوره تغذية مدينة تعد 50 ألف مقــــيم. وتشغل هذه المراكب من البحر صواريخ باليستية عابرة للقارات. وقصف الصواريخ من أعمـــق البحر ليس عملاً يسيراً، وضمان أن تبلغ هذه الصـواريخ أهدافها على بعد آلاف الكيلومترات على وجـــه الدقة، يفوق القصف وحده بكثير. وبحارو الغـــواصات هم، على هذا، ملاحون في وسعــهم تحمّل شظـــف عيش البحر الشديد، وتقنيون يتصرفـــون بأعلى التكنولوجيات دقة، معاً. والى هذا، هم عسكريون غارقون في الظل، ويؤثرون السر على العلن. فمهماتهم سرية، ومحطاتهم وطرقهم يلفّها الصمت، وإجراءاتهم لا يعرف أحد عنها شيئاً. وتنقل الغواصة النووية على جنبيها 16 صاروخاً باليستياً عابراً للقارات. وتحمل هذه مجتمعةً 96 رأساً نووياً متعدّد الاتجاه. ويسود جعب الصواريخ، الغارقة في ضوء أبيض اصطناعي بارد، جو لا يشبه جو آخر.

وتسبق الإبحار تمارين قاسية تمتحن طاقة أفراد الطاقم على معالجة الأوضاع الطارئة، مثل انبعاث الأبخرة أو انفجار تمديدات المياه. وتعدّ له تمارين تكتيكية متفرّقة، وتُعمل وسائل عسكرية وأجهزة مثل فرقاطة مضادة للغواصات، وطوافات وطائرات دورية بحرية («باتمار») تنخرط كلّها في مطاردة الغواصة. وطوال ساعات، يتمرن الطاقم على جبه هجوم مضاد للغواصات، ويحاكي ملابسات الحرب الفعلية على مسرح مساحته قريبة من مساحة محافظة أو منطقة (نحو 5 آلاف كلم مربع). وتختبر مساحة مسرح المناورة وقواعد استعادة التصويب، طاقة الغواصة على التبدّد في أمداء المحيط العريضة، وعلى الهرب من مطاردة العدو المنهجية. وبينما تتولى الفرقاطات المضادة للغواصات والطائرات سبر القاع البحري، ترصد طائرات الدورية البحرية تغيرات الحقل المغناطيسي على سطح المياه. وتُخشى قدرة هذه الطائرات على رمي أجهزة طواف نشطة على صفحة المحيط، تؤدي دور جمهرة من اللواقط المستقلّة والمنسّقة معاً.

وتتمتّع الغواصة بحاسة سمع بالغة الرهافة. وتخون الأصوات المنبعثة من «الأهداف» مصادرها، وتمكن الغواصة من قراءة «توقيعها الصوتي» وإثباته. ويسمي الطاقم العامل على سفينة غطس المركبَ العائم، وهو مصدر الأصوات، «الصائت». وتحار الملاحة الجوفية في تعيين موضع الصائت وسرعته ووجهته، وملاحتها هي رهن هذا التعيين. ومصدر الحيرة هو احتمال التعيين حلولاً كثيرة، وعلى طاقم الغوص ترجيح كفة حل على آخر. وتقضي أعراف الملاحة بترجيح الحل الذي تترتب عليه أوخم النتائج. وهذا يعني أن على الطاقم الشعور على الدوام بملاحقة العدو مركبة غوصه.
وعلى الطاقم الإيقان بأن بالغاً ما بلغت التقنية من دقة وثقة، لن يقوم شيء أو عامل محلّ طاقاته الذهنية والفكرية. فـ «فكرة المناورة» يعود بناؤها واستنباطها، ودمجُها عدداً ضخماً من العوامل المقدرة والمجهولات، الى عقول الملاحين، والى غريزة تُكتسب في أعقاب آلاف الساعات من الملاحة المتّصلة. ويضطلع الربان، أو القبطان، بدور لا يضاهى: فقدرته على الإحاطة بالحال وعلى استباق مناورة الخصم وإتقانه صوغ الأمر بصوت واضح وقوي من مركز قيادة العمليات، يقلبان الوضع رأساً على عقب، ومن طريدة تتحوّل الغواصة الى صياد مخيف بمياه المحيط المتمادية الى غايات صيده.
.jpg)
والمياه التي تبحر فيها الغواصة تتفاوت ملوحتها وحرارتها وأخيراً ضغطها الجوي. لذا، لا ينتقل الشعاع الصوتي في المياه الجوفية على خط مستقيم. وحساب الالتواء والانحراف يمكن الغواصة من الغطس والاقتراب من الهدف من غير تمكينه من تحديد مسار أو موقع الغواصة التي تطارده، فيسع الغواصة الإطباق على طريدتها، وقطع الطريق على هربها أو نجاتها. وفي أثناء حرب المالوين (بين بريطانيا والأرجنتين في 1982)، حين قصفت الغواصة إتش إم إس كونكيرور سفينة الاعتراض ببلغرانو، قتلت 323 ملاحاً أرجنتينياً.
ووصف تشرشل رعب طواقم سفن الحلفاء التي تتعقبها الغواصات الألمانية الخفية، فكتب أن الإنسانية لم تحلم من قبل بحرب على هذا القدر من القسوة والتعقيد. فأعملت معطيات العلوم كلها، وتطبيقات الميكانيك والصوتيات والبصريات، وتوسّلت بالخرائط والحسابات والحواسيب والإبر، وجنّدت اختصاصيين في لباس أبطال محاربين، وعبأت تفكيرهم الصبور والعنيد الذي كانت تقطعه انفجارات مباغتة تغرق مراكب ضخمة في أعماق المياه المظلمة، من غير عون ولا ملجأ.
ويضطلع قبطان الغواصة بدور فريد. فهو حلقة الوصل الوحيدة بين الأمر الرئاسي بالقصف الصاروخي النووي وبين الصواريخ المحمولة على متن الغواصة. فهو وحده نظير كل ما عداه، وحده نظير لفيف أركانه ونظير طاقم الملاحة. ويُختار القباطنة بين خيرة كبار الضباط البحريين، وتمتدّ خبرتهم الى 200 ألف ساعة غطس، ويتمتعون بسيرة مهنية أو سلوكية متميزة تعود حلقتها الأولى الى المدرسة البحرية. وسبق لهم كلّهم أن تولوا قيادة مركب حربي «سطحي» (يبحر على سطح الماء) وغواصة هجومية. فقيادة غواصة تحمل صواريخ ورؤوساً نووية وأعمدة إطلاق، تتويج لتضحيات كبيرة وخاتمة سيرة مهنية لا عيب فيها.