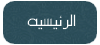( الحلقة الأولى )
أميركا تجهز للحرب والعراق يستعد للاحتفال بعيد ميلاد صدام
بعد عدة ساعات، من إعلان الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش إنذاره الشهير للرئيس العراق السابق صدام حسين ونجليه بمغادرة العراق، وبينما كان الجميع يرقبون الغيوم الثقيلة القادمة بسرعة صوب العراق، فوجئ محدثي، وهو أحد المسؤولين في الدائرة الزراعية التابعة لديوان الرئاسة العراقي، باتصال هاتفي من أحد المرافقين للرئيس ، الذي نقل انزعاج الرئيس صدام حسين، من إهمال لإحدى أشجار النخيل، وعدم تلقيحها، وقال أن الرئيس شاهد النخلة وعبر عن انزعاجه الشديد.
وأنا استمع إلى هذه الرواية، إضافة إلى قصص أخرى حصلت، خلال الأسابيع القليلة، التي سبقت الحرب، طفرت إلى ذهني المقولة الشهيرة للفيلسوف الصيني (صن تزو) الذي قال قبل 2500 سنة في كتابه (فن الحرب)، الذي يُعد دليل جميع المحاربين، عبر مختلف العصور، رغم تطور الأساليب الحربية، ودخول الأسلحة الحديثة والمتطورة، فقد قال في ذلك الوقت (إذا عرفت نفسك تربح نصف الحرب، وإذا عرفت عدوك تكسب النصف الثاني، أي المطلوب أن تعرف نفسك وعدوك). فهل عرف صدام حسين عدوه، في هذه الحرب، وهل عرفت الولايات المتحدة عدوها العراق، بصورة صحيحة، نتائج الحرب الأولى، تجيب على نصف السؤال، لكن تداعيات مرحلة ما بعد الحرب، تفتح الأبواب أمام أسئلة جديدة.
ليست قصة النخلة وحدها، التي تكشف أحد أهم أوجه حجم الاستعداد العراقي للمواجهة مع الولايات المتحدة في حرب، أعدت لها واشنطن جميع مستلزماتها العسكرية والإعلامية والاقتصادية.
في اَخر يوم خميس من فبراير من عام 2003، وقبل ثلاثة أسابيع من بدء الحرب، التي باتت وشيكة، وأخذ نثيثها القوي يطرق الأبواب في العراق، فوجئ العاملون في الدائرة الهندسية التابعة لديوان الرئاسة، بزيارة صدام حسين إلى حديقة الزوراء، التي تقع في جانب الكرخ من العاصمة العراقية، وهي أكبر متنزه في العراق، كان ذلك في الساعة السادسة صباحاً، عندما دخل موكب الرئيس إلى داخل الزوراء، حيث كانت تجري عمليات تأهيل الحدائق، وترع المياه والبحيرات الاصطناعية، وتوسيع حديقة الحيوانات، وكان العمل قد بدأ بهذا المشروع، منذ عدة أشهر، وتحدثت عنه وسائل الإعلام العراقية، التي تشرف عليها الحكومة، وتم تخصيص مبالغ طائلة لهذا المشروع السياحي الكبير، وأخبرني مهندسون في هذا المشروع، أنهم كانوا يعملون ببطء، وكلما ازدادت التهديدات الصادرة من واشنطن، كلما شعروا بأنه قد تصلهم أوامر في أية لحظة للتوقف عن العمل، بسبب تسارع الأحداث، لكن زيارة الرئيس جاءت مخالفة لكل تصوراتهم، كان حيوياً وبشوشاً على حد وصفهم، وتبادل أحاديث ودية مع بعض العاملين، الذين بان النعاس على ملامح وجهوههم، فقد قفزوا مسرعين من الأفرشة، التي أعدت في موقع العمل. أمضى صدام حسين وقتاً قصيراً، أعطى خلاله بعض التوجهات، لكنه قال كلمة في غاية الأهمية، حتى أنها اربكت ما يدور في أذهان الجميع. وبينما ارتفعت معنويات البعض ، فإن نوعاً من التشويش والضبابية، قد سيطر على الاَخرين.
قال لهم صدام حسين: يجب أن يتم انجاز مشروع حديقة الزوراء بالكامل، قبل يوم الثامن والعشرين من شهر أبريل 2003.
هذا يعني بكل وضوح، أن الرئيس قرر أن يتم افتتاح متنزه الزوراء أمام العراقيين، لمناسبة عيد ميلاده، الذي يحتفل به العراقيون سنوياً في الثامن والعشرين من أبريل، وفي مثل هذه الأيام، من كل عام، يكون الربيع قد أطل على العراق، وافترشت الخضرة الكثير من الأماكن، ورغم قصر فصل الربيع في العراق، إلا أنه يحمل الكثير من الأجواء الرائقة، إذ تتفتح الزهور، وتورق جميع الأشجار، ويكون الجو في أجمل درجات اعتداله، وهو يسبق الصيف اللاهب. لم يتمكن العاملون في متنزه الزوراء، من مهندسين كبار وعمال وسائقي مكائن ثقيلة، ومهندسين زراعيين، من الوصول إلى تفسير واضح ودقيق، لما يرون في الساحة السياسية الدولية، وتحديداً ما يتعلق بالحرب القادمة على العراق من جهة، وما قاله الرئيس عن ضرورة الاحتفال بافتتاح متنزه الزوراء، في الثامن والعشرين من أبريل، وهو ذكرى عيد ميلاده. تسلم الجميع مكرمة مالية جيدة، وانهمكوا في أعمالهم، بعد أن تراجعت في دواخلهم حالة التذبذب والقلق.
سألت أحد العاملين في القصر الجمهوري، عن الاستعدادات التي كانت تجري لمواجهة القوة الأميركية، التي أخذت وسائل الإعلام، تتحدث عن قدراتها الحربية والتقنية الهائلة، أجابني باقتضاب، أن البرنامج اليومي لرجال حماية الرئيس ، يقصد بعض أفراد الخط الأول، لم يتغير، خاصة ما يتعلق بأوقات ما بعد انتهاء الواجبات.
قبل أسبوع من بداية الحرب، وتحديداً يوم الجمعة، الذي سبق الحرب، التي بدأت يوم الخميس 20/3/2003، كنا في سفرة سياحية عائلية، حيث تجمع المئات من العراقيين، في منتجع اسمه (صدامية الفلوجة) يقع قرب الطريق السريع المؤدي إلى الأردن، شرق مدينة الفلوجة، أتخذته فيما بعد القوات الأميركية قاعدة عسكرية، وهذا الموقع كان خاصاً بالرئيس والمقربين منه، إلا أنه فُتح أمام العائلات العراقية، قبل سنتين من ذلك التأريخ، ويشمل ثلاث بحيرات اصطناعية، إضافة إلى حدائق وأماكن للاستراحة.
وبينما كانت أجواء الحرب تخيم على عقولنا، وتسيطر علينا بصورة قوية، شاهدنا عدة سيارات مرسيدس تتجول في المنتجع، ولكن في الجناح الاَخر، بعد قليل علمنا أن سكرتير الرئيس الخاص الفريق عبد حميد محمود مع عائلته ومرافقيه، كانوا في تلك النزهة السياحية.
أردت في تلك الأثناء إيجاد تفسير لكل ذلك، هناك لغز غريب، بينما تتحرك الولايات المتحدة بكل قوتها، معلنة أنها دخلت الحرب فعلياً، على مختلف الصعد، ما عدا بدء إطلاق النار، كان المسؤولون العراقيون، يتصرفون بطريقة مغايرة تماماً.
حاولت أن استفسر من عدد من الأصدقاء الذين يعملون في دوائر الدولة، وحتى في الأجهزة الأمنية، عن الاحترازات أو عمليات الإخلاء، كما كان يحصل في كل مرة، تهدد فيها الإدارة الأميركية بتوجيه ضربات للعراق، كما حصل أواسط شهر ديسمبر عام 1998، عندما هدد الرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون بتوجيه ضربات إلى العراق، وحصل ذلك فعلاً، وأستمر لثلاثة أيام، ورغم أن الإدارة الأميركية، لم تعلن حينها خطة لاحتلال العراق، إلا إن عمليات إخلاء لدوائر الدولة، قد حصلت على نطاق واسع، وتم تحديد أماكن بديلة للقيادات والوزارات والدوائر الأخرى، إلا إنه في تلك الأيام التي سبقت الحرب، لم تحصل أية إجراءات بمستوى ما يلوح في الأفق.
انعكس ذلك على مظاهر الحياة اليومية، إذ لم تكن ثمة أزمة في وقود السيارات، كما كان يحصل مع كل تهديد سابق، إلا إن الظاهرة الجديدة، التي انتشرت في العراق، كانت ظاهرة حفر الاَبار الارتوازية داخل حدائق المنازل.
قلة من العراقيين، أدركوا انه قد تم قرع طبول الحرب، على أوسع مايكون في الأول من مارس عام 2003، أي قبل ان يبدأ سقوط اولى الصواريخ، على سكن عائلة الرئيس السابق صدام حسين، الواقع في منطقة الدورة، في الحي الجنوبي من العاصمة، بعد ثلاثة أسابيع بالتمام والكمال من ذلك اليوم، فقد كان إصرار مفتشي الأمم المتحدة على تدمير صواريخ (الصمود -2)، يؤكد أن قرار الحرب، قد تم اتخاذه بصورة نهائية، لأن هذه الصواريخ، ليست من تلك المشمولة بقرارات الأمم المتحدة، ذات المديات البعيدة، أي ان مداها يتراوح بين 100- 150 كلم، وهي اَخر سلاح تبقى في الترسانة العراقية، التي خضعت للتفتيش والتدمير ابتداء منذ عام 1991 حتى السادس عشر من ديسمبر عام 1998، ثم استأنفت تلك اللجان نشاطاتها في العراق، بعد قبول الحكومة العراقية القرار رقم 1441، الذي تبناه مجلس الأمن في الثامن من نوفمبر 2002، وأعلن قبوله في الثالث عشر من نوفمبر، وأجرت فرق التفتيش مسحاً سريعاً وشاملاً، على جميع المواقع العراقية، مستخدمة الطائرات المروحية، وبصلاحيات مطلقة. ومن الواضح ان عمليات التفتيش تلك، كانت تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية:
الأول: التأكد من أن العراق، لم يتمكن من إنتاج أسلحة جديدة، خلال الفترة، التي غادرت فيها لجان المفتشين العراق في السادس عشر من ديسمبر عام 1998.
الثاني: الحصول على احدث الخرائط التفصيلية للمواقع الرئاسية، والمعسكرات ومقرات الأجهزة الأمنية، التي ستكون أهدافاً رئيسية خلال حرب الولايات المتحدة على العراق. وهذه التفاصيل هي الأحدث، وتضاف إلى المخططات السابقة، كما أن الإدارة الأمريكية والجهات المختصة في وكالة المخابرات المركزية، وفي البنتاغون، تحتاج الى مطابقتها مع ما لديها من خرائط قديمة، جاءت بها لجان التفتيش السابقة، إضافة إلى ما توفره الأقمار الاصطناعية المنتشرة في سماء العراق لهذا الغرض ، ففي منتصف سبتمبر من عام 2002، أي قبل ستة أشهر من بداية الحرب، بدأت قافلة من أقمار التجسس تجوب فضاء العراق على مدار 24 ساعة في اليوم، ويقود هذه المجموعة قمر (ميستي) المعروف باسم وأطلقت هذه المجموعة المؤلفة من ستة أقمار وكالة (ناسا) ويسير قمر (ميستي) على ارتفاع يزيد عن السبعمائة كيلومتر، ويحمل أجهزة ومعدات ومختبرات تزن 15 طناً، وهذا القمر، انطلق أول مرة مطلع عام 1992. ويعتقد انه تخصص بالتجسس على العراق والدول المحيطة به. وهذه الأقمار هي (لاكروس 4) وقمر (كيهول 11) إضافة إلى ثلاثة أقمار أخرى ترافق قمر (لاكروس 4). وتقول معلومات البنتاغون إن هذا القمر، يتمكن من تمييز حجم البيضة في الصين.
رغم الحملات الدعائية الواسعة، التي خصصتها الإدارة الأميركية للحديث عن قدراتها الفائقة في السيطرة على أدق ما موجود من تفاصيل على سطح الأرض وأحياناً في الأعماق، من خلال بسط سيطرتها على الفضاء، إلا ان مخاوفها ظلت قائمة من احتمالات التمويه التي قد تستخدمها القيادة العراقية، على أقمار التجسس التي تجوب سماء العراق. لذلك أصر المسؤولون على مطابقة ما لديهم من معلومات وصور ووثائق، مع ما ينقله المفتشون في تقاريرهم والصور والأفلام، التي يتم التقاطها للمواقع والمقرات، وحتى الطرق ومداخل المدن الرئيسية.
الثالث: التأكد من خلو المنطقة الصحراوية، من أية صواريخ بعيدة المدى، يمكن اطلاقها في حال نشوب الحرب، على اسرائيل أو دول الخليج، كما حصل عام 1991، وتمتد هذه المنطقة من جنوب الموصل في الشمال، حتى أم قصر قرب الحدود الكويتية في الجنوب. إذ ان اطلاق مثل هذه الصواريخ، سيشكل أزمة خطيرة لقادة الحرب في البيت الأبيض ، الذين تعهدوا بشن حرب (نظيفة). ولم يكن بالإمكان التأكد من ذلك، إلا من خلال الزوايا التالية:
أ. اجراء مسوحات شاملة في الأراضي العراقية.
ب . التأكد من عدم وجود منصات لاطلاق هذه الصواريخ.
ج. التأكد من عدم تصنيع مثل هذه المنصات داخل العراق، وأستدعى هذا الأمر، وللتأكد منه بصورة تامة الالحاح في مسألة مقابلة العلماء العراقيين من العاملين في برامج التسلح العراقية. ورغم اعتراض العراق، إلا ان الضغوطات كانت شديدة، حتى وافق العراق على ذلك وجرت أولى مقابلة انفرادية مع عالم عراقي في شهر مارس 2003 قبل الحرب بأسابيع، ثم جرت مقابلات أخرى. حتى اطمأن البيت الأبيض الى عدم وجود صواريخ بعيدة المدى، ثم جاء التأكيد على صواريخ (الصمود -2)، لتدميرها مع القوالب والمعدات وقواعد الإطلاق، وتم تدمير اَخر مجموعة من هذه الصواريخ بتاريخ السادس عشر من مارس أي قبل بدء الحرب باثنتين وسبعين ساعة.
الرابع: ان تدمير هذا النوع من الصواريخ، والذي تم أمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية، بقدر ما أعطى طمأنينة للقوات الأميركية والبريطانية المحتشدة قرب الحدود العراقية في الكويت، إذ تأكد خلو العراق من أي سلاح هجومي، بما في ذلك الطائرات، فإن ذلك التدمير شكل حالة إحباط وخيبة كبيرتين عند العسكريين العراقيين، الذين يراد منهم، مواجهة هذا الجيش بأسلحته الفتاكة والمتطورة، وبينما أخذ الجنود يرتدون خوذات القتال، استعداداً لمواجهة الخصم، كانوا يشاهدون عبر شاشات التلفاز، كيف تتم عملية تدمير أسلحتهم والقضاء على جميع أدوات القتال المتوفرة لديهم.
في تلك الأيام، أنقسم العراقيون على أنفسهم، منهم من وجد في النشاطات الواسعة والمحمومة للجان التفتيش الجديدة، المنقذ الذي سيقول للعالم، هاهو العراق فتشناه من أقصاه الى أقصاه، ولم نعثر على السلاح الذي تريده أميركا مسوغاً لشن الحرب، ومنهم من رأى في تلك اللجان مجرد أداة بيد الولايات المتحدة، للتأكد من خلو الطريق من أي ألغام قد تعرقل حربها.
في تلك الأثناء، لم يصدر من القيادة العراقية ما يكشف عن الذي يدور في عقول المسؤولين، عن شكل المواجهة، التي أصبحت واقعة لا محال. حاولت ان أستقصي بعض ما تخطط له القيادة في بغداد، من خلال الإجراءات والاستعدادات، التي تتخذها وزارة التجارة، فأعلمني د. محمد مهدي صالح- وزير التجارة السابق، عندما زرته مساء في مكتبه بالوزارة، بساحة الخلاني وسط شارع الجمهورية، التي احترقت يوم العاشر من أبريل ضمن موجة الحرق الغامضة، التي اجتاحت المباني الحكومية خلال أيام الاحتلال الأولى. قال لي حينها وزير التجارة، أن وزارته قد اتخذت جميع الاستعدادات لمواجهة جميع الاحتمالات. وأعلمني أن خطة الطوارئ وضعت بالحسبان ستة أشهر، وشمل ذلك استيراد كميات كبيرة جداً من مفردات البطاقة التموينية، التي بدأ العمل بنظامها منذ صيف 1990، مع بدء فرض العقوبات الاقتصادية على العراق.
خلصت من تلك المعلومة، في ذلك الوقت، ان القيادة العراقية، ترى ان أقصى فترة للحرب ستكون ستة أشهر، لأن منافذ العراق سيتم إغلاقها، كما ان سير الشاحنات في الطرق الخارجية، سيكون شبه مستحيل، إذ ستتعرض لقصف الطائرات الأميركية، وهذا حصل إبان حرب 1991، مع انها كانت على نطاق أقل، على اعتبار ان الهدف المعلن لتلك الحرب، هو اخراج العراق من الكويت، أما الحرب المقبلة، فهدفها إزاحة النظام، وبسط السيطرة الأميركية على العراق.
في تلك الأثناء تبدلت اللهجة الأميركية تماماً، فالكلام الذي قاله وزير الدفاع دونالد رامسفيلد اَواخر نوفمبر عام 2002، في مقابلة مع قناة الأميركية، عن احتمال بقاء صدام حسين في السلطة، إذا أعلن عن استعداده لتسليم أسلحة الدمار الشامل، هذا الكلام اختفى تماماً، وبدأت واشنطن تتحدث عن مرحلة ما بعد الحرب، ونشرت الصحف الأميركية معلومات تتحدث عن خطة أميركية لحكم العراق من ثلاث مراحل، تبدأ بتولي جنرال أمريكي الحكم، ولا ندري إذا كان الأمر قد تم إسناده في ذلك الوقت، إلى الجنرال المتقاعد جي جارنر، أم لا.
حاولت أن أعرف شيئاً عن استعدادات الجيش العراقي لمواجهة الاستعدادات الأميركية الواسعة، وقلت لأحد الضباط الكبار من العاملين في دائرة العينة (وهي الجهة المسؤولة عن تجهيزات الجيش العراقي) قلت له، ان السفن الأميركية، بدأت عبور قناة السويس منذ شهر نوفمبر من عام 2002، وان أولى السفن واسمها (سكان ارتيك) تحمل دبابات ومواد مشعة وبطاريات ليثيوم وتوربينات للطيران من قاعدة في سبادن العسكرية في ألمانيا، وقد وصلت إلى القواعد الأميركية في قطر والكويت.
ومن خلال حديثي مع الضابط العراقي، اكتشفت أن أي أسلحة أو تجهيزات خاصة بحرب من النوع الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة، لم يحصل، بل ان الجيش لم يتلق أي توجيهات لرفع درجة التأهب إلى أعلى المستويات. وكانت قناعة الضابط العراقي، أن الحرب لن تحصل، وكان هذا الرأي يتفق مع ما يراه الكثيرون في العراق، من أن هدف الحملة الأميركية دعائية بحتة، ويستند هؤلاء في تفسيرهم هذا إلى أربع نقاط:
أولاً: أن هدف الولايات المتحدة الأساسي، هو إزالة أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها صدام حسين، وليس هدفها إزالة صدام حسين نفسه من الحكم. وان الضغوطات النفسية والإعلامية كفيلة بدفع الرئيس العراقي إلى الموافقة على تسليم جميع الأسلحة، والتخلص تماماً من أي برامج قابلة للتطوير مستقبلاً، ويرى أصحاب هذا الفريق، أن الولايات المتحدة، لو كان هدفها إسقاط نظام صدام حسين، لفعلت ذلك في الأول من مارس عام 1991، عندما انسحب الجيش العراقي من الكويت، ولم يعد نظام صدام حسين مسيطراً على الأوضاع في غالبية المدن العراقية، ولو زحفت المدرعات الأميركية في حينها، ولم تتوقف عند قاعدة الإمام علي في الناصرية، لوصلت مع الغطاء الجوي الكثيف إلى بغداد.
ثانياً: أخذ البعض يتداولون فكرة، أن بقاء نظام صدام حسين، الذي تعرفه الولايات المتحدة جيداً في حالة ضعف تام وعدم وجود أية أسلحة لديه، وفرض رقابة تمنعه من تطوير الأسلحة مستقبلاً، أفضل لواشنطن من الخوض في غمار حرب، تخسر فيها الكثير، وتضعها في تشابكات إقليمية ودولية، ويستند هؤلاء في قناعتهم تلك إلى المواقف الدولية الرافضة للحرب، وفي المقدمة منها فرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
ثالثاً: اذا كان أحد أهداف الولايات المتحدة هو النفط، فقد كانت أول باخرة تحمل النفط العراقي، بعد تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء مطلع عام 1996، هي باخرة أميركية، ولم يتوقف تدفق النفط العراقي إلى الشركات الأميركية طيلة السنوات اللاحقة.
رابعاً: تم تفسير استمرار الغارات التي تشنها الطائرات الأميركية والبريطانية على العراق، مستهدفة الدفاعات والرادارات العراقية، على أنها عملية منظمة للقضاء على أية قدرات عسكرية عراقية، على أمل أن تطرح الولايات المتحدة في مراحل لاحقة مشروعاً لإعادة تسليح الجيش العراقي، خاصة ان القطب الاَخر في المعادلة الدولية وهو الاتحاد السوفيتي، قد خرج من حلبة الصراع في وقت مبكر مطلع تسعينيات القرن الماضي. وعلى هذا الأساس شنت الطائرات الأميركية والبريطانية، حتى أواخر عام 2002، أي قبل اندلاع الحرب بثمانين يوماً، أربعة وأربعين ألف طلعة جوية، استناداً إلى البيانات العراقية الرسمية، وأكدت ذلك ايضاً قناة الأميركية. وهذا الاعتقاد يقود الى ان الحرب قد تقع بهذا الشكل المتقطع، ولن تقع بالصورة التي يراها الاَخرون.
من هنا جاء الاعتقاد، بأن عدم تجهيز الجيش العراقي مع اشتداد حرارة المواجهة، قد دخل ضمن هذا التصور لمجريات الأحداث.
في يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من نوفمبر عام 2002، حصل تطور هام بالنسبة لعمليات البحث عن الأسلحة العراقية فقد انتهت القطيعة بين فرق التفتيش عن الأسلحة والحكومة العراقية، بعد ان غابت هذه الفرق، لما يقرب من الأربع سنوات، ففي هذا اليوم، الذي كان أقرب الى أجواء الربيع المعتدلة، من الشتاء الذي غالباً مايكون قارص البرودة، وصلت طلائع المفتشين من لجنة (انموفيك) لتستأنف عمليات التفتيش وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الأمن المرقم (1441) الذي صدر في 8/11/2002 وأعلن العراق قبوله في 13/11/2002. وجلبت هذه اللجنة معها أجهزة ومعدات تزن اكثر من 20 طناً، وبعد يومين من وصول المجموعة الأولى، كشفت صحيفة (الاندبيندنت) البريطانية، ان هناك خططاً لمداهمة المواقع الحساسة، في حين قال بعض أعضاء فريق التفتيش ، ان واشنطن ترغب في أن يتم التحرك بشكل سريع في إجراء عمليات التفتيش .
لاشك بأن الموافقة العراقية على عودة المفتشين كانت متأخرة جداً، وان القيادة العراقية قد وقعت داخل الشرك الذي نصبته لها الإدارة الأميركية عام 1998، ولكن قبل مناقشة ذلك بصورة تفصيلية، لابد من التوقف عند لجنة (انموفيك) الجديدة، التي حلت محل لجنة (اونسكوم) التي بدأت عمليات البحث عن الأسلحة العراقية عام 1991.
عشية عودة المفتشين إلى بغداد صدر تصريح في غاية الأهمية لأول رئيس للجان التفتيش هو السويدي رولف ايكيوس ، الذي أجرى لقاءاته الشهيرة مع صهر الرئيس العراقي حسين كامل عندما لجأ الى الأردن عام 1995. قال ايكيوس ومع عودة المفتشين ان احتمال وقوع الحرب وصل الاَن الى اكثر من 70 في المائة. اللافت في كلام ايكيوس ، انه قال عام 1997، عندما غادر منصبه رئيساً لفرق التفتيش ، ان ما تبقى من أسلحة العراق قليل. أما بالنسبة للبرنامج النووي، فكان ايكيوس متأكداً من انتهائه، وينطلق المسؤول الأممي من حقائق عديدة، تتمثل في معرفته بصعوبة إنتاج أسلحة الدمار الشامل، خاصة في مثل أوضاع العراق، لأن المصانع الكبرى قد تم تدميرها، كما أن هناك رقابة شديدة على الشركات الكبرى، وهذه الشركات معدودة ومعروفة، وتخضع لمراقبة أجهزة المخابرات في الغرب، التي تكاتفت فيما بينها بخصوص العراق، وتحديداً فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. كما ان هناك معضلة شحن المعدات الأساسية للعراق، لوجود رقابة صارمة على استيرادات العراق، وعدم وجود طيران إلى بغداد. ثم تأتي معضلة الموارد المالية، التي يحتاجها العراق، وصعوبة توفير المبالغ الطائلة لذلك، بعد فرض الحظر الاقتصادي منذ صيف عام 1990. ربما لم ينتبه الكثيرون إلى توقعات رولف ايكيوس ، التي رجحت الحرب على السلم، رغم ان جميع الدلائل تشير إلى عكس ذلك، منطلقة من زاويتين أساسيتين هما:
الأولى: ان تفسير موافقة العراق على القرار 1441، دون قيد أو شرط، والتي نصت على فقرات قاسية كثيرة، وأتاحت للجان التفتيش الوصول الى أي مكان واستجواب أي شخص ، بما فيه الرئيس العراقي صدام حسين، وفتح جميع الأبواب والأماكن، دون أي عوائق، هذه الموافقة، أعطت انطباعاً شبه مؤكد، ان العراق لايمكن أن يوافق على هذه الشروط، اذا كانت لديه أسلحة دمار شامل، لأن هذه الصلاحيات، ستمكن لجان التفتيش من الوصول إلى تلك الأسلحة، خاصة أن إحدى فقرات القرار (1441) تسمح باستجواب العلماء العراقيين على انفراد، وأخذهم إلى خارج العراق، إذا وجدت ضرورة لذلك، أي بمعنى اَخر، أن إمكانية إخفاء أي أثر لهذه الأسلحة، أن وجدت اصبح ضئيلاً بل يستحيل ذلك.
الثانية: أن هدف الولايات المتحدة، هو التخلص من أسلحة الدمار الشامل، على اعتبار أنها تهدد أمن المنطقة والعالم، فإذا خرجت لجنة (انموفيك) بتقريرها النهائي، الذي يؤكد خلو العراق من هذه الأسلحة، فأن ذلك، واستناداً إلى ما يعيشه المجتمع الدولي من طروحات، تؤكد على خطورة انتهاك القانون الدولي والالتزام بالمواثيق الدولية، واحترام سيادة الدول، كل ذلك، سيقف عائقاً أمام الولايات المتحدة، في شنها الحرب على العراق. لكن رغم كل ذلك، فأن رولف ايكيوس ، أعطى الأرجحية للحرب، وهو الأكثر خبرة بحقيقة ما يدور من حديث عن أسلحة الدمار الشامل.
هذا يفسر المراحل التي مرت بها اللعبة الأميركية، ويؤكد على أن واشنطن اتخذت قرار الحرب على العراق، حتى لو تأكد خلوه من أسلحة الدمار الشامل.
لا يخفى على أحد إن مسؤولية تدمير أسلحة العراق، كانت قد تبنتها الولايات المتحدة، مستخدمة واجهة الأمم المتحدة، ويرتبط ذلك بالمشروع الأميركي، الذي بدأت أولى خطواته أو لنقل ملامحه، مع اقتراب الاتحاد السوفيتي من الانهيار وبرزت أهم ملامحه ذلك خلال حكم غورباتشوف، واختصر ذلك الرئيس الأميركي الأسبق نكسون في كتابه المعنون (نصر بلا حرب)، وتحدث فيه عن انتصار الولايات المتحدة الحتمي على الاتحاد السوفيتي، بعد أربعة عقود متواصلة من الحرب الباردة.
من هنا اختارت الولايات المتحدة من العراق، نقطة انطلاق لها في تنفيذ استراتيجيها الجديدة، التي ترتكز إلى الردع والحروب الاستباقية وعسكرة الفضاء، وبسط الهيمنة على العالم، وبالتالي التفرد بالقوة، وفرض السياقات الجديدة في السلوكيات، في التعامل مع الدول، ومحاولة تقديم مفاهيم جديدة لمعنى السيادة، وبما يتماشى والمكانة الجديدة للولايات المتحدة. وبما يتلاءم ومصالحها المستقبلية. لهذا ومن خلال فهم دقيق لأبعاد السياسة الأميركية، جاءت قناعة رولف ايكيوس ، في ذلك الوقت، الذي رأى فيه الكثيرون أن شبح الحرب، قد ابتعد كثيراً بعد موافقة العراق على القرار (1441)، بكل ما يحمل من قسوة واشتراطات وصلاحيات، وصلت إلى الحد الذي وصفه البعض ، بأنه ينتهك سيادة الدولة العراقية بصورة كاملة وعلى أوسع نطاق.
لا شك أن واحدة من أكبر الأخطاء، التي وقعت بها القيادة العراقية، هي ابتلاعها للطعم الخطير، الذي وضعته الإدارة الأميركية أمامها عام 1998، عندما حصلت قصة خروج فرق المفتشين من العراق، وكان يرأسها ريتشارد باتلر. هذه القصة بجميع تفاصيلها، تحتاج إلى أكثر من وقفة وتحليل دقيق، لأنها تكشف عن أساليب الإدارة الأميركية في تأزيم المواقف وجني ثمار ذلك، وبما يتوافق والمراحل والمخططات، التي تخدم استراتيجيتها.
أعتقد أن أكثر اللحظات سعادة، التي عاشها مخططو السياسة الأميركية من الذين يمسكون الملف العراقي، قد تأججت فرحاً عندما شاهدوا طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي، وهو يدلي بتصريح ناري يوم الثامن عشر من ديسمبر عام 1998، أي بعد يومين من بدء القصف الجوي العنيف على بغداد، الذي بدأ في السادس عشر من نفس الشهر، وقال في تصريحه، أن لجان التفتيش حفرت قبرها بيدها، وأكد المسؤول العراقي، أن العراق لن يسمح بعودة اللجان ثانية. هذا الموقف، مثّل نقطة التحول الأهم بالنسبة للإدارة الأميركية، كما أنها كانت بداية المنزلق الخطير، الذي أوقعت القيادة العراقية نفسها في مطباته. لكن كيف تمكنت واشنطن من تحقيق هدفها هذا، وعلى هذه الشاكلة. لكي نرى الصورة بجميع تفاصيلها، نحتاج إلى عملية تشريح لإطار الصورة، ثم قراءة الفراغات الموجودة في زواياها.
يتبع ........